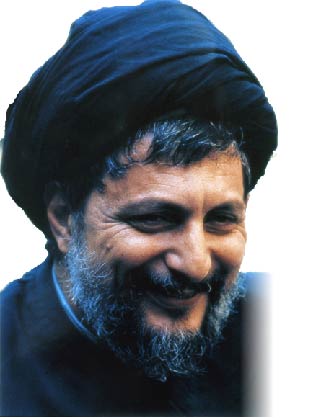بسم الله الرحمن الرحيم
يختلف المؤتمر الثامن عن المؤتمر السابع بأمور عديدة،
منها، أننا فقدنا خلال هذه المدة، أيّ منذ 1972 حتى 1977، مجموعة من نخبة زملائنا: الشيخ محمد أبو زهره، الشيخ عبد الله غوشه، الأستاذ صالح بويصير والأستاذ مالك بن نبيّ نترحم عليهم.
ومنها، أن المؤتمر السابع كان في أجواء احتلال القنال وسيناء، وكنّا نزور مدينة السويس ولا نجد فيها موجودًا حيًّا، عدا الجنود والضباط والذين كنّا نلتقي بهم في مسجد الشهداء، وكان كالقلعة الراسخة في وجه العدو محفوفا بأكياس الرمل.
أما اليوم فإن القنال وقسمًا من الجولان، ومدينة السويس عادت إلى طبيعتها.
ولم يكن هذا هو النصر الوحيد للعرب والمسلمين، بل كان بداية انتصارات لهم وهزائم للعدو الإسرائيلي، سياسية، دبلوماسية، بترولية واقتصادية.
وكان آخرها ثقافية إيديولوجية حيث طُرِدت إسرائيل من منظمة الأونيسكو، واعتبرت الأمم المتحدة أن الصهيونية نوع من العنصرية، وهذه هي بداية النهاية لإسرائيل حيث إن العالم لفظها واعتبرها غريبة عن العائلة البشرية التي ترفض التصنيف العنصري.
ولذلك، فإن إسرائيل انتقمت من العرب في لبنان حيث شنّت عليه حربًا غير مباشرة، وأصابت العرب ولبنان بخسائر بشرية ومادية تفوق جميع ما أُصيب به الجانبان في جميع الحروب العربية الإسرائيلية.
ولا تزال الحرب مستعرة في جنوب لبنان حيث تريد إسرائيل فرض التعامل على أبناء الجنوب وتطمع في مياه الجنوب، وتريد خلق حزام أمني لها في وجه الفلسطينيين، ولكن أبناء الجنوب صامدون يفضلون التشريد والخسائر والموت على ذلك.
وقد أصابت إسرائيل العرب بخسائر معنوية أهمّها خلق فتنة طائفية، وإيجاد اهتزاز في الوحدة الوطنية، الأمر الذي يشكل خطرًا على العرب ويؤكد الوجود العنصري لها. ولم تزل إسرائيل للعرب وللمسلمين وللمسيحيين بالمرصاد، حيث إنها تستعمل أنواعًا من الحرب المتنوعة ضدهم جميعًا، وهي الآن تدعي حماية المسيحيين في الجنوب وهي الخطر الأكبر عليهم. وهي تحرض وتفتن وتخلق مشاكل وتيارات حضارية وثقافية. ولذلك، فإن القيادة الإسلامية تعيش اليوم أخطر مراحل حياتها، وهذه تستدعي اليقظة والحذر والارتفاع بمستوى العصر.
قد يبدو للوهلة الأولى أن أساليب التربية بعيدة عن أصول الدين، حيث إن الفقه الإسلامي يبحث في قسم الآداب والسنن، وفي مسائل الولادة من كتاب النكاح عن تربية الطفل مثلًا، بينما الأصول هي الجذور العقيدية والثقافية للإسلام، وهي الأوّليات والبدايات فيه.
ولكن المزيد من التأمل، يكشف أن القرآن الكريم نفسه يعتمد في تربية المسلمين -أفرادًا وجماعات- أسلوب التقيّد بالأصول كما نشاهد خلال هذه الدراسة، كما يثبت أن فصل الأساليب التربوية عن الأصول هو جزء من المأساة الكبرى لاستيعاب الإسلام وللدعوة إليه.
إن هذه الدراسة تعرض أولًا أساليب التربية المختلفة، ثم تحاول اكتشاف الأسلوب القرآني وهو الترابط المتين بين الأسلوب التربوي وبين الأصول، وهنا تلقي الدراسة أضواءً على طريقة القرآن لعرض الإسلام والدعوة إليه، وهي طريقة تختلف كليًّا عن الطريقة الأكاديمية، وهي تعتمد تقسيم مسائل العقيدة أو الشريعة، وتفصيل الشريعة إلى الفقه والأخلاق، ثم تقسيم الفقه إلى كتب في العبادات والمعاملات والسياسات والأحكام... وهكذا.
وفي نهاية الدراسة، نبحث عن الضرورات التربوية الحادّة المعاصرة، وعن بعض المقترحات لمواجهتها.
أولًا، الأساليب التربوية والأسلوب القرآني:
1- إن الأسلوب البدائي للتربية هو توجيه الأمر والنهي إلى موضوع التربية (المربّي)، ولا شك أن له تأثيرًا محدودًا ومضاعفات سلبية أحيانًا، سيّما عندما يُستعمل العنف في سبيله وعندما لا يؤخذ وضع المربّي النفسي بعين الاعتبار.
2- ويأتي الأسلوب الأرقى من ذلك عندما يستعمل المربّي وسائل الإقناع، ويحاول التصرّف في عقل المربّي وقلبه لكي يقتنع بالهدف ويحبّه لينطلق نحوه.
3- أمّا الأسلوب الثالث الذي يعتزّ به أصحاب المدارس الاجتماعية الحديثة، فهو التوجّه أولًا إلى البيئة للمربّي فردًا كان أو جماعة، لتصبح مناخًا ملائمًا للهدف التربوي، وليتكوّن تيّار نحوه يسهل معه على المربّي العمل والإقناع. والقرآن الكريم يستعمل هذه الأساليب الثلاثة في آن معًا، ويضيف أسلوبًا رابعًا هو من اختصاصاته، ويُعتبر من معجزات الإسلام، حيث تحاول المدارس الإصلاحية والثورية المتأخّرة أن تقتبس منه.
إن القرآن الكريم يأمر وينهى بمختلف التعابير والوسائل، ويذكر الدليل تلو الدليل، ويعتمد على الفطرة وعلى المرتكزات الراسخة عند الشعوب، وعلى العبَر التي يمكن استخلاصها من الأمم السالفة، ويستعمل ألفاظًا تشبه الأدلّة، مثل كلمات الطيّبات والخبائث، ويذكّر دائمًا برحمة الله ومحبّته ونِعمه وعلمه بمصالح الناس، كلّ ذلك حتى تكون القناعة المقترنة بالمشاعر (متوجّهة) نحو الوظائف (الأسلوب الثاني).
ولقد أعلن الرسول الأعظم في خطبة الوداع: "أيّها الناس، ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلّا وقد أمرتُكم به، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلّا وقد نهيتكم عنه".
أمّا اهتمام الإسلام بتكوين البيئة الصالحة فيبدو من تعاليمه القاطعة حول وجوب إقامة المجتمع الإسلامي، ومن توجيهه التامّ من أجل مناخات ملائمة كالجماعة والجمعة والحجّ وشهر رمضان والأعياد، ورفض الاعتزال عن الناس وعدم اعتزال الجماعة، والمنع عن عِشرة المفسدين والفسَقة والعصاة إلّا لإصلاحهم وهكذا.
ومع ذلك كلّه، يستعمل القرآن الكريم أسلوبه الخاص الذي يمكن أن نسمّيه ثورة في المفاهيم، أو تحوّلًا عميقًا في الرؤية العامة للكون والحياة وارتباط الهدف التربوي.
وعندما يرسم القرآن الكريم صورة الخلق والموجودات والحياة من خلال العقائد ومن خلال المعلومات التي تضيفها آياته البيّنات إلينا، فإنه يحاول خلق مناخ كوني عام في ذهن الإنسان يحسّ معه بأن البقاء والنجاح والخلود هو في الالتزام بالتوجيهات الإسلامية، وأن الوجود ينبذ كلّ فرد وكلّ جماعة لا تنسجم مع هذه القواعد، وأن مصيرهما هو الفناء والنسيان.
إن هذا الأسلوب في تفوّقه على الأساليب السابقة لا يقبل الجدل، وله مزايا متعددة نحاول تعدادها بعد إيضاح معالم هذا الأسلوب واستعراضه.
في سورة الرحمن الآيات 7-9 منها: ﴿والسماء رفَعها ووضَع الميزان ألاّ تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تُخسروا الميزان﴾، نلاحظ الربط بين طلب عدم الطغيان في الميزان وإقامة الوزن بالقسط، وبين رفع السماء ووضع الميزان الذي هو تعبير عن الحساب والنظام والعدالة الكونية.
وفي سورة آل عمران الآية 1: ﴿شهِد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط﴾ ، وهنا تأكيد على قائمية الله بالقسط، ونجد آيات أخرى كنتيجة للآية الأولى، وأوضحها: ﴿إنّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيّين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشّرهم بعذابٍ أليم﴾ [آل عمران، 21]، حيث إن الإدانة لمعادي القسط ولخصوم العدالة معلَّلة بقائمية الله بالقسط وثمرة من ثمارها.
وفي سورة الأنبياء نقرأ: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين﴾، وفي الآية، 18 نصل إلى بعض نتائج هذا المبدأ: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء، ١٨].
وفي بعض المقامات ترِد النتائج قبل المبادئ، ومنها الآيات: 25-29 من سورة الدخان: ﴿كم تركوا من جنّات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك و أورثناها قوماً آخرين * فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين﴾، ﴿ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين * ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ [الدخان، 38-39]، حيث إن فناء الذين يتركون الجنّات والعيون دون أيّ ردّ فعل، لأن قوم تبّع كانوا أقوى منهم، وهم تنكّروا للبعث والحساب، أقول إن فناء هؤلاء أثر طبيعي لخلق السماوات والأرض مبنية على الحقّ.
الآيات التي تؤكد أن الخلق كان في ستة أيّام وأنه كان خلال أجل مسمّى، مع وضوح معنى الأيام في المصطلح القرآني وأن المقصود منها في المراحل والعهود، كما يتّضح ذلك في مقدمة سورة فصّلت. أقول إن التأكيد على كون الخلق حصل خلال أجل مسمّى "ستة أيام" تمهيد للنتائج المهمّة التربوية التي تنتج عنها، وهي حسب الوصف القرآني انهزام الروم بعد غلبتهم، وأنهم يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا (سورة الروم)، وضرورة التوجه إلى الله ودعائه تضرعًا وخفية وخوفًا وطمعًا (سورة الأعراف)، وتشجيع المؤمنين العالِمين بالقسط والملتزمين بالسنن والحساب والمتفكرين في اختلاف الليل والنهار والظواهر الكونية الأخرى (سورة يونس)، والاختبار في العمل في السباق نحو الصالحات (سورة هود).
وأخيرًا وليس آخرًا، للتوكل على الله وتسبيحه وذِكره، والصبر على ما يقولون استهزاءً وشماتة وافتراءً (سورة الفرقان وسورة ق).
ومجمل القول إن التربية القرآنية تعتمد على توفير الوسائل التربوية المعتمدة، بالإضافة إلى التقيّد بأصول الدين وما تعكسه الأصول هذه من القواعد العامة للخلق وتأسيسه على الحقّ والعدل والأجل المسمّى وغير ذلك من الأساسات التي يعلنها القرآن ويربط بينها وبين المطالب التربوية، وتوجيه حياة الإنسان الذي يريد النجاح نحو المسلك القائم على العدل والحقّ، والمنطبق على صفات الله وتعليمه باعتماد خطّة عمل قائمة على أساس جدول زمني لا متنكرًا للزمن ولا مهمِلًا للتحديد كما هو الحال في الخلق.
ثانيًا، نتائج هذا الأسلوب:
ولمثل هذا الأسلوب القرآني نتائج كثيرة:
أوّلها، تمتد أبعاد العمل المطلوب في تصوّر المربّي وفي الواقع إلى البعيد، فتصل إلى الأزل والأبد وإلى الأرض والسماء وإلى أساس الخلق...
وهذا الإحساس يضمن تأثير التربية كما يصون استمرارها.
ثانيها، أن الإنسان أمام هذا الأسلوب يشعر بالمواكبة العالمية، وأن الموجودات كلّها ترافقه، ولا يحسّ أبدًا بالغربة حتى ولو كان سلوكه مخالفًا أو متناقضًا أو محاربًا مع سلوك الآخرين، ويلمس معنى الحديث الشريف: "لا يهولنّك طريق الحق وإن قلّ سالكوه".
وهذه الميزة بالذات واردة في القرآن الكريم، عندما يؤكّد سجود الشمس والقمر والنجوم والأشجار والبحار والرعد والدواب، ويكرّر أنها كلها ساجدة لله مصلّية له، والإنسان بفطرته وبجسمه أيضًا يمشي في هذا الركب الكوني الكبير، وهذه المواكبة تسهّل جدًا على الإنسان أن يطيع الأمر والنهي وأن يسجد ويسبّح ويصلّي ويعمل الصالحات.
وثالثها، تلاقي كافة طاقات الفرد في جميع أحواله وأزمانه، وتلاقي طاقات الجماعة بمختلف الفئات والمستويات، ذلك لأن المنطلق واحد، والخطّ واحد، والأسلوب واحد، وبذلك تتكون قوّة كبيرة من الطاقات لا تعجز عن تحقيق أيّ هدف مهما كان صعبًا ومستعصيًا. إن طاقات الفرد كثيرة ولكنها تتشتت، وطاقات الجماعات تفوق درجة التصور، ولكنها تتناقض ويصطدم بعضها ببعض، ومع توجيه هذه الطاقات وتنسيقها وتجنيدها فإن القوّة الذاتية للأمة لا تُهزم.
ثالثًا، طريقة القرآن لعرض الإسلام والدعوة إليه:
وبعد أن نستوعب هذا الأسلوب القرآني المعجز للتربية، نصل إلى نقطة أساسية أخرى قد تكون كبرى لبحثنا التربوي، ألا وهي وحدة الإسلام، مع العلم أن الإسلام لدى المسلمين وحتى لدى العلماء والباحثين ولأسباب تعليمية ينقسم إلى عدة أقسام:
- علم العقائد والعلوم المتعلقة به كالفلسفة الإلهية.
- علم الكلام وعلم الفقه بأقسامه العديدة (عبادات ومعاملات وسياسات وأحكام مع الكتب المتعددة في كلّ قسم).
- وأخيرًا: علم الأخلاق.
ونشاهد أيضًا أن تقسيم الإسلام إلى أصول يحتاج إلى إيمان ودليل قاطع، وإلى فروع، وهكذا...
إن هذه التفصيلات التي حصلت بدواعٍ علمية، وعلى أساس درجة الأهمية أحيانًا، خلقت نوعًا من الضعف التربوي وكثيرًا من الاستهتار، حتى بلغ الأمر ببعض المسلمين أن يعتزّوا بإسلامهم في قلوبهم، ولكنهم يصارحون بعدم الالتزام بالعبادات.
أمّا البُعد عن الأخلاقيات الإسلامية فإنه مرض شائع حتى عند المتدينين، وكذلك يجهل الكثيرون من المسلمين مسائل الحياة الاجتماعية والسياسية.
ويعود السبب في جميع ذلك إلى هذا التقسيم الأكاديمي للإسلام. أمّا القرآن الكريم فإنه يقرن المسائل العقيدية بالمسائل العملية، ويربط بينهما وبين الأخلاق كما شاهدنا ذلك في أسلوبه التربوي.
ففي بدايات سورة البقرة، يصف المتّقين بصفات خمس: ثلاث منها عقيدية، وهي: الإيمان بالغيب، والإيمان بما أُنزل إلى النبي وإلى الأنبياء، واليقين بالآخرة؛ واثنتان منها من المسائل العملية، وهما: الصلاة والزكاة، تأكيدًا على أن الصلاة هي صيانة الإيمان بالغيب، وأن الصلاة من دون الزكاة تستحقّ الويل (سورة الماعون). وقلّ ما يرِد في القرآن دون ذكر العمل الصالح، مع أنهما في حسابات التقسيم الفنّي من مقولتين مختلفتين.
وفي دراسة دقيقة للأحكام الإسلامية، نلاحظ التفاعل الواضح بينها، وأن الممارسات العملية هي ذات تأثير واسع على الإيمان، والإيمان قاعدة للأخلاق ويتأثر بها أيضًا، كما وأن المسائل العقيدية ترسم الخطّة العامة للقضايا الاجتماعية ورؤاها.
وهذه التفاعلات يشير إليها القرآن الكريم في أماكن متعددة، منها: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوأى أن كذّبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤون﴾ [الروم، 10]، ﴿بل يريد الإنسان ليفجر أمامه * يسئل أيان يوم القيامة﴾ [القيامة، 5-6]، فالآيات هذه تؤكد تأثير الأعمال على العقيدة.
والأحاديث عندما تحرّم الكِبر، تعتبره نوعًا من الشرك والتشبّه بسلطان الله عزّ وجلّ، والكثيرون من الكفّار وكبيرهم إبليس استكبروا فكفروا: ﴿خلقتَني من نار وخلقتَه من طين﴾ [الأعراف، 12].
أمّا تأثير أصول الدين سيّما التوحيد، فينعكس على العبادات وعلى ترويض الإنسان وإصلاحه لكي يصبح متعاونًا متفائلًا، يعامل أخاه الإنسان بانفتاح وحُسن ظنّ وتكافؤ، دون أن يتّخذ منه إلهًا أو شيطانًا أو عبدًا. وكذلك، تأثير المعاد على دقّة الإنسان في سلوكه ومحاسبته لنفسه وإحساسه بالمسؤولية، وغير ذلك من التفاعلات والتأثيرات، فهي تفوق إمكانية البحث والحصر.
إن الدراسات الإسلامية تحتاج إلى مادة خاصة بوحدة الإسلام واعتباره كُلًّا لا يتجزأ، ويجب التحدث فيها عن ترابط الأحكام، ولا بدّ من اعتبار هذه المادة ضرورية لجميع الدارسين والدعاة.
رابعًا، في المسائل التربوية الحادة المعاصرة:
يمتاز عصرنا بأنه عصر الاختصاصات، ولا يمكن تصنيف الناس إلى عالِم وجاهِل، بل أكثر الناس أصبحوا علماء كلٌّ في اختصاصه، وهذا بحدّ ذاته يجعل الدعوة والتربية أصعب مما كانت سابقًا.
ومن جهة أخرى، فإن الأفكار السياسية التي تنطوي في الأغلب على مطامع اقتصادية، أصبحت اليوم تتبنّى عقائد وآراء فلسفية تدعو إليها بجميع الوسائل، وتنطلق من طبيعة مروّجيها والمؤسسات العالمية التي تؤيّدها، وهي مزوّدة بأحدث الأسباب وأدقّ الأجهزة وأغنى الوسائل.
وهذه المدارس التي تحارب الأديان، تتبنّى في نفس الوقت طرق الدعوة الدينية وتطلب الإيمان بمبادئها، وتقف بقوّة وبخطط مدروسة ضدّ دعوتنا الإسلامية، ولا تتورّع عن استعمال جميع الطرق للقضاء عليها.
وليس التهجّم على المؤسسات الدينية وعلى العلماء هو الوسيلة الوحيدة لديها، بل تخلق الانقسامات والخلافات الداخلية وتجنّد عناصر -بعلمها أو بدون علمها- للتصدّي للقادة الروحيين ولتحدّيهم، وإثبات عجزهم عن تحمّل المسؤولية.
إذًا، علينا أن ندرك أن مجتمعاتنا أصبحت ساحة الصراع العقيدي متعدد الأطراف، مع عدم التكافؤ في الوسائل والأسباب.
ومن جهة ثالثة، وبسبب اعتماد السياسات على واجهات عقيدية، فإن تعدد السياسات الحاكمة في بلاد الإسلام جعل التشتت الفكري بين البلاد وداخلها أمرًا محتومًا.
ثم إن الوضع المؤلم وتصاعد التشكيك في القيادات يدفعان بالكثير من الأفراد والجماعات لأن يتصدّوا للمشكلة، رغم عدم كفاءاتهم بسبب الآلام النفسية، وهذا الوضع بدوره يدفعهم إلى معالجات خاطئة متطرّفة أحيانًا، مسايرة مايعة أحيانًا أخرى، ولكلّ من الطريقتين ردود فعلهما وتفاعلاتهما الاجتماعية، ومن جملتها التعرّض للأقلّيات التي هي بدورها مصابة بمثل هذه الأمراض، فيضعها في جوّ الدفاع أو يعطي المستعمر ذريعة تجعل الأقلّيات في أجواء الدفاع عن النفس، فتزداد الصعوبات، وهكذا.
كلّ هذه المِحَن، ولا نزال نتحدّث عن الأرضية التربوية الموجودة في عالمنا الإسلامي دون أن نذكر إسرائيل وشرورها وسمومها ووسائلها المتنوعة الخطرة، ودون أن نتحدّث عن الاستعمار وقدرته وحبائله وثقافاته وتبشيره. فإذا أردنا استعراض الوضع مع هذه العناصر الأساسية، وحاولنا دراسة المشكلة بجميع أبعادها، فإن الأفق يبدو حالكًا، والمستقبل مظلمًا، والعواصف الهوجاء تعصف بنا من كلّ جانب.
هل المِحَنة القاسية تدعونا إلى اليأس؟ كلا. ﴿إنه لا ييأس من روح الله إلّا القوم الكافرون﴾ [يوسف، 87]، ولكن الاستهتار بالمشكلة وعدم الاستعداد لمواجهتها لا يجتمعان مع روح المسؤولية، فالمبدأ الذي نرفض به اليأس يأتي بعد قول يعقوب: ﴿يا بنيّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه﴾ ]يوسف، 87[.
خامسًا، بعض المقترحات:
إن من عنايات الله وجودنا الآن في مؤتمر يضمّ علماء المسلمين من أقطار العالم، وهو المؤتمر الثامن، يعني أن أمامه مجموعة من التجارب تمكنّه من تقييم الأمر. ووجود مجمع البحوث الإسلامية دليل على عزم الأزهر الشريف على مواجهة المشكلات بروح المسؤولية التامّة. ولست هنا لأقترح مزيدًا من الأعباء والتكاليف على الأزهر دون أن أدعو نفسي ورفاقي في المؤتمر لأجل تحمّل مسؤوليات المرحلة المعاصرة، فالمقترحات للدرس والمناقشة ولكي يقوم كلٌّ منّا بدوره.
إن القيادة المسؤولة عن الإسلام بحاجة إلى عناصر ثلاثة:
أولًا، تكثيف الجانب الروحي والتهذيب النفسي للدعاة، فالعالم اليوم رغم تقدّمه المادي، بل بسبب هذا التقدّم متشوّق إلى الصفاء الروحي والتنّزه عن الماديات، ولا بدّ من الاعتراف بأن مظاهر الكثير من علماء الدين لا توحي بهذا.
لا أقول إن العالِم الديني والداعية يجب أن يترك متعة الحياة الدنيا، فإن الإسلام يرفض الرهبانية، وعليّ (ع) يقول: "ليس الزهد ألّا تملك شيئًا، بل الزهد ألّا يملكك شيء". بل أقول إن نموّ الوضع المادي المحيط بالإنسان يجب أن يرافقه النموّ في الجانب الروحي لكي لا ينجرف، وهذا ما نطالب به بإلحاح.
إن ذرّة من الروحانية لا تزال تتغلب على الكثير من الأسباب المادية وتجاربنا في أقطار العالم، حتى في البلاد المتقدمة جدًا تثبت ذلك.
ثانيًا، وضوح الاهتمام بوضع المعذّبين، وعدم الرضا بسلوك الظالمين، والسعي الدائم للتخفيف عن آلام الناس، والغضب على من يحرمهم حقهم.
لماذا نترك النضال في سبيل الطبقات الكادحة أو المستثمرة تحتكره الأحزاب الإلحادية، والإسلام لا يقبل إيمان من بات شبعانًا وجاره جائع؟
ألَم يأمرنا الرسول الكريم بأن نُنكر المنكر بيدنا أو بلساننا أو بقلبنا؟ وعلى جميع الافتراضات، فإنه غير راضٍ حتمًا عن مسايرة الظالمين والركون إليهم.
إن الإنسان المعاصر معذَّب، يشعر مهما بلغ بدرجة من الحرمان، ويحمّل الأنظمة والأشخاص مسؤولية حرمانه وعدم توفير الفرص المتناسبة له، وهو ينتظر أن يحسّ في الداعي أو العالِم المسلم حرارة النضال وصرخة الحق.
ثالثًا، تطوير الشكل وتحديثه يعني الاستعانة بالوسائل المتطورة والأساليب الحديثة لعرض الأفكار والأحكام ولتنظيم المؤسسات الدينية، بحيث تصبح من حيث الشكل ووسائل العمل بمستوى المؤسسات العالمية.
إن إحصاءً دقيقًا ومتجددًا عن المسلمين في العالم وعن شؤونهم التربوية، وعن قادتهم الروحيين، وعن مؤسساتهم الدينية والثقافية، وعن كتبهم وجرائدهم وحصصهم في الإذاعة المسموعة والمرئية وعن إمكانياتهم، كلّ ذلك هو من أوليات التطوير المؤسس، علمًا بأن أَولى المؤسسات بهذا الأمر الذي لا تتحقق الرعاية بدونه هو الأزهر الشريف.
إن آلام بعض المسلمين في العالم أمثال المسلمين في الفليبين وأريتريا والحبشة معروفة، ولكن المعلومات المتفرقة تؤكد وجود مآسٍ أخرى لا تقلّ عن مأساة هؤلاء في تايلند وسيام والمجر وغيرها.
وفي حدود مشاهداتي، لم يكن موقف المسلمين العرب وغيرهم تجاه محنة المسلمين في لبنان يتناسب مع عظمة المحنة، وكان هذا ناتجًا عن عدم معرفتهم بواقع الأحداث التي جرت في لبنان وتجري حتى الآن في جنوبه.
إن وضع المذاهب الإسلامية في أقطار العالم يجب أن يتعالج بسماحة وجدّية كبيرتين، سيّما بالنسبة إلى أولئك الذين انحرفوا عن أركان الإسلام بسبب بُعدهم عن ظهور مبتدعين بينهم.
إنني لا أعرف حتى الآن اهتمامًا بالمستوى المطلوب بهؤلاء الناس أبدًا، اللهم إلّا طرد البعض لهم، وقبول الآخرين دون علاج لأمرهم، وذلك رغم تعطّشهم الكبير لتصحيح أفكارهم، والشوق إلى التلاقي مع إخوتهم في الدين.
إن المؤسسات المعنيّة بشؤون المسلمين من مؤتمرات ومراكز ثقافية وغيرها أصبحت كثيرة، وهناك نشاطات واسعة يقوم بها الأفراد. ولقد آن الأوان لأن يصبح مجمع البحوث هو الهيئة القيادية العليا التي تتمثل فيها المؤسسات والمؤتمرات الإسلامية، وهذا الأمر يتطلب تخصيص هيئة من كبار علماء المسلمين ومن أعضاء المجمع أو المؤتمر أو من غيرهم وبتكليف من المجمع للقضايا العلمية، وتفرّغ المجمع وأمانته العامة للقيام بمهمّة رعاية المسلمين في العالم ودرس أحوالهم وتتبّعها، وعند ذلك يصبح المؤتمر هذا هيئة عامة، ويصبح المجمع المتفرّع أمانة عامة دائمة.
وغنيّ عن القول إن الجميع حسب هذا الطرح يبقى على صلة دائمة بأعضاء المؤتمر وبغيرهم لادّخار المعلومات التي ترده بانتظام، وبتبويبها، وإرسال تقارير بشأنها.
ومن أهمّ الأعمال المطلوبة من مثل هذه الهيئة القيادية هو تنسيق النشاطات التي تصدر في العالم، لكي لا يُطبع كتاب أو يُترجم مرّات مختلفة، بل يزوّد المجمع سائر المؤسسات في العالم بذلك، توفيرًا للطاقات وتوجيهًا نحو الفراغات.
وحول المؤتمر وقراراته: لا بدّ من وقفة جريئة مخلصة، ومن السعي لعدم إصدار قرار -أيّ قرار- أكثر من مرّة، ومن البحث حول الأسباب التي منعت تنفيذ القرارات التي صدرت مرارًا منذ المؤتمر الأول، ومن الامتناع عن إصدار أيّة قرارات دون توفير شروط تنفيذها، وإلّا فليكتفِ المؤتمر بإصدار فتوى أو توصية.
__________________
* بحث قدمه المؤتمر الثامن في مجمع البحوث الإسلامية المنعقد القاهرة بتاريخ 22 تشرين أول 1977، من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.