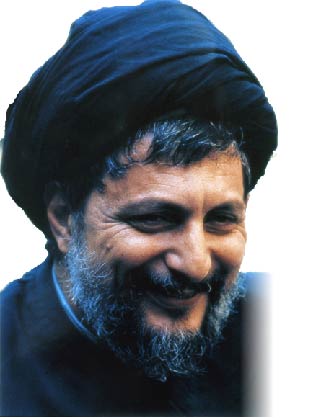* مخطوطة بيان المؤتمر الذي ألقاه الإمام الصدر بتاريخ 19 تشرين ثانٍ 1969 في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، وذلك عن الأخطار المحدقة في الجنوب، منشورة في الصحف اللبنانية بتاريخ 20 تشرين ثانٍ 1969.
إخواننا أعضاء الجمعية،
هدية العيد المبارك لكي لا يفوتنا هذا الرمز، رمز الذكرى ولو كان قليلًا في مادته، لكنه كبير في معناه ومحتواه.
بسم الله الرحمن الرحيم
بعدما سمعنا من مختلف جوانب ذكرانا ذكرى ولادة بقية الله في الأرض، لا بد لي أن أجمع وأبوب معكم ما سمعناه من الأبحاث القيمة والدراسات والأدب الرفيع والعاطفة الصادقة الإسلامية، لا بد لي أن ألخص ما سمعنا.
أولًا، خلاصة العقيدة:
كما تعلمون نحن نعتقد أن رسالة الله الإسلام بجميع أحكامه وفرائضه وسننه، وجميع تعاليمه قد أوحى الله بها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد بلغ وأتم الرسالة قبل وفاته. ولكن بلغ الرسالة للأمة، بعض الأحكام وصل إلى جميع الأمة، وبعضها بقيَ في صدور الذين أُوتوا العلم، بقي مخزونًا عند الأمناء لكي يبلغوا الأمة في وقت الحاجة. ولهذا، إذا قلنا إن هناك الكثير الكثير من الأحكام قد بُين بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما يشهد لنا التاريخ، ما بالغنا وما قلنا شيئًا غريبًا. نعم، إن هناك موارد عديدة بعد النبي الكريم اختلف الأصحاب في حكمها. فقال عليّ (عليه السلام) نقلًا عن رسول الله تلك الأحكام وأجوبة تلك المسائل، وهذا موجود في جميع التواريخ، ليس معنى هذا أن عليّ (عليه السلام) كان يوحى إليه -نعوذ بالله هذا كفر، فرسول الله خاتم الأنبياء- ولكن، كما أنه قد أودع عند بعض أصحابه أحكامًا، فقد أودع كذلك عند عليّ وهو الباب لمدينة علم الرسول ألف باب من العلم، من كل باب ينفتح ألف باب. وهذه العلوم التي كانت تشمل العقيدة والفقه والأخلاق والتفسير والمفاهيم الإسلامية كانت موضوعة عند الأئمة الطاهرين (عليهم السلام).
هذا الدور قد أداه أئمتنا (عليهم السلام) بكل إتقان وبكل إخلاص وتغلبوا على جميع المشاكل والمصاعب وإن كان الدور الأساسي، أي دور تكوين الأمة وإيجاد مجتمع صالح وتكوين حكمٍ صالح، هذا الدور ما سمحت به الأمة مع الأسف من سوء حظها أن يؤديه أئمتنا (عليهم السلام) حتى يوصلوهم إلى المحجة البيضاء، كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعبر عنه.
هذا الدور، أي توجيه الأمة عند المشاكل وعند جهلهم وعدم معرفتهم، يتبين بوضوح في أيام أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) مع الصحابة فكان لهم مشيرًا ووزيرًا، وإن لم يكن عليهم أميرًا بحسب الظاهر، والتاريخ يشهد بذلك، ونحن في غنى عن ذكره في مسائل أساسية نُقلت عن الإمام واستشير الإمام بشأنها بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وهكذا انتقل الدور إلى الأئمة المعصومين (سلام الله عليهم) وهذا الدور بلغ ذروته حين إمامة الإمامين أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق (عليهما السلام). والسبب أن المجتمع الإسلامي كما تعلمون كان محصورًا في مدينة الرسول ثم توسع بعض الشيء، وكانت الحياة بدائية وبسيطة وغير معقدة والحاجات قليلة والموضوعات معروفة متشابهة. ولكن حينما اتسع الفتح الإسلامي والتقت الحضارة الإسلامية بالحضارات الإسكندرانية واليونانية والكلدانية والهندية والفارسية نتيجة لتلاقي هذه الحضارات أنه دخلت على المجتمع الإسلامي أفكار جديدة، ومواضيع جديدة، وتساؤلات جديدة ومفاهيم جديدة ما كانت الأمة تعرفها من قبل، فتجد الأبحاث التي أُثيرت في أوائل القرن الثاني من الهجرة حول المسائل الكلامية والمسائل الفلسفية تجد أنها ما كانت معهودة عند المسلمين من ذي قبل.
المواضيع الجديدة، نوع الحياة الجديدة ما كان معهودًا عند المسلمين من ذي قبل، المشاكل والحوادث وطبيعة اتساع المجتمع واللقاءات العديدة التي حصلت، والعلوم الجديدة التي دخلت ما كانت معهودة عند المسلمين. فهنا ترى الأئمة (سلام الله عليهم) وفي طليعتهم عملًا ونشاطًا لأجل موافقة الظروف، الإمام الباقر والإمام الصادق تراهم مثل الأسود يحملون المشاعل فيتركون للناس ما حملوه، وما أُمنوا عليه من ألف باب من العلم من كل باب ينفتح ألف باب، فيذكرون للناس التفاسير الجديدة والأبحاث الجديدة والأجوبة الجديدة والحلول الجديدة للمشاكل؛ وكل هذه الأمور مستقاة من أحاديثهم المنقولة عن النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) والموضوعة عندهم لتلك الأيام.
وهكذا نتمكن أن نبين سببًا من الأسباب لتعداد الأئمة الاثنا عشر، اثنا عشر جيل في كل جيل حدث تطورات وأحداث وتبينت أمور جديدة، فوجودهم كان ضمانة لبقاء الأمة في خطها الأصيل وعدم ذوبانها وانحرافها، وإلا فما رأيكم لو لم يكن هذا الموقف القيادي التوجيهي من أئمتنا؟ كانت الأمة تضيع وتذوب في التيارات الفلسفية اليونانية أو التيارات العلمية المصرية الإسكندرانية أو التيارات الفلسفية الصوفية الهندية أو التيارات الحضارية الحمورابية أو الكلدانية أو الفارسية وأمثال ذلك. صيانة هذه الحضارة وسلامتها وبقائها في الخط الذي رسمه الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كان بيد أئمتنا (سلام الله عليهم) الذين عاصروا الأجيال المتتالية. فنحن آمنا بإمامة هؤلاء وقيادتهم، وأنهم مقاييس الحق وموازين العدل ومصابيح الهدى في طريقنا وفي خطنا.
ثم جاء دور المهدي المنتظر (سلام الله عليه) فنحن نؤمن بأنه ولد في سنة 255 ه وأنه ولد من الإمام أبي محمد الحسن العسكري أبيه، وأمه نرجس كما تعرفون. ثم غاب في ظروف غامضة شبيهة بظروف ولادة النبي موسى (عليه السلام) كما يشير إلى هذا كثير من الروايات. ففكرة المهدي كما سمعتم من فضيلة العلامة الأخ الشيخ محمود، كانت فكرة شائعة بينهم، معروفة بين جميع الأمم وبين المسلمين، وقد وجد بين الأمة بالذات دعاة يدعون المهدوية كاذبون، مثل: محمد النفس الزكية الملقب بالمهدي، ابن عبد الله المحض كان يدعي أنه هو المهدي الموعود. فكرة المهدي كانت شائعة لأن الروايات الواردة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متواترة، مئات من الروايات موجودة في مختلف كتب المسلمين من جميع الفرق ولا تختص الروايات بأحاديث الشيعة الإمامية أبدًا، بل الأحاديث الموجودة عند سائر مذاهب المسلمين أكثر من الأحاديث الموجودة عند المسلمين.
انتظار المهدي كان أمرًا شائعًا بين الأمة، ولهذا، بعض الخلفاء حجز على الإمام الهادي والإمام العسكري وأسكنهما -بعض الخلفاء العباسيين المتأخرين- في معسكرات الجيش. في ثكنات الجيش حفاظًا على السر الموعود والوليد المنتظر العتيد حتى يتمكنوا من القضاء عليه؛ ولهذا، سُميا بالعسكريين: الإمام العسكري، لعل هذا وجه التسمية بكلمة العسكري.
الإمام المهدي وُلِدَ وغاب، أو أخفاه أبوه مدة من الزمن حتى دنا أجله، أجل الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) فعرفه على الأمة وعرف جماعته عليه، ثم غاب الغيبة الصغرى وكان له -للإمام المهدي (عليه السلام)، ألخص لكم العقيدة- وكان له في أيام الغيبة الصغرى نواب أربعة مخصوصين، كانوا على اتصال مباشر معه وكانوا ينقلون عنه أحاديث وروايات وكان كبار علماء الشيعة كالكليني والصدوق وابن الوليد وأمثال ذلك من أكابر محدثي الشيعة بالرغم من أنهم كانوا أجل قدرًا وأكثر علمًا وأكثر اشتهارًا من النواب الأربعة كانوا يخضعون للنواب الأربعة خضوعهم لأئمتهم، يأخذون منهم الأحاديث؛ حتى جاء وقت الغيبة الكبرى، فغاب الإمام المهدي، بحسب عقيدتنا نحن أنه حي باقٍ إلى الآن. ولا شك كما سمعتم أن هذا العمر عمر غير طبيعي أو غير عادي ربما يستصعبه الإنسان ويتعجب منه، ولكن ما أكثر ما تعجبنا، ما أكثر الأشياء التي تعجبنا منها ثم رأيناها أمام أعيننا، لو كان سابقًا قبل خمسين سنة أو مئة سنة أحدهم يقول إن الإنسان يتمكن أن يطوي أرضًا أو بحرًا أو مسافة تبلغ عشرات الألوف من الكيلومترات في خلال ساعات أو أيام نادرة لكنا نقول إن هذه معجزة أو غير عادية أو غير طبيعية، ولكن العلم كشف عنها.
فإذًا، وجود الشيء الغريب ليس معناه الاستحالة، فالاستحالة غير موجودة لأن المنطقيين أو الفلاسفة يقولون إن الاستحالة اجتماع النقيضين أو اتفاق النقيضين وأمثال ذلك، والعقل لا يتعجب من ذلك. وإنما عادتنا وتعودنا على مشاهدة معدل العمر البشري في عصرنا هذا يوجب العجب من هذا العمر الطويل، ولكن العقل لا يحكم بالاستحالة بل العقل يحكم بالإمكان، ولأجل تقريب الفكرة إلى الذهن سمعتم بعض المؤيدات وبعض الأبحاث.
فإذا لاحظنا الناحية الفلسفية، الفلاسفة يقولون حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز على حد سواء. لو كان الموت أمرًا ضروريًا ذاتيًّا للبشر لكان يأتي في وقت محدد معين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر بالنسبة لجميع البشر على حد سواء. فحينما نرى أن رجلًا يموت في الستين من عمره وآخر في التسعين وآخر يموت في المئة وآخر يموت في السابعة عشر نعرف أن الموت الذي يمكن تأخيره وتقديمه عشرة أو عشرين سنة يمكن تأخيره مئة سنة ومئتين وثلاثمئة سنة، هذا الرأي الفلسفي. طبعًا، ليس المجال مجال التفصيل فيه، ولكن إذا لا نريد أن نتكلم عن البحث الفلسفي، نتكلم عن الفكرة البديهية الطبيعية الفطرية عند البشر، هذا البحث الجميل الذي سمعتم، بدليل أن الناس يفكرون في تطويل العمر، والأطباء يحاولون تطويل العمر، والمختبرات تشتغل في موجبات تطويل العمر، وقد نجحوا إلى إكثار معدل عمر البشر خمس أو عشر سنوات. بنفس الدليل، يدل على أن البشر يعتبر أن هذا الشيء ممكن ولهذا يسعى لأجله؛ لو كان الشيء غير ممكن ما كانوا فكروا فيه وهذا دليل على أن الفطرة البشرية والبداهة الإنسانية تحكمان بسهولة أو بإمكان تطويل العمر أكثر من العمر الذي يعيشه الإنسان. هذا الدليل العقلي أو الدليل الفطري.
ثم إذا جئنا إلى العلوم نرى أن الإنسان بالذات والموجودات الحية مثل الإنسان كالنبات وكالشجر هذه الأمور، الإنسان والحيوان والأشجار تختلف عن جميع الموجودات في العالم مثلًا: هذه الطاولة، هذا الميكروفون، السيارة، الجبل، كل شيء في العالم، كل جامد في العالم له حد من العمر، لماذا؟ لأن له حد من الاستعداد للبقاء ممكن 10، 20، 30، 40، 50 سنة وحتى إذا أتقنت تبقى 50، 60 سنة، لكن الإنسان والحيوانات غير شكل هذه الطاولة لها عمر 10، 15، 20 سنة ينتهي لماذا؟ لأن أجزاء هذه الطاولة أو هذا الميكروفون أو هذه السيارة، أجزاؤها أو حسب تعبير العلم الحديث خلاياها واحدة لا تتغير، هذه الخلايا موجودة وقت أنت تمسح أو تستعمل أو تركب السيارة أو تستعملها تعتق، تشيخ وتموت.
أما الإنسان، ما الفرق بين الإنسان والموجود الآخر؟ الإنسان ليس موجودًا واحدًا، الإنسان سلسلة من الموجودات، إسألوا الشباب، أبناءكم يقولون لكم إن الخلايا الحية يعني ذرات جسد الإنسان تعيش مدة ثم تولد خلايا جديدة، الخلايا الجديدة تبقى والخلايا القديمة تموت وتتحول إلى أوساخ فتخرج من البدن بواسطة البول أو الوسخ أو الشعر أو بعض أنواع العظم أو الظفر، ثم تدفع إلى خارج الجسد وتبقى الأجزاء الجديدة الشابة في جسد الإنسان. ويقول كثير من الأطباء والعلماء إن جسد الإنسان في خلال 13 سنة أو 14 سنة دفعة واحدة تتغير جميع خلاياه، يعني قبل 13 سنة كان في جسمي أجزاء اليوم غير موجود منها ولا ذرة، لا ذرة من الجلد ولا من اللحم ولا من العظم ولا من العصب ولا من الدم، أبدًا كله راح، تحول إلى أجزاء جديدة.
فإذًا، أظن الكلمة واضحة. الإنسان عدة موجودات، وليس موجودًا واحدًا، موجودات ولها أولاد، والأولاد يقومون مقام الآباء وهكذا. يعني هذا الموجود الذي نحن نراه شيئًا واحدًا هو ليس شيئًا واحدًا، سلسلة من الأشياء، إنما طبيعة جهل البشر تجعل الخلايا الجديدة أقوى من الخلايا القديمة فترة صعود الإنسان يعني من أيام الطفولة إلى أيام الشباب، ثم يبدأ دور الشيخوخة، فالخلايا الجديدة أضعف من الخلايا السابقة وهكذا يبدأ الانحطاط والوصول إلى أرذل العمر. فلو تمكن العلم أن يعطي دروسًا ويؤسس ظروفًا ويهيئ أغذية ووسائل يتمكن من أن يجعل من الخلايا الجديدة خلايا أقوى من الخلايا السابقة أو متساوية فيمتد عمر الإنسان، وقد تمكن العلم من إنجاز بعض هذا في مختبراتهم وفي وسائلهم. والدليل على الإمكان أن هناك كما سمعتم حيوانات تعيش أكثر من ألف سنة، وأشجار تعيش أكثر من ألف سنة مع أن مشكلة تحول الخلايا ومشكلة استمرار وإمكان الجزء الواحد للعيش مدة من الزمن متشابهة بين الإنسان وبين الحيوان وبين الأشجار.
فإذًا، العلم أيضًا يعترف بإمكان طول العمر، ثم كما سمعتم التاريخ يشهد بعض الشيء لأشخاص عاشوا 120، 150، 180 سنة، والتاريخ القديم يشهد لأشخاص عاشوا أكثر من هذا ونحن نقرأ في القرآن الكريم أن نوح (عليه السلام) دعا في قومه 950 سنة ما عدا قبل الدعوة وما عدا بعد الطوفان يعني يصير أكثر من ألف سنة، وهكذا في قضية يونس صاحب الحوت، و: ﴿لولا أنه كان من المسبحين * لَلَبِثَ في بطنه إلى يوم يبعثون﴾ [الصافات، 143-144]. لبث ليس معناها مات، لبث يعني توقف عن الحركة وهو حي، لبث في اللغة العربية يستعمل في الشيء الذي ممكن أن يتحرك ولكن لا يتحرك، عدم الحركة حسب تعبيركم، لبث يعني وقف وتأمل.
فإذًا، مشكلة الاستحالة غير موجودة، ممكن علمًا، ولكن شيء غريب وقدرة الله ومعجزة العلم والدراسة العميقة كما سمعتم أيضًا في كلمات الأستاذ حسين بإمكانها أن تحقق هذه المعجزة، وقد تأكدنا من وجود المهدي (عليه السلام) بواسطة أخبار متواترة تثبت ظهوره بعد ذلك. ولهذا، نحن نؤمن بذلك إيماننا بسائر العقائد، وهذا جزء ضروري من مذهب الإمامية الاثني عشرية الذي هو مذهبنا. هذا القسم الأول من الحديث.
القسم الثاني من الحديث: ما هي فائدة الإمام الغائب في أيام غيبته؟ وما هي فائدة ظهوره بعد ظهوره؟
أما فائدة ظهوره فقد ذكرناها خلال أبحاثنا عن فائدة وجود الأئمة، لأن الإمام سوف يظهر في وقت يكون الوعي بلغ القمة، والاستعداد بلغ الكمال، ولكن التجارب البشرية فشلت كلها واستعد البشر لقبول الرأي الصحيح السليم من دون ضغط ولا قوة، فحينئذ يأتي بالدين الصحيح ويطبق الدين الصحيح كما قام به سائر أئمتنا في وقتها بعض الشيء.
وأما الغياب والغيبة لا شك أن هناك فائدة فقهية، الإمام الغائب، هذه الفائدة الفقهية يذكرها فقهاؤنا في الأصول وفي الفقه حينما يبحثون عن الإجماع. من أدلة الفقه الإسلامي جميع المذاهب، الإجماع، يعني نحن حينما نريد أن نقول هذا حلال وهذا حرام، هذا مستحب وهذا واجب نريد دليلًا أليس كذلك؟ أدلتنا أربعة: القرآن والسنة والإجماع والعقل. هذه الأدلة قائمة ومعروفة بين الفقهاء، من هذه الأدلة، الإجماع. الإجماع... فقهاؤنا على ألوان وأقسام من المذاهب، منهم من يعتقد بالإجماع الدخولي يعني يقول اتفاق الأمة دليل على وجود حكم لأن اتفاق الأمة يكشف عن دخول الإمام صاحب الزمان داخل الفقهاء المتفقين على أمر. وقسم منهم يقول بالإجماع الكشفي، يقول اتفاق الأمة يكشف عن رضا الإمام. منهم يقول -بالإجماع اللطفي- يقول إجماع الأمة يدل على سكوت الإمام وهذا معناه رضا الإمام بالفقه الشايع، ولهذا حجة. مهما كان نحن لا نناقش في البحث الفقهي أو الأصولي لكن نحن نقول إن الإمام وجوده في غيبته ضمانة لعدم انحراف الأمة، لعدم نسخ شريعة جده، لعدم تغيير الحلال، لعدم تغيير الحرام، لبقاء الأحكام كما هي، وكفى بهذا فائدة.
هذا شيء ليس مني وإنما هو موجود بصورة مبهمة في الفقه وفي الأصول.
فإذًا، لا يمكن لفقهاء المسلمين أن يجتمعوا على أمرٍ ضلال بوجه من الوجوه، لماذا؟ لأن إما فيهم الإمام، أو يرضى عنهم الإمام، أو يسكت عليهم الإمام، حسب التعبيرات الثلاث: الإجماع الدخولي والكشفي واللطفي، وهذا معناه أن الإمام ضمانة لبقاء الأحكام الإسلامية وكفى بهذا أنه حلال محمد يبقى حلالًا إلى يوم القيامة وضمانة بقاء الحلية هو وجود الإمام؛ لا، لا يترك المجال للانحراف، وليس بقوة السيف أو بالدعوة. أبدًا، بل بإبداء الرأي، لأنه لو وُجد بين الفقهاء رأي واحد لا ينعقد الإجماع ولا يبقى الشيء الثابت من دون دليل.
فإذًا، هذه فائدة فقهية فائدة عظيمة وفائدة معناها صيانة الشريعة وبقاء الخط، وحسب الآية الكريمة الذي ابتكر الاستشهاد بها أخونا العظيم الأستاذ حسين حفظه الله: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ [الحجر، 9] حفظ الذكر بهذه القصة.
وأما الفائدة الاجتماعية، أنتم تعرفون أن الإنسان طاقاته كثيرة يصبر ويعمل ويشتغل ويسعى ويهتم إلى أن ييأس إذا يئس مات، الإنسان يشتغل بكل طاقته إلى أن يأتيه اليأس، فإذا يئس الإنسان مات، وانتهى، يترك واجبه، يترك رسالته، يترك جهاده ويقول ما الفائدة ما دام لا يوجد أمل، ما دام انقطع الأمل... انتهى خلِّنا نذوب مع الناس، خلِّنا نكون مع الآخرين، خلِّنا نمشي مع التيار، خلِّنا نترك الجهد وننتهي من هذه الصعوبات والمشاكل. وأنتم تعلمون أن المذهب الحق، أن الطريقة الصحيحة، مرت عليهما محن واضطهادات لا مثيل لها في التاريخ أبدًا، يمكن بعض كباركم يتذكر أيام الأتراك ولكن الذي ما شاهدناه وعرفناه من خلال التاريخ أكثر وأقسى بكثير، فالأمل بالنجاح وبالانتصار، كانا يحافظان على كيان الحق في هذه الأمة وهذا الأمل لا ينبثق ولا يتكرس إلا في الايمان بمجيء رجل على حد تعبير رسول الله: اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعدما ملئت ظلمًا وجورًا. فالإيمان بالإمام كان يبعث الأمل في نفوس المؤمنين ويمنعهم من الوصول إلى درجة اليأس الذي هو الانعدام والكفر، وهو الذوبان في البيئة والمحيط مهما كان، هذا بعض فوائد الغيبة.
وهناك واجب ووظيفة علينا من صميم آثار الغيبة وهو واجب الانتظار؛ يمكن تعرفون أنتم أيها الإخوان أن الواجب علينا في أيام الغيبة أن ننتظر، ولكن كثير من المفاهيم السامية تشوهت بكل أسف بين أيدينا، ولهذا التشويه أمثال ونظائر عديدة. التوكل تحول عندنا إلى التواكل، أليس كذك؟ التوكل ليس معناه أنه أترك الأمر على الآخرين، التوكل معناه أنه اشتغلْ واعزمْ واعقلْ وتوكل كما يقولون وهذا شيء معروف.
يعني أنت اشتغلْ ولا تتوانى ولا تتساهل ولا تقصر، ولكن اتكلْ على الله وتوكل على الله: ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله﴾ [آل عمران، 159]. نفس الشيء الدعاء، الدعاء هذا المفهوم العظيم الإسلامي، هذا الأمر الجليل، هذه البقية من اللون والنور في قلوب الناس، هذا الدعاء تحول عندنا أيضًا إلى اتكالية على الله وترك العمل. قصة تلك العجوز التي كانت جالسة عند جملها، والجمل يموت وهي تبكي وتدعو وتتضرع إلى الله تطلب الشفاء، معروفة قصتها أن أحد الكبار أو أحد الأئمة رآها وهي تبكي وتتوسل إلى الله لأن يشفي الله سبحانه وتعالى جملها قال لها الكبير أنه: لو ضممتِ إلى الدعاء شيئًا من القطران، ضعي القطران ثم ادعي الله سبحانه وتعالى.
الدعاء ليس معناه أنه أنت لا تروح عند الطبيب، ولا تستعمل الدواء، ولا تعمل، ولا تترك الأشياء المضرة، ولا تتقي، ولا تحتمي... هذا ليس معناه الدعاء هذا معناه أن الدعاء خُلِق لنسف الكون إذا كان فقط بهذا المعنى، يعني تغيير كل عوامل الطبيعة. معروف عن أحد أرحامنا من أصفهان (رحمة الله عليه) رجل طيب مؤمن وصالح كان، وكانت ساعته خربانة راح إلى حرم الإمام الحسين (سلام الله عليه) ووضع الساعة بالقفص، قالوا له لماذا تضع الساعة بالقفص؟ قال: حتى الحسين يصلح لي ساعتي. يا أخي ضع ساعتك عند الساعاتي... ليست هذه شغلة الحسين. تحول مفهوم الدعاء عندنا وهذا هو المفهوم. هذا ضلال، يعني تشويه. فإذًا، ما أكثر المسائل المشوهة التي لها حقيقة ولكن أصبحت مشوهة بين أيدينا.
من جملة المسائل المشوهة عند بعضنا مسألة الانتظار. يفكرون أن الانتظار عند الشيعة معناه أنه نحن لا نشتغل وأمام كل مصيبة نقول: يا صاحب الزمان تعال وأصلح. أمام كل مشكلة، كل محنة... ننام ونتخلى عن واجباتنا ونقول إن شاء الله صاحب الزمان يأتي ويطهر الأرض منهم. لا، هذا ليس معنى الانتظار، هذا معناه مطابقة اليهود أصحاب موسى الذين قالوا: ﴿اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون﴾ [المائدة، 24] لا، هذا ليس معناه.
معنى الانتظار معنى التهيؤ، معنى الانتظار معنى الحيوية الدائمة والحركة المطلقة والاستعداد الكامل. اليوم إذا عدو من الأعداء هجم علينا ونحن كنا في بيوتنا نائمين غافلين، نحن كنا ملتهين بأمورنا، لا يقال نحن كنا بانتظار العدو، متى يقول العرب نحن كنا في انتظار العدو؟ حينما جندنا أنفسنا، حينما هيأنا أمرنا، حينما تهيأنا لمقابلة العدو حينئذٍ يقال أنا كنت في الانتظار.
الانتظار لظهور الإمام مع الهدف الذي نحن نؤمن به بأن الإمام سوف يظهر ويتحدى العالم ويسود العالم بقوته العدل، بعدما ملئت ظلمًا وجورًا، هذا الهدف العظيم الملقى على عاتق الإمام ونحن نعتقد أننا من أنصاره يستدعي أيها الإخوان، يستدعي هذا الهدف والايمان الانتظار العظيم، والاستعداد العظيم، والتهيؤ العظيم لذلك اليوم. أما كل واحد منا ملتهٍ بنفسه، ملتهٍ بإخوانه، يختلف هو والآخرين يلتهي بأعماله الداخلية يلتهي بحياته الخاصة؛ كسل، انحراف، توانٍ، تخلٍّ عن المسؤوليات هذا ليس معناه انتظار، هذا معناه موت.
فالانتظار هو التهيؤ، بلغة عصرنا إذا نريد أن نقول الانتظار يعني الحياة الجندية، التجنيد، الحياة العسكرية، إذا نحن ما عشنا الحياة العسكرية، الحياة الصلبة، الحياة الخشنة، الحياة المهيأة، فنحن لسنا من أنصار الإمام ولا من أنصار أهدافه؛ متخاذلين مستسلمين للعدو، مستسلمين لكل عدو مهما كان حقيرًا أو صغيرًا. فالانتظار يعني أن نستعد، يعني أن نتجند. كيف يمكن أن ندعي أننا بانتظار الإمام، أو نحن مهيئون للقاء ونعيش هذه الحياة المخزية المتردية المنحرفة؟ كيف يمكن أن ندعي أننا بالانتظار أو نحن مجندون، وكثير من شبابنا أو من كبارنا أو من بناتنا يعيشون حياة الميوعة وحياة الترف وحياة اللهو والفساد؟ يا أخي لا يمكن.
اليوم أنت تفتح على بلدك لبنان أو البلاد العربية أو جميع البلاد الذين يحبون العز، ولا يستسلمون للذل والاستكانة، كيف يمكن أن يستعدوا للقاء وللمعركة ولكن يفتحون على بلادهم أبواب العدو، الخطر من كل جانب.
فلنتصور... المجلات حينما تنشر الصور العارية، عارية عارية جدًا... أخيرًا وصلوا من الوقاحة بوضع صورة امرأة عارية، يعني سابقًا كانوا يشتغلون بالتجارة: يفتحون بيتًا، يضعون فيه كم فاحشة، اليوم يتاجرون بأجساد النساء بالمجلات. نفس الشيء يعني لا شرف على هذا... الشيء واحد. المتاجرة بجسد المرأة سواء كان لفتح دار البغاء أو بنشر هذه المجلات التي نراها... يعني هؤلاء دعاة البغاء، تجار الرقيق الأبيض شيء واحد، لا شرف لهم على تجار البغاء أبدًا، مثل بعض.
المجلة تنشر هذه الصور وتثير وتنشر الأخبار المفسدة والقضايا المثيرة. الأفلام تثير، المسارح تثير، البيوت الليلية تثير وتحرك، ثم التلفزيون ينقل هذه المخازي والدعارة من داخل الكاباريهات إلى بيوتنا، وبعد ذلك الموضة قائمة على أساس الإثارة أليس كذلك يا إخوان؟ أنا لا أتهجم، مبدأ الموضة في حياة نسائنا أليست الإثارة في القرن الحديث؟ ألا يختارون الموضة الأكثر إثارة؟ ما معناه، حتى يحركوا ويثيروا وماذا يثيرون؟ المطلوب أن هذه الخطوط، هذه الجوانب، هذه العوامل ماذا تعمل مع شبابنا؟ والعملية لو اقتصرت على كتلة منحرفة غنية فاسدة لكنا نقول الحمد لله نخلص منهم، تتوسع يا أخي تأتي لبيتي وبيتك. تلتهم شباننا، عمالنا، كسبتنا، تجارنا، شبابنا، طلابنا. الآن تصور الحفلات الجامعية، الجامعة! جامعة... لغة مقدسة، الحفلات الجامعية... أنا أقرأ في الجرائد أنها لا تختلف عن الحفلات الموجودة في الكازينو، الرقص والملابس القصيرة والملابس الخليعة كل شيء موجود علمًا أنها حفلات جامعة، أي جامعة هذه؟
فإذًا، الفساد يتعمم، لماذا يتعمم؟ لأن وسائل الإعلام تشجع هذا الفساد. الشاب الذي يصرف طاقاته المباشرة وغير المباشرة في سبيل إرضاء هذه الشهوات التي تضطرم مع الأسف، يعني مسألة الرغبة إلى الجنس أو حب الجمال تجاوزت قضية الحاجة النفسية، يحركونها دائمًا..