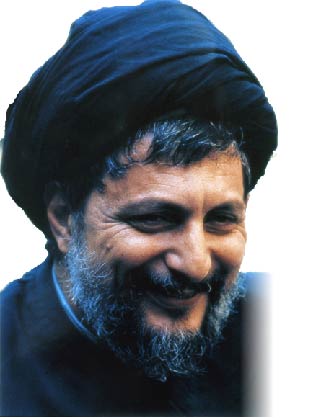الملتقى السابع للتعرف على الفكر الإسلامي- تيزي- اوزو (الجزائر) 10-22 تموز (يوليو) 1973
بسم الله الرحمن الرحيم
1- في حدود معلوماتنا المتواضعة وبعد الدراسات المضنية وجدنا: أن واقع التشريع في العالم الإسلامي في هذا الوقت بعيد كل البعد عن روح الشريعة الإسلامية في الأساس وفي المصادر وفي المبادىء العامة وحتى في كثير من التفاصيل.
وإذا كان بينهما من لقاء فهو محصور في بعض الفروع وفي كثير من المظاهر، وهذا التشابه قائم بنفس المقدار أو أكثر بين تشريعاتنا وبين مختلف التشريعات المدنية المعاصرة والسالفة.
ومن المحزن أن نعترف بهذا الواقع ونحن نتذكر الآيات القرآنية الكريمة في سورة الحجر: ﴿لا تمُدَّنَّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجًا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين * وقل إنّي أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المقتسمين * الذين جعلوا القرآن عضين * فوربِّك لنسألنّهم أجمعين * عما كانوا يعملون * فاصدع بما تُؤمر وأعرضْ عن المشركين * إنّا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون﴾ [الحجر، 88-96].
إن بعض الإنتباه إلى هذه الآيات مع ترتيبها ثم وقفة تأمل أمام الكلمات: ﴿تمُدَّنَّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجًا﴾ و﴿الذين جعلوا القرآن عضين﴾ و ﴿وأعرض عن المشركين﴾ والوعد بكفاية ﴿المستهزئين* الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر﴾... إن الدقة في هذه الأمور توضح المفهوم القرآني عن الشرك (في مصطلح الأحاديث الشرك الخفي) وإن التوحيد الكامل هو في التسليم لجميع ما أمر به، وإن تجزئة القرآن نوع من الشرك، وجعل مع الله إلهًا آخر هو المطاع في بعض المواقف وإن المظاهر التي يعيشها الآخرون الذين لا يؤمنون بالله أو بعبارة أخرى النجاح الظاهري الذي يكتسبه الملتزمون بقوانين غير القوانين الإلهية، إن هذه المظاهر رغم إغرائها لا يمكن أن تشكل طموح الرسول (ص)، والمؤمنين الذين يلتزمون بأحكام الله جميعًا رغم اتهامهم بالرجعية وغيرها، ورغم تعرضهم للإستهزاء.
والحقيقة أن المفهوم القرآني للشرك أو للكفر بالله لا ينحصر في العبادة لغير الله، وإلا فما معنى الآية المباركة: ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم﴾ [الجاثية،23] هل هناك من يصلي ويسجد لهواه؟ بل الإله في المصطلح القرآني هو قدس أقداس الإنسان الذي يدفعه في حركاته ونشاطه بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو الذي يجعل الإنسان من نفسه، وفكره وعواطفه وحركاته، وسيلة لكسب رضاه، لتلبية رغباته.
وهذا المعنى هو المعنى الذي يقرب بل يوحد بين معنى التوحيد ومعنى السلام إذ الإسلام هو التسليم الكامل عقلًا وقلبًا وجسمًا لله، فالتسليم في مقام العمل أي إسلام الجوارح هو جزء من مفهوم التوحيد.
والآيات القادمة تلقي أضواءً على هذا المفهوم العميق فلنتلها بتأمل:
﴿إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا * أولئك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا﴾ [النساء، 150 – 151].
فلنكرر: ﴿ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا﴾ ألا يعني الكفر ببعض الأحكام، عدم إعتراف بصلاحيتها والاقتباس من المصادر الأخرى؟
ثم نتلو أيضًا: ﴿ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله﴾ هؤلاء هم عينًا ﴿الذين يكفرون بالله ورسله﴾ فالإيمان بالله بالعقل وبالقلب "أي العقيدة والأخلاق" دون الإيمان بالجسد أي الإلتزام بالأحكام "كفر بالرسل وفي مقياس القرآن كفر بالله والرسل".
وهنا يظهر بوضوح ما سنقرأه في سورة المائدة وفي الآيات 44 – 50 حيث أن الحكم بغير ما نزّل الله حول القيود والقصاص يعتبر في منطق القرآن ظلمًا وكفرًا وفسقًا وكذلك اتباع أهواء الآخرين وعدم الخضوع لأحكام الله في الإنجيل وفي القرآن مرفوض وفسق.
الآيات: ﴿إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استُحفِظُوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشونِ ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون * وكتبنا عليهم فيها أن النفسَ بالنفسِ والعينَ بالعينِ والأنفَ بالأنفِ والأذنَ بالأذنِ والسنَّ بالسنِّ والجروحَ قصاصٌ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون * وقفّينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدِّقًا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقًا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين * وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون * وأنزلنا إليك الكتاب بالحقِّ مصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون * وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإنَّ كثيرًا من الناس لفاسقون * أفحكمَ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون﴾ [المائدة، 44 ـ 50].
ومجمل القول إن الأحكام في الشريعة الإسلامية مثل جميع الشرائع السماوية جزء لا يتجزأ من الوحدة المتكاملة التي نسميها "بالإسلام". والإسلام رغم تقسيم تعاليمه في الدراسات والكتب إلى الثقافة والعقيدة والفقه والأخلاق، رغم ذلك، وحدة متماسكة مترابطة الحقول متفاعلة الأجزاء، فالثقافة أو ما نسميه الرؤية الإسلامية للوجود قاعدة لعقيدته وكلتاهما أساس للشريعة في فقهها وأخلاقها. ومن جانب آخر فالشريعة تصون العقيدة وتوضح الرؤية وكل قسم من الشريعة ذو تأثير عميق على القسم الآخر.
وإليكم بعض الصور لهذا الترابط :
القرآن الكريم يعطي مفهومًا عن الله هو أوسع وأشمل من كافة المفاهيم التي قُدِّمَت من قبل الأديان السابقة "ملك الملوك"، "الأب" ومن قبل المفكرين والفلاسفة "واجب الوجود"، "الوجود المطلق".
هذا المفهوم الذي له الأسماء الحسنى وهو منتهى كل كمال والأول والآخر والظاهر والباطن: ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ [الزمر، 67] وهو أقرب من حبل الوريد و﴿يحول بين المرء وقلبه﴾ [الأنفال، 24] وغير ذلك، هذا الذي نعده ركن الثقافة الإسلامية أساس العقيدة على المسلم أن يدرك هذا ويؤمن به عن دليل ويعيشه بكل وجوده ولا يقبل الإسلام بغير هذا أبدًا ولا يعد الذي فكر وآمن بغيره مسلمًا وهكذا يقدم الإسلام مفاهيم عن الكون والحياة والموت والإنسان والمجتمع وغيره، وهذه المفاهيم أسس التفكير والإيمان والعمل في الشريعة الإسلامية.
والإيمان بالله الواحد الأحد الذي ﴿لم يلد ولم يولد﴾ [الإخلاص، 3] بدوره ينعكس على موقف المسلم من أخيه المسلم ومن الإنسان كل إنسان ومن مجتمعه.
والعبادات بما لها من شروط وفي مقدمتها الإخلاص لله في النية نتيجة طبيعية لهذا الإيمان، وفي نفس الوقت تصون الإيمان وتنميه في النفس وتقلص النزعات الدافعة للتحرك في نفس الإنسان المسلم.
وتأثر الأخلاق الإسلامية بهذا وذاك ظاهر، حيث أن الكبر مرفوض والثقة بالله، لا بالنفس، والتواضع وحسن الظن والتسامح والطموح الكبير والأمل الدائم والكرم والشجاعة، هذه الأوصاف تُستقى من الإيمان الإسلامي ومن الرؤية الإسلامية ومن العبادات والأعمال المرغوبة في الفقه الإسلامي وهي بدورها تؤثر فيها.
إن الصورة الحقيقية للإسلام هي في كونها لوحة مترابطة الأجزاء لكل حكم مكانه ولكل تعليم أثره البالغ. وتجزئة هذه الصورة للدراسة لا يمكن أن تفصل بين حقولها ولا تمكن المسلم من الاحتفاظ الكامل ببعض مع ترك البعض الآخر.
2- التفاوت في الأساس: يصرح القرآن الكريم في أول سورة البقرة أن الأساس الأول للتقوى هو الإيمان بالغيب ويأتي من بعده متسلسلًا إقامة الصلاة والإنفاق مما رزق الله وهذا التسلسل يتضح في مختلف التعاليم الإسلامية ويؤكد أن الحكم الإسلامي ينطلق من أساس الإيمان بالغيب.
والحقيقة أن الفارق المميز بين الحكم الديني وبين الحكم الوضعي هو الإيمان بالغيب بل هذا هو الفرق بين التعاليم الدينية وبين العلوم المختلفة وبينها وبين آراء الفلاسفة وبينها وبين مكارم الأخلاق وغيره.
والغيبية في أساس الحكم الديني هي سبب القداسة والخلود والإطلاق. والحاجة الملحة في نفس الإنسان إلى الغيب وإلى الاطمئنان والإستقرار في كافة شؤونه الحياتية، تُلبى بواسطة هذه الصفة.
إن هذه الحاجة تنبع من الإحساس الطبيعي بضرورة المعايشة مع المطلق وإلا فهو يعيش مضطربًا في ذاته مترددًا في سلوكه ضعيفًا في عزماته ومواقفه.
أما العلوم والفلسفة والتكنولوجيا والقوانين الوضعية وكل ما هو من صنع الإنسان فهو متزلزل، حيث إنه متكامل ومتغير لذلك فهو لا يغني الإنسان عن شعوره بالحاجة إلى المطلق، يحس بصحبته الدائمة في ساعات الحرج وعند انهيار الأسباب والتردد في بداية السلوك.
ويشير القرآن الكريم إلى هذه الزاوية من حاجات الإنسان بقوله: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ [الرعد، 28].
ومن المؤكد أن هذا الإحساس بالمعايشة لا بد من التكريس عند ممارسة الحياة العادية والعبادات في الإسلام بتوقيفها وعدم تقبلها للتطوير أثر حتمي لخلق هذه المعايشة، وهي بدورها تصونها وتنميها بل الثابت في جميع الأحكام الشرعية حتى المعاملات والأعمال العادية إمكان إقترانها بقصد القربة. بل الأفضل من ذلك كما ورد في وصايا الرسول (ص) وهذا بدوره يؤكد حتمية إستناد الأحكام إلى الغيب حيث أن لا قربة دون الغيب، ومن جهة أخرى فإنها تتفاعل مع المعايشة المطلوبة حتى لو كان ذلك ضمن إطار عام فيكون الإنسان عند اتخاذ مواقف يحس بأنه ينفذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة فعل إيمانه بالله وتسليمه لأمره ونهيه.
إن الغيبية وما وراءها من صفات لا تتنافى على صعيد التطبيق مع التطوير والاهتمام الكامل بالضرورات الاجتماعية المتغيرة وبكلمة فإن سماوية الحكم لا تتناقض مع أرضية التطبيق عند حاجة الإنسان له.
وهنا يتضح مفهوم الإجتهاد في الشريعة والفرق بينه وبين التشريع المتعارف في المؤسسات المخصصة للتشريع.
إن الإجتهاد هو في المصطلح استفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي من مصادره. وهذا يعني أن المجتهد يبذل قصارى جهده في المصادر والنصوص لكي يكشف الحكم للواقعة التي يحتاج إلى معرفة حكمها فهو يضم إلى الحكم الديني فهمه واستنباطه النابع من خبرته وممارسته ومَلَكَته النفسية به، يدخل كل هذا في استنباط المجتهد.
إن الإجتهاد تحرك وتطور ونظرة إلى الأرض ضمن الإطار الغيبي المطلق السماوي للحكم، فالإطلاق والغيبية لا يفقدان الحكم تطوره وانطباقه على حاجات الإنسان كما أن التطور والاهتمام بالحاجات لا يفقدان الحكم قدسيته وغيبيته.
أما التشريع فهو دراسة الموضوع وأبعاده والظروف المحيطة به ووضع حكم له مستند إلى مصلحة عامة أو خاصة.
والتشريع على هذا يضم جزءًا من فهم المشرِّع إلى المصالح المتوافرة في الموضوع وهو أي التشريع نظرة إلى الأرض بينما الإجتهاد إنتباه إلى السماء ويشتركان في انضمام جزء من ذات المجتهد والمشرِّع ومن فهمه واستنباطه.
3- التطور في الشريعة: وقد وضع الإسلام ضمن شريعته مبادىء تمكن الإنسان من تطوير الحكم الشرعي حسب مقتضيات الزمان والمكان وغيرهما دون أن يفتقد الحكم قداسته وغيبيته.
وبذور التطور هذه على أنواع:
النوع الأول: موضوعات الأحكام وأجزائها وشروطها التي تقبل التطوير في مدلولاتها عند مختلف الظروف والأحوال ذلك مثل موضوع حكم تعدد الزوجات في القرآن الكريم: ﴿وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى﴾ [النساء، 3] وهذا الشرط قابل للتعميم في الحالات الاجتماعية المتنوعة كظروف ما بعد الحرب وفي بعض المجتمعات الخاصة والمفهوم من الآية أن هذا الحكم ليس حكمًا مطلقًا في جميع الحالات.
وإذا فسرنا الآية الكريمة بأنها في صدد بيان حل لمشكلة الخوف من عدم القسط في شؤون الأيتام وليست في مقام تقييد الحكم إلا لمنع الزيادة عن أربع، إذا فهمنا الآية بهذا المعنى نقول: أن القرآن لم يذكر إذًا أي نص يبيح التعدد المطلق والسيرة المطهرة وسلوك الأصحاب والأئمة سيرة عملية لا إطلاق لها مثل الأدلة اللبية في مصطلح الأصوليين، يمكن اختصاصها بأسباب خاصة وبشروط معينة:
ومثل شرط العدالة في العشرة فهي تختلف باختلاف حقوق المرأة التي تحدد إمكانية قيام الزوج بمسؤولياته أمام أكثر من زوجة.
نقول هذا حتى ولو كانت الروايات فسرت العدل في العشرة فإن شأن المرأة في الطعام والكساء والسكن يختلف أيضًا ويتطور.
ومثل موضوع الفقر في الزكاة حيث إنه يتطور حسب الحاجات المتزايدة ومتوسط الدخل الفردي. فكلما تحسنت أوضاع المعيشة وارتفع المستوى المتوسط توسع مفهوم الفقر وهذا يعني أن الزكاة تدارك مستمر لنقص الأوضاع المعيشية لدى الفقراء وتقريب دائم لمستوى دخل الطبقات المختلفة.
ومثل موضوع الرشد في آية البلوغ والذي يجعل عمر البلوغ المدني يختلف عن السن الذي يبلغ الشاب درجة المسؤولية الجزائية.
إن الآية الكريمة تقول: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء، 6] واستئناس الرشد بعد البلوغ الجزائي ضروري للتأكد من وصول الشاب درجة البلوغ المدني وهنا يدخل تقدير الحاكم المسلم عندما يريد وضع القانون لتحديد سن المسؤولية المدنية وبالتالي يدخل إمكان التطوير.
والأمثلة على هذا كثيرة جدًا اكتفينا بالقليل منها، وأبرزها مبدأ تطبيق الزكاة فبإمكاننا اليوم أن نرفع مستوى حياة الفقراء بواسطة تأمين العلاج والعلم والضمان الاجتماعي لهم وهذا أقرب للكرامة وأدق في هذا العصر.
النوع الثاني: مبادىء موضوعة لأجل التطوير بالذات مثل قاعدة "المؤمنون عند شروطهم" وقانون ﴿أوفوا بالعقود﴾ [المائدة، 1] وغيرهما ومن خلال هذه القواعد يمكن تطوير صور الزواج وشروط الطلاق وإدخال تعديلات واسعة في قانون الأحوال الشخصية.
فالزواج بالصورة العادية هي الصورة المتناسبة مع بعض العصور إقترح الإسلام له صورة أصلية هي المتعارفة لدى المسلمين ويمكن وضع صور جديدة للزواج من خلال وضع شروط ضمن العقد تحدد استرسال الرجل في الطلاق وعند الامتناع عن الطلاق وتحدد أيضًا المكان والمال المكتسب خلال العمل والأموال الموجودة في البيت ويمكن وضع شروط يستصعب على الزواج معها من تحديد الزوج كما يمكن تحديد وضع الأولاد عند الطلاق.
إن هذه الشروط يمكن أن توضع ضمن استمارات تعرض على الزوجين حال الزواج لأجل التمسك بها أو التخلي عنها. فإذا ذكر في عداد الشروط أن الزوج إذا أراد أن يطلق دون مبرر صحيح فعليه أن ينفق على المطلقة ما دامت غير متزوجة أو عليه أن يدفع مبلغًا كبيرًا. إن هذا الشرط من طبعه تحويل كل طلاق إلى المحكمة لمعرفة الموضوع ووجود المبرر الصحيح، ثم إنه يحول دون استرسال الزوج في الطلاق، ومن جهة ثانية إذا وضعنا ضمن العقد وكالة الحكمين أو المحكمة عن الزوج في الطلاق في حالات معينة فإن تعنت الزوج في امتناعه عن الطلاق يخف بل يتعالج نهائيًا.
النوع الثالـث: مراعاة العناوين الثانوية فإنها من أهم شؤون الاكتشاف وتطوير الأحكام الشرعية، فالتأميم مثلًا لا يمكن قبوله كمبدأ في الشريعة الإسلامية حيث إنه يقوم على أساس عدم الاعتراف بالملكية الشخصية ولكن الشريعة عندما تلاحظ أن مصالح الأمة تعرضت للخطر مثلًا تقف لحظة واحدة لحفظ مصالح الفرد فتحكم عندئذٍ بالتأميم أو حتى المصادرة، وهنا ينفتح باب واسع آخر لأجل تلبية الحالات الحادة والمستعجلة وغيرها ضمن الإطار الشرعي المتحفظ.
إن هذه التطورات ضمن الإطار العام للحكم الديني تمكن المسلم من معايشة التطورات الحديثة ومعالجة الحاجات والمشكلات الاجتماعية المتزايدة دون أن يشعر بأنه ينفذ حكمًا غير حكم الله ومع احتفاظ الحكم بقداسته الكاملة.
وهنا يتضح الفرق في الأساس بين الحكم الشرعي وبين الحكم الوضعي وما عليه عالمنا الإسلامي اليوم، حيث إن الأحكام والتشريعات فقدت قداستها لأنها لم تستند إلى أساس غيبي.
4- الفرق في المصادر: إن مصادر الأحكام الإسلامية تختلف كليًا عن المصادر المعتمدة لتشريع القوانين في العالم الإسلامي في هذا الوقت رغم ما يوجد في كافة الدساتير والقوانين الأساسية، إن دين الدولة الإسلام، وإن الإسلام مصدر رئيسي من مصادر التشريع. إن هذا كله لا يغير حقيقة الأمر.
فالحكم الإسلامي يبحث عنه وعن تفاصيله في القرآن والسنة المطهرة ثم في إجماع الأمة وهذه المصادر لا تُراجع من قبل الباحثين عن وضع القوانين بل البحث يتجه في المبادىء الدولية الحقوقية وفي تجارب الأمم الأخرى وفي الدستور وفي بلاغات الثورة وتضع المجالس التشريعية تفاصيلها. ثم تصدر مراسيم لأجل تنفيذها ولا يصلح أي قانون للتنفيذ ما لم يصدر المرسوم بشأنه ومع رعاية شروط معينة.
والمصادر تقتبس على ضوء المصالح والحاجات من الأحكام الإسلامية كما تقتبس من سواها. يقال أن "نابليون" في رحلته إلى مصر حمل معه الفقه الإسلامي في القضايا المدنية واعتمد عليها في قوانينه الشهيرة. إن هذا الاقتباس لم يجعل القوانين النابوليونية أحكامًا شرعية.
إن الفقيه المعاصر عليه أن يرجع إلى المصادر القانونية المعاصرة أيضًا لكي يصدر الفتوى ولكن الرجوع هذا محاولات لاكتشاف الموضوع وإدراك أبعاده على العكس من الحكم الوضعي.
وهناك فرق آخر في هذا المجال وهو أن اختيار الحكم الشرعي من مصادره إلزامي على العكس من اقتباس الحكم الوضعي الذي يجعل القانون المقتبس بإرادة السلطات المشرعة دون إلزامها على إصداره.
يبقى المصدر الأخير من مصادر الشريعة الذي هو مصدر القوانين الوضعية في نفس الوقت وهو العقل ولكن العقل في الشريعة أساس العقيدة والمسائل العقائدية في الغالب، ثم إنه يعتمد لاكتشاف الحكم الالهي إستنادًا إلى مبدأ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أما الأحكام الوضعية فمن أوسع مصادرها حكم العقل وآراء العقلاء على أنها تلبية لحاجات الإنسان وبالتالي فهي أحكام موضوعة من قبل الإنسان.
5- المبادىء العامة: عند مقارنة التشريعات المعاصرة مع روح الشريعة نجد فارقًا في المبادىء العامة أيضًا رغم أن هذا الفارق هو نتيجة طبيعية للتفاوت في الأساس.
أ. فالفقه الإسلامي يعتمد في عباداته ومعاملاته على النية إلى حد كبير اعتمادًا مطلقًا بينما التشريعات الحديثة تقلص من دور النية بشكل ملموس. والنية في الإسلام هدف وروح للعمل والنتيجة الباقية منه يحاسب الإنسان بحسابها ولا يُقبل أي عمل من دونها ولها في المعاملات من عقود وإيقاعات دورها الأساسي نكتفي بتذكير المستمعين إلى الفرق بين الاضطرار والإكراه وصحة العقد مع الأول دون الثاني نكتفي بهذا اختصارًا ثم نعيد إلى أفكارنا اهتمامات الإسلام بالمسائل النفسية والدوافع ومسائل الأخلاق.
ب. تضع الشريعة الإسلامية حدودًا لمفهوم الملكية وتلغي الملكية عن بعض الأشياء والمالية عن بعض الأشياء وعلى هذا الأساس تتأثر المعاملات تأثرًا بالغًا في هذا المجال.
فالخمر وآلات اللهو وما لا يستعمل إلا في المعاصي ولا يتمتع به في الحلال لا تعد في الإسلام مالًا فلا يجوز بيعها وشراؤها واستئجارها. كما وأن الملكية تحتاج إلى سبب ثابت فلا يكفي التسجيل للأرض في تملكها بل الحيازة أيضًا لا تملك. إنما الإحياء سبب لملكية الأرض ثم المبادلة والميراث.
ج. والإنسان في المعاملات يقوم بدور كبير وفي التشريعات الحديثة تقوم المؤسسة مقام الإنسان تدريجيًا. أما الإسلام فعلى الرغم من إقراره بل اكتشافه لأول مرة الشخص المعنوي فإنه يعلق على الشخص الحقيقي في المعاملات والإيقاعات والشهادة والقضاء أهمية كبرى تجعل منه الركن الأساسي.
د. والعمل الذي هو أساس لبناء العلاقات الاجتماعية مفهومه لدى الشرع غير مفهومه في القوانين الوضعية وهذا التفاوت في المفهوم يدخل فرقًا أساسيًا في القوانين والأنظمة.
إن العمل في المفهوم الديني رسالة ووظيفة، لذلك فهو حي مطلق يربط أعضاء المجتمع بعضها ببعض ويربط الأجيال المتلاحقة ربطًا عضويًا.
إن العمل ليس بضاعة تُباع وتُشترى كالأمتعة والأشياء الخارجية بل هو واجب. يقدم المجتمع الإسلامي لعامله الواجب لحفظه وحفظ عائلته وشؤونه حسب ظروف المجتمع والمرحلة الاقتصادية التي يمر فيها وهذا البحث من كنوز الفكر الإسلامي وهو مفتاح توزيع الثروة العادلة في نظام الإسلام الاقتصادي توزيعًا عادلًا موجهًا مطورًا يشد الأفراد والأجيال في رباط مقدس.
والعمل في مفهومه القانوني كمية من الطاقة المجسدة تُقدم مقابل أجر معين والتقابل يقتضي المساواة في القدرة والجودة أو الرداءة. والعمل في هذا المفهوم بضاعة بحتة تبحث الأنظمة الشيوعية والرأسمالية عن تقييمها ووضعوا على نتائج التقييم جميع قوانينهم الاقتصادية وغيرها.
ه. والكمال في المفهوم الديني كمية مقترنة مع الحق وليس المهم أن نكتسب القدر الأكثر من المكاسب بل المهم عدم مفارقة الحق، مع العلم أن المبدأ في المفهوم القانوني الوضعي هو تأمين الوصول إلى الدرجة الأعلى من المطالب حتى على حساب الآخرين. وما نسميه اليوم بالتربية في الإنسان والتنمية في الأشياء هو ما عبرنا عنه بالكمال في المصطلح الديني والواجب على المسلم من المهد إلى اللحد.
وهذا مصدر الطغيان والظلم والثروات والصراع الاجتماعي المرير والقانون الوضعي المنبثق من الواقع البشري يكرس هذا.
أما الدين فساحة كمال الإنسان فيه فسيحة لا يصطدم تحقيق طموح الفرد مهما بَعُد بطموح الآخرين ولا لمصالح الجماعة بمصالح جماعات أخرى فرضى الله لا حد له ولا يشغله شأن عن شأن.
و. والربا فرع من هذا المبدأ، ناهيك عن تحكم قانون العرض والطلب بصورة مطلقة في التشريعات القانونية. حتى في الأنظمة الشيوعية ولكنه يتحول إلى ميادين أوسع.
ز. وهناك مبدأ الجزاف واعتماد الحظ وجهالة العوضين أو الغُرر فهو بفروعه مرفوض في المعاملات الإسلامية دون التشريعات القانونية التي تكرس في العالم الإسلامي أنواعًا كثيرة من هذه المعاملات كما نجد أنواعًا من اليانصيب، هذه المقامرة التي تسلب الإنسان المسلم جميع أنواع العطاء حتى في الصدقات الصغيرة فتحولها إلى تجارة.
أما التفاصيل في الفروع فوجود أحكام وقوانين غير متوافقة مع الشريعة بل متناقضة معها أكثر من أن تحصى وهذا أثر طبيعي للفرق في الأساس والمصادر والمبادىء العامة.
6- الربا: هنا أحب أن أقف أمام مثال واضح يلقي الأضواء الكاشفة على الواقع الإسلامي وهو مثل الربا.
إن أكثر الدول الإسلامية بعدما وجدت الحاجة الملحة إلى القرض لأجل الإنماء وبعدما وجدت أن حرمان صاحب المال من الربح غير ممكن أقرت الربا بصورة صريحة أو في إطار من إستحياء. فمن محاولة لإصدار فتاوى بالسماح للربا في الإنتاج لا في الإستهلاك إلى حلية الربا مع فائدة قليلة أو إبراز معاملات ربوية في صورة غير صريحة مثل أوراق الاستثمار في بعض الدول الإسلامية.
هذه المساعي تكشف بوضوح سير القوانين في العالم الإسلامي مع العلم أن المحاولة لاكتشاف بديل عن الربا كالمضاربة من المصادر الإسلامية لم تجرِ والدراسات التي وضعت لها أو اقتراح بنك لا ربوي ما جُرِّبَتْ من قبل المعنيين في العالم الإسلامي أبدًا رغم الأموال الطائلة التي تصرف في مختلف الشؤون الدينية وفي مجالات الدعوة والثقافة وغيرها.
7- التشريع المعاصر: وفي نهاية المطاف لا بد من طرح السؤال المطلوب طرحه في هذه الدراسة وهو أننا رغم الواقع ورغم الظروف المحلية والعالمية المعاشة كيف يمكننا أن نختصر الطريق ونقرب البعيد ونسلك خطًا يوصل التشريع المعاصر في يوم ما إلى روح الشريعة الإسلامية؟
وفي الجواب، علينا أن نعترف بصعوبة المسلك وضرورة توفير النية الحازمة ومن ثم يصار إلى تكليف هيئة من علماء الدين تضع الهيكل التشريعي العام ثم تلتقي مع الخبراء في القانون ومع المعنيين بالشؤون العامة لكي تبحث معهم ويدرسون جميعًا تطبيق المبادىء العامة ووضع التفاصيل على ضوء الواقع والظروف المحيطة به واستنباط الأحكام الأولية للأمور وإصدار الأحكام المرحلية لدى الحاجة.
وإن هناك أمورًا لا يمكن قبولها من الناحية الشرعية ولكن يمكن تبني الشريعة لها على ضوء الظروف الحرجة للأمة ومن أوضح الأمثلة على ذلك مبدأ التأميم ثم السعي إلى تطبيق هذه النتائج في إطارات محدودة لاكتشاف النواقص واختيار الأفكار على الأرض في هذا القرن ومراقبة هذه التجارب ومن ثم تحويلها إلى قوانين وتقديمها للمجتمعات الإسلامية مع الاحتفاظ بالأساس وبالمصادر والمبادىء دون التفريط بأحدها مهما صغر في تقييم الناس له.
وبعد، فإن الطريق رغم وعورتها سالكة، والمشكلة رغم صعوبتها لا تستعصي على الحل.
﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين﴾ [العنكبوت، 69].
* ردود الإمام الصدر على التعقيبات
بسم الله الرحمن الرحيم
1- في حدود معلوماتنا المتواضعة وبعد الدراسات المضنية وجدنا: أن واقع التشريع في العالم الإسلامي في هذا الوقت بعيد كل البعد عن روح الشريعة الإسلامية في الأساس وفي المصادر وفي المبادىء العامة وحتى في كثير من التفاصيل.
وإذا كان بينهما من لقاء فهو محصور في بعض الفروع وفي كثير من المظاهر، وهذا التشابه قائم بنفس المقدار أو أكثر بين تشريعاتنا وبين مختلف التشريعات المدنية المعاصرة والسالفة.
ومن المحزن أن نعترف بهذا الواقع ونحن نتذكر الآيات القرآنية الكريمة في سورة الحجر: ﴿لا تمُدَّنَّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجًا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين * وقل إنّي أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المقتسمين * الذين جعلوا القرآن عضين * فوربِّك لنسألنّهم أجمعين * عما كانوا يعملون * فاصدع بما تُؤمر وأعرضْ عن المشركين * إنّا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون﴾ [الحجر، 88-96].
إن بعض الإنتباه إلى هذه الآيات مع ترتيبها ثم وقفة تأمل أمام الكلمات: ﴿تمُدَّنَّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجًا﴾ و﴿الذين جعلوا القرآن عضين﴾ و ﴿وأعرض عن المشركين﴾ والوعد بكفاية ﴿المستهزئين* الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر﴾... إن الدقة في هذه الأمور توضح المفهوم القرآني عن الشرك (في مصطلح الأحاديث الشرك الخفي) وإن التوحيد الكامل هو في التسليم لجميع ما أمر به، وإن تجزئة القرآن نوع من الشرك، وجعل مع الله إلهًا آخر هو المطاع في بعض المواقف وإن المظاهر التي يعيشها الآخرون الذين لا يؤمنون بالله أو بعبارة أخرى النجاح الظاهري الذي يكتسبه الملتزمون بقوانين غير القوانين الإلهية، إن هذه المظاهر رغم إغرائها لا يمكن أن تشكل طموح الرسول (ص)، والمؤمنين الذين يلتزمون بأحكام الله جميعًا رغم اتهامهم بالرجعية وغيرها، ورغم تعرضهم للإستهزاء.
والحقيقة أن المفهوم القرآني للشرك أو للكفر بالله لا ينحصر في العبادة لغير الله، وإلا فما معنى الآية المباركة: ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم﴾ [الجاثية،23] هل هناك من يصلي ويسجد لهواه؟ بل الإله في المصطلح القرآني هو قدس أقداس الإنسان الذي يدفعه في حركاته ونشاطه بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو الذي يجعل الإنسان من نفسه، وفكره وعواطفه وحركاته، وسيلة لكسب رضاه، لتلبية رغباته.
وهذا المعنى هو المعنى الذي يقرب بل يوحد بين معنى التوحيد ومعنى السلام إذ الإسلام هو التسليم الكامل عقلًا وقلبًا وجسمًا لله، فالتسليم في مقام العمل أي إسلام الجوارح هو جزء من مفهوم التوحيد.
والآيات القادمة تلقي أضواءً على هذا المفهوم العميق فلنتلها بتأمل:
﴿إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا * أولئك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا﴾ [النساء، 150 – 151].
فلنكرر: ﴿ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا﴾ ألا يعني الكفر ببعض الأحكام، عدم إعتراف بصلاحيتها والاقتباس من المصادر الأخرى؟
ثم نتلو أيضًا: ﴿ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله﴾ هؤلاء هم عينًا ﴿الذين يكفرون بالله ورسله﴾ فالإيمان بالله بالعقل وبالقلب "أي العقيدة والأخلاق" دون الإيمان بالجسد أي الإلتزام بالأحكام "كفر بالرسل وفي مقياس القرآن كفر بالله والرسل".
وهنا يظهر بوضوح ما سنقرأه في سورة المائدة وفي الآيات 44 – 50 حيث أن الحكم بغير ما نزّل الله حول القيود والقصاص يعتبر في منطق القرآن ظلمًا وكفرًا وفسقًا وكذلك اتباع أهواء الآخرين وعدم الخضوع لأحكام الله في الإنجيل وفي القرآن مرفوض وفسق.
الآيات: ﴿إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استُحفِظُوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشونِ ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون * وكتبنا عليهم فيها أن النفسَ بالنفسِ والعينَ بالعينِ والأنفَ بالأنفِ والأذنَ بالأذنِ والسنَّ بالسنِّ والجروحَ قصاصٌ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون * وقفّينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدِّقًا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقًا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين * وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون * وأنزلنا إليك الكتاب بالحقِّ مصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون * وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإنَّ كثيرًا من الناس لفاسقون * أفحكمَ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون﴾ [المائدة، 44 ـ 50].
ومجمل القول إن الأحكام في الشريعة الإسلامية مثل جميع الشرائع السماوية جزء لا يتجزأ من الوحدة المتكاملة التي نسميها "بالإسلام". والإسلام رغم تقسيم تعاليمه في الدراسات والكتب إلى الثقافة والعقيدة والفقه والأخلاق، رغم ذلك، وحدة متماسكة مترابطة الحقول متفاعلة الأجزاء، فالثقافة أو ما نسميه الرؤية الإسلامية للوجود قاعدة لعقيدته وكلتاهما أساس للشريعة في فقهها وأخلاقها. ومن جانب آخر فالشريعة تصون العقيدة وتوضح الرؤية وكل قسم من الشريعة ذو تأثير عميق على القسم الآخر.
وإليكم بعض الصور لهذا الترابط :
القرآن الكريم يعطي مفهومًا عن الله هو أوسع وأشمل من كافة المفاهيم التي قُدِّمَت من قبل الأديان السابقة "ملك الملوك"، "الأب" ومن قبل المفكرين والفلاسفة "واجب الوجود"، "الوجود المطلق".
هذا المفهوم الذي له الأسماء الحسنى وهو منتهى كل كمال والأول والآخر والظاهر والباطن: ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ [الزمر، 67] وهو أقرب من حبل الوريد و﴿يحول بين المرء وقلبه﴾ [الأنفال، 24] وغير ذلك، هذا الذي نعده ركن الثقافة الإسلامية أساس العقيدة على المسلم أن يدرك هذا ويؤمن به عن دليل ويعيشه بكل وجوده ولا يقبل الإسلام بغير هذا أبدًا ولا يعد الذي فكر وآمن بغيره مسلمًا وهكذا يقدم الإسلام مفاهيم عن الكون والحياة والموت والإنسان والمجتمع وغيره، وهذه المفاهيم أسس التفكير والإيمان والعمل في الشريعة الإسلامية.
والإيمان بالله الواحد الأحد الذي ﴿لم يلد ولم يولد﴾ [الإخلاص، 3] بدوره ينعكس على موقف المسلم من أخيه المسلم ومن الإنسان كل إنسان ومن مجتمعه.
والعبادات بما لها من شروط وفي مقدمتها الإخلاص لله في النية نتيجة طبيعية لهذا الإيمان، وفي نفس الوقت تصون الإيمان وتنميه في النفس وتقلص النزعات الدافعة للتحرك في نفس الإنسان المسلم.
وتأثر الأخلاق الإسلامية بهذا وذاك ظاهر، حيث أن الكبر مرفوض والثقة بالله، لا بالنفس، والتواضع وحسن الظن والتسامح والطموح الكبير والأمل الدائم والكرم والشجاعة، هذه الأوصاف تُستقى من الإيمان الإسلامي ومن الرؤية الإسلامية ومن العبادات والأعمال المرغوبة في الفقه الإسلامي وهي بدورها تؤثر فيها.
إن الصورة الحقيقية للإسلام هي في كونها لوحة مترابطة الأجزاء لكل حكم مكانه ولكل تعليم أثره البالغ. وتجزئة هذه الصورة للدراسة لا يمكن أن تفصل بين حقولها ولا تمكن المسلم من الاحتفاظ الكامل ببعض مع ترك البعض الآخر.
2- التفاوت في الأساس: يصرح القرآن الكريم في أول سورة البقرة أن الأساس الأول للتقوى هو الإيمان بالغيب ويأتي من بعده متسلسلًا إقامة الصلاة والإنفاق مما رزق الله وهذا التسلسل يتضح في مختلف التعاليم الإسلامية ويؤكد أن الحكم الإسلامي ينطلق من أساس الإيمان بالغيب.
والحقيقة أن الفارق المميز بين الحكم الديني وبين الحكم الوضعي هو الإيمان بالغيب بل هذا هو الفرق بين التعاليم الدينية وبين العلوم المختلفة وبينها وبين آراء الفلاسفة وبينها وبين مكارم الأخلاق وغيره.
والغيبية في أساس الحكم الديني هي سبب القداسة والخلود والإطلاق. والحاجة الملحة في نفس الإنسان إلى الغيب وإلى الاطمئنان والإستقرار في كافة شؤونه الحياتية، تُلبى بواسطة هذه الصفة.
إن هذه الحاجة تنبع من الإحساس الطبيعي بضرورة المعايشة مع المطلق وإلا فهو يعيش مضطربًا في ذاته مترددًا في سلوكه ضعيفًا في عزماته ومواقفه.
أما العلوم والفلسفة والتكنولوجيا والقوانين الوضعية وكل ما هو من صنع الإنسان فهو متزلزل، حيث إنه متكامل ومتغير لذلك فهو لا يغني الإنسان عن شعوره بالحاجة إلى المطلق، يحس بصحبته الدائمة في ساعات الحرج وعند انهيار الأسباب والتردد في بداية السلوك.
ويشير القرآن الكريم إلى هذه الزاوية من حاجات الإنسان بقوله: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ [الرعد، 28].
ومن المؤكد أن هذا الإحساس بالمعايشة لا بد من التكريس عند ممارسة الحياة العادية والعبادات في الإسلام بتوقيفها وعدم تقبلها للتطوير أثر حتمي لخلق هذه المعايشة، وهي بدورها تصونها وتنميها بل الثابت في جميع الأحكام الشرعية حتى المعاملات والأعمال العادية إمكان إقترانها بقصد القربة. بل الأفضل من ذلك كما ورد في وصايا الرسول (ص) وهذا بدوره يؤكد حتمية إستناد الأحكام إلى الغيب حيث أن لا قربة دون الغيب، ومن جهة أخرى فإنها تتفاعل مع المعايشة المطلوبة حتى لو كان ذلك ضمن إطار عام فيكون الإنسان عند اتخاذ مواقف يحس بأنه ينفذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة فعل إيمانه بالله وتسليمه لأمره ونهيه.
إن الغيبية وما وراءها من صفات لا تتنافى على صعيد التطبيق مع التطوير والاهتمام الكامل بالضرورات الاجتماعية المتغيرة وبكلمة فإن سماوية الحكم لا تتناقض مع أرضية التطبيق عند حاجة الإنسان له.
وهنا يتضح مفهوم الإجتهاد في الشريعة والفرق بينه وبين التشريع المتعارف في المؤسسات المخصصة للتشريع.
إن الإجتهاد هو في المصطلح استفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي من مصادره. وهذا يعني أن المجتهد يبذل قصارى جهده في المصادر والنصوص لكي يكشف الحكم للواقعة التي يحتاج إلى معرفة حكمها فهو يضم إلى الحكم الديني فهمه واستنباطه النابع من خبرته وممارسته ومَلَكَته النفسية به، يدخل كل هذا في استنباط المجتهد.
إن الإجتهاد تحرك وتطور ونظرة إلى الأرض ضمن الإطار الغيبي المطلق السماوي للحكم، فالإطلاق والغيبية لا يفقدان الحكم تطوره وانطباقه على حاجات الإنسان كما أن التطور والاهتمام بالحاجات لا يفقدان الحكم قدسيته وغيبيته.
أما التشريع فهو دراسة الموضوع وأبعاده والظروف المحيطة به ووضع حكم له مستند إلى مصلحة عامة أو خاصة.
والتشريع على هذا يضم جزءًا من فهم المشرِّع إلى المصالح المتوافرة في الموضوع وهو أي التشريع نظرة إلى الأرض بينما الإجتهاد إنتباه إلى السماء ويشتركان في انضمام جزء من ذات المجتهد والمشرِّع ومن فهمه واستنباطه.
3- التطور في الشريعة: وقد وضع الإسلام ضمن شريعته مبادىء تمكن الإنسان من تطوير الحكم الشرعي حسب مقتضيات الزمان والمكان وغيرهما دون أن يفتقد الحكم قداسته وغيبيته.
وبذور التطور هذه على أنواع:
النوع الأول: موضوعات الأحكام وأجزائها وشروطها التي تقبل التطوير في مدلولاتها عند مختلف الظروف والأحوال ذلك مثل موضوع حكم تعدد الزوجات في القرآن الكريم: ﴿وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى﴾ [النساء، 3] وهذا الشرط قابل للتعميم في الحالات الاجتماعية المتنوعة كظروف ما بعد الحرب وفي بعض المجتمعات الخاصة والمفهوم من الآية أن هذا الحكم ليس حكمًا مطلقًا في جميع الحالات.
وإذا فسرنا الآية الكريمة بأنها في صدد بيان حل لمشكلة الخوف من عدم القسط في شؤون الأيتام وليست في مقام تقييد الحكم إلا لمنع الزيادة عن أربع، إذا فهمنا الآية بهذا المعنى نقول: أن القرآن لم يذكر إذًا أي نص يبيح التعدد المطلق والسيرة المطهرة وسلوك الأصحاب والأئمة سيرة عملية لا إطلاق لها مثل الأدلة اللبية في مصطلح الأصوليين، يمكن اختصاصها بأسباب خاصة وبشروط معينة:
ومثل شرط العدالة في العشرة فهي تختلف باختلاف حقوق المرأة التي تحدد إمكانية قيام الزوج بمسؤولياته أمام أكثر من زوجة.
نقول هذا حتى ولو كانت الروايات فسرت العدل في العشرة فإن شأن المرأة في الطعام والكساء والسكن يختلف أيضًا ويتطور.
ومثل موضوع الفقر في الزكاة حيث إنه يتطور حسب الحاجات المتزايدة ومتوسط الدخل الفردي. فكلما تحسنت أوضاع المعيشة وارتفع المستوى المتوسط توسع مفهوم الفقر وهذا يعني أن الزكاة تدارك مستمر لنقص الأوضاع المعيشية لدى الفقراء وتقريب دائم لمستوى دخل الطبقات المختلفة.
ومثل موضوع الرشد في آية البلوغ والذي يجعل عمر البلوغ المدني يختلف عن السن الذي يبلغ الشاب درجة المسؤولية الجزائية.
إن الآية الكريمة تقول: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء، 6] واستئناس الرشد بعد البلوغ الجزائي ضروري للتأكد من وصول الشاب درجة البلوغ المدني وهنا يدخل تقدير الحاكم المسلم عندما يريد وضع القانون لتحديد سن المسؤولية المدنية وبالتالي يدخل إمكان التطوير.
والأمثلة على هذا كثيرة جدًا اكتفينا بالقليل منها، وأبرزها مبدأ تطبيق الزكاة فبإمكاننا اليوم أن نرفع مستوى حياة الفقراء بواسطة تأمين العلاج والعلم والضمان الاجتماعي لهم وهذا أقرب للكرامة وأدق في هذا العصر.
النوع الثاني: مبادىء موضوعة لأجل التطوير بالذات مثل قاعدة "المؤمنون عند شروطهم" وقانون ﴿أوفوا بالعقود﴾ [المائدة، 1] وغيرهما ومن خلال هذه القواعد يمكن تطوير صور الزواج وشروط الطلاق وإدخال تعديلات واسعة في قانون الأحوال الشخصية.
فالزواج بالصورة العادية هي الصورة المتناسبة مع بعض العصور إقترح الإسلام له صورة أصلية هي المتعارفة لدى المسلمين ويمكن وضع صور جديدة للزواج من خلال وضع شروط ضمن العقد تحدد استرسال الرجل في الطلاق وعند الامتناع عن الطلاق وتحدد أيضًا المكان والمال المكتسب خلال العمل والأموال الموجودة في البيت ويمكن وضع شروط يستصعب على الزواج معها من تحديد الزوج كما يمكن تحديد وضع الأولاد عند الطلاق.
إن هذه الشروط يمكن أن توضع ضمن استمارات تعرض على الزوجين حال الزواج لأجل التمسك بها أو التخلي عنها. فإذا ذكر في عداد الشروط أن الزوج إذا أراد أن يطلق دون مبرر صحيح فعليه أن ينفق على المطلقة ما دامت غير متزوجة أو عليه أن يدفع مبلغًا كبيرًا. إن هذا الشرط من طبعه تحويل كل طلاق إلى المحكمة لمعرفة الموضوع ووجود المبرر الصحيح، ثم إنه يحول دون استرسال الزوج في الطلاق، ومن جهة ثانية إذا وضعنا ضمن العقد وكالة الحكمين أو المحكمة عن الزوج في الطلاق في حالات معينة فإن تعنت الزوج في امتناعه عن الطلاق يخف بل يتعالج نهائيًا.
النوع الثالـث: مراعاة العناوين الثانوية فإنها من أهم شؤون الاكتشاف وتطوير الأحكام الشرعية، فالتأميم مثلًا لا يمكن قبوله كمبدأ في الشريعة الإسلامية حيث إنه يقوم على أساس عدم الاعتراف بالملكية الشخصية ولكن الشريعة عندما تلاحظ أن مصالح الأمة تعرضت للخطر مثلًا تقف لحظة واحدة لحفظ مصالح الفرد فتحكم عندئذٍ بالتأميم أو حتى المصادرة، وهنا ينفتح باب واسع آخر لأجل تلبية الحالات الحادة والمستعجلة وغيرها ضمن الإطار الشرعي المتحفظ.
إن هذه التطورات ضمن الإطار العام للحكم الديني تمكن المسلم من معايشة التطورات الحديثة ومعالجة الحاجات والمشكلات الاجتماعية المتزايدة دون أن يشعر بأنه ينفذ حكمًا غير حكم الله ومع احتفاظ الحكم بقداسته الكاملة.
وهنا يتضح الفرق في الأساس بين الحكم الشرعي وبين الحكم الوضعي وما عليه عالمنا الإسلامي اليوم، حيث إن الأحكام والتشريعات فقدت قداستها لأنها لم تستند إلى أساس غيبي.
4- الفرق في المصادر: إن مصادر الأحكام الإسلامية تختلف كليًا عن المصادر المعتمدة لتشريع القوانين في العالم الإسلامي في هذا الوقت رغم ما يوجد في كافة الدساتير والقوانين الأساسية، إن دين الدولة الإسلام، وإن الإسلام مصدر رئيسي من مصادر التشريع. إن هذا كله لا يغير حقيقة الأمر.
فالحكم الإسلامي يبحث عنه وعن تفاصيله في القرآن والسنة المطهرة ثم في إجماع الأمة وهذه المصادر لا تُراجع من قبل الباحثين عن وضع القوانين بل البحث يتجه في المبادىء الدولية الحقوقية وفي تجارب الأمم الأخرى وفي الدستور وفي بلاغات الثورة وتضع المجالس التشريعية تفاصيلها. ثم تصدر مراسيم لأجل تنفيذها ولا يصلح أي قانون للتنفيذ ما لم يصدر المرسوم بشأنه ومع رعاية شروط معينة.
والمصادر تقتبس على ضوء المصالح والحاجات من الأحكام الإسلامية كما تقتبس من سواها. يقال أن "نابليون" في رحلته إلى مصر حمل معه الفقه الإسلامي في القضايا المدنية واعتمد عليها في قوانينه الشهيرة. إن هذا الاقتباس لم يجعل القوانين النابوليونية أحكامًا شرعية.
إن الفقيه المعاصر عليه أن يرجع إلى المصادر القانونية المعاصرة أيضًا لكي يصدر الفتوى ولكن الرجوع هذا محاولات لاكتشاف الموضوع وإدراك أبعاده على العكس من الحكم الوضعي.
وهناك فرق آخر في هذا المجال وهو أن اختيار الحكم الشرعي من مصادره إلزامي على العكس من اقتباس الحكم الوضعي الذي يجعل القانون المقتبس بإرادة السلطات المشرعة دون إلزامها على إصداره.
يبقى المصدر الأخير من مصادر الشريعة الذي هو مصدر القوانين الوضعية في نفس الوقت وهو العقل ولكن العقل في الشريعة أساس العقيدة والمسائل العقائدية في الغالب، ثم إنه يعتمد لاكتشاف الحكم الالهي إستنادًا إلى مبدأ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أما الأحكام الوضعية فمن أوسع مصادرها حكم العقل وآراء العقلاء على أنها تلبية لحاجات الإنسان وبالتالي فهي أحكام موضوعة من قبل الإنسان.
5- المبادىء العامة: عند مقارنة التشريعات المعاصرة مع روح الشريعة نجد فارقًا في المبادىء العامة أيضًا رغم أن هذا الفارق هو نتيجة طبيعية للتفاوت في الأساس.
أ. فالفقه الإسلامي يعتمد في عباداته ومعاملاته على النية إلى حد كبير اعتمادًا مطلقًا بينما التشريعات الحديثة تقلص من دور النية بشكل ملموس. والنية في الإسلام هدف وروح للعمل والنتيجة الباقية منه يحاسب الإنسان بحسابها ولا يُقبل أي عمل من دونها ولها في المعاملات من عقود وإيقاعات دورها الأساسي نكتفي بتذكير المستمعين إلى الفرق بين الاضطرار والإكراه وصحة العقد مع الأول دون الثاني نكتفي بهذا اختصارًا ثم نعيد إلى أفكارنا اهتمامات الإسلام بالمسائل النفسية والدوافع ومسائل الأخلاق.
ب. تضع الشريعة الإسلامية حدودًا لمفهوم الملكية وتلغي الملكية عن بعض الأشياء والمالية عن بعض الأشياء وعلى هذا الأساس تتأثر المعاملات تأثرًا بالغًا في هذا المجال.
فالخمر وآلات اللهو وما لا يستعمل إلا في المعاصي ولا يتمتع به في الحلال لا تعد في الإسلام مالًا فلا يجوز بيعها وشراؤها واستئجارها. كما وأن الملكية تحتاج إلى سبب ثابت فلا يكفي التسجيل للأرض في تملكها بل الحيازة أيضًا لا تملك. إنما الإحياء سبب لملكية الأرض ثم المبادلة والميراث.
ج. والإنسان في المعاملات يقوم بدور كبير وفي التشريعات الحديثة تقوم المؤسسة مقام الإنسان تدريجيًا. أما الإسلام فعلى الرغم من إقراره بل اكتشافه لأول مرة الشخص المعنوي فإنه يعلق على الشخص الحقيقي في المعاملات والإيقاعات والشهادة والقضاء أهمية كبرى تجعل منه الركن الأساسي.
د. والعمل الذي هو أساس لبناء العلاقات الاجتماعية مفهومه لدى الشرع غير مفهومه في القوانين الوضعية وهذا التفاوت في المفهوم يدخل فرقًا أساسيًا في القوانين والأنظمة.
إن العمل في المفهوم الديني رسالة ووظيفة، لذلك فهو حي مطلق يربط أعضاء المجتمع بعضها ببعض ويربط الأجيال المتلاحقة ربطًا عضويًا.
إن العمل ليس بضاعة تُباع وتُشترى كالأمتعة والأشياء الخارجية بل هو واجب. يقدم المجتمع الإسلامي لعامله الواجب لحفظه وحفظ عائلته وشؤونه حسب ظروف المجتمع والمرحلة الاقتصادية التي يمر فيها وهذا البحث من كنوز الفكر الإسلامي وهو مفتاح توزيع الثروة العادلة في نظام الإسلام الاقتصادي توزيعًا عادلًا موجهًا مطورًا يشد الأفراد والأجيال في رباط مقدس.
والعمل في مفهومه القانوني كمية من الطاقة المجسدة تُقدم مقابل أجر معين والتقابل يقتضي المساواة في القدرة والجودة أو الرداءة. والعمل في هذا المفهوم بضاعة بحتة تبحث الأنظمة الشيوعية والرأسمالية عن تقييمها ووضعوا على نتائج التقييم جميع قوانينهم الاقتصادية وغيرها.
ه. والكمال في المفهوم الديني كمية مقترنة مع الحق وليس المهم أن نكتسب القدر الأكثر من المكاسب بل المهم عدم مفارقة الحق، مع العلم أن المبدأ في المفهوم القانوني الوضعي هو تأمين الوصول إلى الدرجة الأعلى من المطالب حتى على حساب الآخرين. وما نسميه اليوم بالتربية في الإنسان والتنمية في الأشياء هو ما عبرنا عنه بالكمال في المصطلح الديني والواجب على المسلم من المهد إلى اللحد.
وهذا مصدر الطغيان والظلم والثروات والصراع الاجتماعي المرير والقانون الوضعي المنبثق من الواقع البشري يكرس هذا.
أما الدين فساحة كمال الإنسان فيه فسيحة لا يصطدم تحقيق طموح الفرد مهما بَعُد بطموح الآخرين ولا لمصالح الجماعة بمصالح جماعات أخرى فرضى الله لا حد له ولا يشغله شأن عن شأن.
و. والربا فرع من هذا المبدأ، ناهيك عن تحكم قانون العرض والطلب بصورة مطلقة في التشريعات القانونية. حتى في الأنظمة الشيوعية ولكنه يتحول إلى ميادين أوسع.
ز. وهناك مبدأ الجزاف واعتماد الحظ وجهالة العوضين أو الغُرر فهو بفروعه مرفوض في المعاملات الإسلامية دون التشريعات القانونية التي تكرس في العالم الإسلامي أنواعًا كثيرة من هذه المعاملات كما نجد أنواعًا من اليانصيب، هذه المقامرة التي تسلب الإنسان المسلم جميع أنواع العطاء حتى في الصدقات الصغيرة فتحولها إلى تجارة.
أما التفاصيل في الفروع فوجود أحكام وقوانين غير متوافقة مع الشريعة بل متناقضة معها أكثر من أن تحصى وهذا أثر طبيعي للفرق في الأساس والمصادر والمبادىء العامة.
6- الربا: هنا أحب أن أقف أمام مثال واضح يلقي الأضواء الكاشفة على الواقع الإسلامي وهو مثل الربا.
إن أكثر الدول الإسلامية بعدما وجدت الحاجة الملحة إلى القرض لأجل الإنماء وبعدما وجدت أن حرمان صاحب المال من الربح غير ممكن أقرت الربا بصورة صريحة أو في إطار من إستحياء. فمن محاولة لإصدار فتاوى بالسماح للربا في الإنتاج لا في الإستهلاك إلى حلية الربا مع فائدة قليلة أو إبراز معاملات ربوية في صورة غير صريحة مثل أوراق الاستثمار في بعض الدول الإسلامية.
هذه المساعي تكشف بوضوح سير القوانين في العالم الإسلامي مع العلم أن المحاولة لاكتشاف بديل عن الربا كالمضاربة من المصادر الإسلامية لم تجرِ والدراسات التي وضعت لها أو اقتراح بنك لا ربوي ما جُرِّبَتْ من قبل المعنيين في العالم الإسلامي أبدًا رغم الأموال الطائلة التي تصرف في مختلف الشؤون الدينية وفي مجالات الدعوة والثقافة وغيرها.
7- التشريع المعاصر: وفي نهاية المطاف لا بد من طرح السؤال المطلوب طرحه في هذه الدراسة وهو أننا رغم الواقع ورغم الظروف المحلية والعالمية المعاشة كيف يمكننا أن نختصر الطريق ونقرب البعيد ونسلك خطًا يوصل التشريع المعاصر في يوم ما إلى روح الشريعة الإسلامية؟
وفي الجواب، علينا أن نعترف بصعوبة المسلك وضرورة توفير النية الحازمة ومن ثم يصار إلى تكليف هيئة من علماء الدين تضع الهيكل التشريعي العام ثم تلتقي مع الخبراء في القانون ومع المعنيين بالشؤون العامة لكي تبحث معهم ويدرسون جميعًا تطبيق المبادىء العامة ووضع التفاصيل على ضوء الواقع والظروف المحيطة به واستنباط الأحكام الأولية للأمور وإصدار الأحكام المرحلية لدى الحاجة.
وإن هناك أمورًا لا يمكن قبولها من الناحية الشرعية ولكن يمكن تبني الشريعة لها على ضوء الظروف الحرجة للأمة ومن أوضح الأمثلة على ذلك مبدأ التأميم ثم السعي إلى تطبيق هذه النتائج في إطارات محدودة لاكتشاف النواقص واختيار الأفكار على الأرض في هذا القرن ومراقبة هذه التجارب ومن ثم تحويلها إلى قوانين وتقديمها للمجتمعات الإسلامية مع الاحتفاظ بالأساس وبالمصادر والمبادىء دون التفريط بأحدها مهما صغر في تقييم الناس له.
وبعد، فإن الطريق رغم وعورتها سالكة، والمشكلة رغم صعوبتها لا تستعصي على الحل.
﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين﴾ [العنكبوت، 69].
* ردود الإمام الصدر على التعقيبات