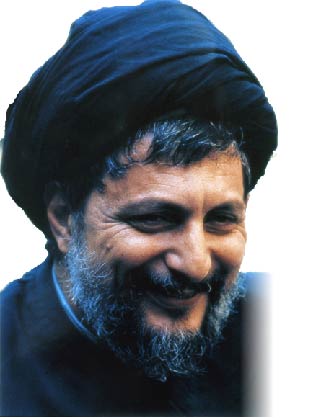*تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿حم * والكتاب المبين * إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركةٍ إنا كنا منذرين * فيها يُفْرَقُ كل أمرٍ حكيمٍ * أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين * رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم * رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين * لا إله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ [الدخان، 1-8]
صدق الله العظيم
هذه الآيات التي تلوناها هي بداية سورة الدخان، السورة التي ورد في الأحاديث الشريفة المأثورة أنها تتلى إلى جانب سورتي الروم والعنكبوت في ليالي القدر.
وفي بداية السورة بالذات نرى آيات تبحث عن ليلة القدر وعن نزول القرآن، وفي السورة أبحاث متعددة تتناسب والجانب التربوي الذي يهتم به الإسلام في احتفالاته وفي شعائره وفي عباداته وفي مختلف تعاليمه. أي أن الإسلام يريد أن يبني الإنسان الجديد، ولا شك أن بناء الإنسان بمقدار ما يتوقف على وجود المجتمع الصالح يعتمد على التربية الذاتية. وكأن هذه السورة بجميع آياتها وأبحاثها ترمي إلى الجانب التربوي في حياة الإنسان. ولذلك حاولنا أن نتبرك بهذه السورة المباركة ونتلوها ونتعمق في مفاهيمها قدر المستطاع بمناسبة هذه الليلة المباركة ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، وهي ليلة ورد في الأحاديث الشريفة أنها من أقوى احتمالات ليلة القدر. وفي الوقوف مع هذه السورة المباركة بتأمل، والاستظلال بمعانيها الكريمة، نقف أمام بعض الأبحاث التي تسمح لنا الفرصة بمطالعتها ودراستها.
فالسورة تبدأ بكلمة ﴿حم﴾ شأنها شأن بعض السور الأخرى في القرآن التي تبدأ بما يسمى بالكلمات والأحرف المتقطعة، وهي ذات معانٍ ودلالات غير وضعية، بل دلالات عقلية كما يسمونها في المنطق. وقد بحث المفسرون طويلًا في معنى الكلمات المتقطعة في أوائل السور مثل ﴿كهيعص﴾ [مريم، 1]، ﴿حم﴾ [الدخان، 1]، ﴿عسق﴾ [الشورى، 2]، ﴿ألم﴾ [البقرة، 1]، ﴿ألمر﴾ [الرعد، 1]، ﴿ق﴾ [ق، 1]، وأمثال ذلك من السور المختلفة.وفي الحقيقة أننا إذا درسنا وضع نزول القرآن، وأن الرسول الأكرم بقرآنه كان يتحدى العرب الفصحاء ويعتمد على أن فصاحة القرآن بالإضافة إلى معانيه هي معجزة، أيّ أن الجن والإنس لو اجتمعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يمكنهم ذلك بل لا يمكنهم أن يأتوا بعشر سور من أمثال سوره، حتى وصل الأمر إلى درجة أن القرآن تحدى فصحاء العرب بأنهم لا يقدرون على أن يأتوا بسورة واحدة من سور القرآن الكريم.
|إذًا، كان جو نزول القرآن خاصةً لدى السور المكية وسورة الدخان تعد من السور التي نزلت في مكة، جو نزول الآيات والسور جو التحدي، أيّ أن المستمعين كانوا يتربصون ويتوقعون عثرة حتى يأخذوها على القرآن.
فلو كانت الكلمات التي تبدأ السور بها كلمات غير مفهومة، غير مأنوسة، غير متناسبة، لكان الاعتراض ارتفع والتحدي رُدَّ من قبل المستمعين، ولكننا في التفاسير والسير لم نسمع إطلاقًا بأن العرب المخاطبين في مرحلة النزول، المعاصرين لنزول القرآن الكريم اعترضوا على هذه الكلمات، أو سألوا عن معاني هذه الكلمات. وهذا يدل بوضوح دلالة عقلية على أن هذه الكلمات كانت مفهومة لدى المستمعين في ذلك الوقت. فماذا يا ترى يمكن أن يفهم من هذه الكلمات إلّا ما ورد في بعض التفاسير، وإلّا ما هو أقرب إلى التفكُّر أن هذه الكلمات إشارة واضحة إلى الحروف الأبجدية التي تركَّبت منها كلمات القرآن وسور القرآن. وكأن الرسول، والذي أوحى إلى الرسول بالقرآن وهو الله سبحانه وتعالى، يريد أن يقول للناس أن هذا القرآن الذي تعجزون أن تأتوا بمثله أو بمثل سورة من سوره ليس القرآن مكونًا من كلمات وحروف غير متعارفة وغير متداولة بأيديكم، بل أن القرآن مكون من الحروف والكلمات التي هي بأيديكم، والتي يستعملها كلّ واحد منكم، وتركبون ألفاظكم وكلماتكم وأفكاركم وتعبيراتكم منها.
إذًا، رغم توفر المواد الأصلية للتركيب، القرآن الكريم تركب من هذه الكلمات وأنتم لا تتمكنون من أن تأتوا بمثله، وهذا تمامًا كما يقول المهندس عندما يبني جسرًا متينًا بأن هذا الجسر بُني من التراب ومن الحديد ومن الإسفلت وأمثال ذلك من المواد الأصلية. إذًا، التحدي والإعجاز يبلغا الدرجة القصوى عندما يقول القرآن الكريم أن هذه الكلمات هي التي تركب القرآن وجمل القرآن وكلمات القرآن منها، ومع ذلك فالقرآن معجز لا يمكن أن يقابل أو أن يضاهى وأمثال ذلك.
والذي يؤكد ذلك أن هذه السور التي تبدأ بهذه الكلمات غالبًا نجد أن الحروف الواردة في البداية هي الحروف التي تستعمل في هذه السورة أكثر من غيرها ففي سورة ﴿حم * عسق﴾ [الشورى، 1-2] نجد أن هذه الحروف استعملت فيها أكثر من السور الأخرى وكذلك في سورة الدخان التي هي موضع دراستنا وتفكرنا وتأملنا. اللفظ "حاء" و"ميم" مستعملان فيها بكثرة، وذلك تأكيد على هذا المعنى الذي كان واضحًا لدى المستمعين ولدى فصحاء العرب الذين تحداهم القرآن الكريم. إذًا، ﴿حم﴾ لا يقصد منه إلّا إعجازًا وتأكيدًا وتثبيتًا لإلهية القرآن وسماوية كلماته.
وفي الآية الثانية قسمٌ بالكتاب المبين والذي هو القرآن الكريم بطبيعة الحال، والذي يوضح ويبين الحقائق، ونحن نعلم أن هذا القسم يتناسب مع موضوع القسم شأنه شأن جميع أنواع القسم الواردة في القرآن الكريم. فحيث إن البحث في هذه السورة عن التبيان وإيضاح الحقائق ونزول القرآن وتوضيح جميع الأمور الأساسية في الحياة إذًا، الكلام عن الإبانة، فالقسم يأتي متناسبًا مع هذا المضمون، ويقول: ﴿والكتاب المبين﴾ أقسم بالكتاب المبين على صحة ما يأتي بعد هذه الجملة، أما الأبحاث الواردة في مضمون هذه السورة فهي أبحاث متعددة.
البحث الأول حول القدر وليلة القدر. طبعًا الآيات الأول من السورة: ﴿إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركةٍ﴾ لقد أنزلنا القرآن، لقد أنزلنا الكتاب المبين في ليلة مباركة، هذه الليلة هي ليلة القدر التي تشير إليها سورة القدر بالذات عندما تقول: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ [القدر، 1] ولا شك أن القرآن حسب تأكيد الآيات المتعددة نزل مرتين، النزول الأول ما يسميه القرآن الكريم بالإنزال أيّ أن القرآن نزل دفعة واحدة إنزالًا في ليلة القدر على قلب رسول الله عندما وصل النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) حسب استعداده وجهده، وبناءً على إرادة الله إلى مقام الرسالة، فقلبه استوعب ملكوت السماء والحقائق الكونية التي يعبر عنها القرآن الكريم من حيث العلاقات بين الإنسان ونفسه والإنسان والحياة وبين الإنسان والله.
إذًا، في ساعة واحدة، وفي ليلة واحدة دخل الرسول حرم الملكوت فاستوعب جميع الحقائق بصورة إجمالية، وهذا معنى الإنزال الذي حصل في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان لأن الآية الأخرى تؤكد أن: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ [البقرة، 185]. إذًا، إنزال القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر ونتيجة الآيتين تصبح أن ليلة القدر هي في شهر رمضان المبارك.
المرحلة الثانية من مراحل نزول القرآن هي مرحلة التنزيل أيّ مرحلة النزول بالتدريج، هذه المرحلة التي بدأت مع نزول السورة المباركة أول سورة نزلت على رسول الله التي تبدأ بكلمة ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علقٍ﴾ [العلق، 1-2]. هذه الآيات التي نزلت على رسول الله عشية السابع والعشرين من شهر رجب، وهي آيات بدأت مرحلة التنزيل القرآني والتي أخذت فرصة ثلاث وعشرين سنة طوال مدة حياة الرسول.
بدأ القرآن يتنزل على رسول الله تنزيلًا فكان عليه أن ينتظر أمر الرسول بالإبلاغ، والتنزيل التفصيلي للآية حتى يبلغها للناس. إذًا، ﴿إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركةٍ﴾، هي ليلة القدر.
ماذا نفهم من ليلة القدر؟ رغم أن هذا البحث قد تكرر في حلقات التفسير وفي مناسبات عديدة نرى أن المناسب في مثل هذه الليلة أن نتحدث عنه ببعض التفصيل لأن المشهور عند الناس، عند جميع المسلمين، أن ليلة القدر فرصة سانحة تتوفر لبعض الناس السعداء ولا تتوفر للبعض الآخر؛ ولها علامات تختلف عن علامات الليالي العادية. ويقول الأمر الشائع بين الناس أن الإنسان إذا أدرك ليلة القدر بإمكانه أن يطلب ما يشاء فيلبى طلبه، ويقول الأمر الشائع أيضًا والأثر المتعارف بين المتدينين أن هذه الساعة إذا أدركها الإنسان بإمكانه أن يطلب زيادة في العمر والرزق والسعادة وحج بيت الله الحرام وكلّ شأن يهمه من أمور حياته، وكأنهم يقصدون بذلك أن هذه الليلة أو هذه الساعة أشبه ما تكون بساعة تقرير الموازنة لدى الحكومات في هذا العصر، فالمجلس والحاكم عندما يصدر الموازنة العامة يحدد بشكل نهائي في هذه الساعة كمية توزيع الأموال على المشاريع ورواتب الموظفين ومختلف شؤون الدولة من نفقات ومدخولات وضرائب، أما ما قبل ذلك فهي مراحل تحضيرية. فأرادوا أن يقولوا أو أثر ما يقولون ونتيجة ما يقولون أن هذه الليلة ليلة إقرار الموازنة للأرزاق والأعمار والحاجات لكلّ إنسان.
لا شك أن هذا المعنى كما تحدثنا في بعض الليالي السابقة لا يمكن أن نستوعبه استيعابًا إسلاميًا، فالمفاهيم القرآنية والتأكيدات الإسلامية توضح أن الحياة نتيجة الجهد، وأن الإنسان ليس له إلّا ما سعى، ونحن نعلم أن حياة الإنسان في السنوات المقبلة كثيرًا ما ترتبط بوضع الصحة التي يعيشها الإنسان من ذي قبل، أمراض الإنسان، أخطار الإنسان، الحوادث التي يتعرض لها الإنسان، مراقبة الإنسان لوضع الصحة أو لعدم الصحة، هذه الأمور هي التي تحدد عمر الإنسان بشكل مبدئي. إذًا، إذا مات الإنسان أو مرض فلا يمكن أن نقول أن موته كان بسبب مفاجئ دائمًا، كحادثة طائرة أو سيارة وأمثال ذلك. بل أكثر الحالات موت الإنسان أو صحة الإنسان أو طول عمر الإنسان يرتبط بأحداث سابقة على هذه السنة وعلى هذه الليلة.
بناءً على ذلك، الحياة تتقرر من بداية حياة الإنسان وهي سلسلة مستمرة الحلقات، والرزق هكذا، والحاجات بنفس المستوى. من جهة أخرى أن نعتبر أن هناك ساعة محددة مجهولة قد تنكشف لبعض الناس ولا تنكشف للبعض الآخر من دون رعاية اللياقات أمر لا يتناسب مع العدل الإلهي.
ومن جهة ثالثة، نحن نعلم أن القرآن يؤكد على قضية الأسباب والمسببات وقضية التقدير: ﴿قد جعل الله لكل شيءٍ قدرًا﴾ [الطلاق، 3]. وهذه المعاني بعيدة كلّ البعد من أن يكون هناك للإنسان ساعة مجهولة يفتش عنها قد يعثر عليها فيصل إلى ما يبتغي في حياته. وعلى كلّ حال دون أن ننكر هذا الأمر نرد علمه إلى أهله ونفتش عما نفهم من معاني ليلة القدر. ليلة القدر في مفهومها القرآني تبدو بوضوح من هذه السور وهذه الآيات التي تلوناها، نعود إلى تلاوة الآية مرة أخرى.
﴿إنا أنزلناه﴾ أيّ القرآن ﴿في ليلةٍ مباركةٍ﴾ يضيف القرآن الكريم ﴿إنا كنا منذرين﴾ عندما أنزلنا القرآن في هذه الليلة كنا في حالة الإنذار، وحالة الإنذار والتبشير هما حالتا التشريع، يعني القرآن يقول نحن كنا بصدد إنذار البشر وتربية البشر وتشريع الأحكام للبشر فأنزلنا القرآن الكريم في هذه الليلة.
إذًا، لم نكن بصدد الخلق كما كنا في أول الخلق، كيفية خلق الأرض والسماء وما بينهما. لم نكن بصدد خلق الإنسان، لم نكن بصدد إبداء المعجزات بل كنا بصدد التشريع والإنذار والتبشير. إذًا، ليلة ربنا جل وعلا أنزل القرآن وكان في موقع الإنذار والتشريع أيّ في موقع إنزال الاحكام الإسلامية والدينية فقط.
نتابع قراءة السورة عندما توضح معنى ليلة القدر فتقول: ﴿فيها﴾ أيّ في هذه الليلة ﴿يفرق كل أمرٍ حكيمٍ﴾، يميز ويبين، يفرق ويوضح جميع الأمور المحكمة الثابتة والأمور المحكمة نوعان: أمور خلقية تكوينية وأمور شرعية تشريعية توضح السورة بأن الأمر الحكيم الذي يفرق في هذه الليلة الأمر الشرعي.
في الآية الخامسة: ﴿أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين﴾، عندما كنا في مقام الإرسال والرسالة والدعوة لا في مقام الخلق والتقدير والإعجاز أوضحنا كلّ أمرٍ حكيم. تأكيد لما فهمناه من معنى كلمة ﴿إنا كنا منذرين﴾، نتابع القراءة: ﴿رحمةً من ربك﴾، لا شك أن الله عندما يفرق عندما يوضح كلّ أمر حكيم إنما بصدد الرحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي جعل الرسول والدين والقرآن رحمة للعالمين. وهنا أيضًا نقطة تلقي أضواءً كاشفة على معنى ليلة القدر عندما تربط السورة بين كلمة الرحمة وبين كلمة الرب؛ أيّ هذه الأعمال والإيضاحات والفرق بين الأمور الحقيقية والأمور الباطلة كانت رحمة من ربك. كان الله في مقام التربية ومقام بناء الذات الإنسانية لا في مقام الخلق: ﴿إنه هو السميع العليم﴾، هذا الرب الذي ليس ربك فحسب بل هو: ﴿رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين * لا إله إلّا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين﴾.
إذًا، إن الله هو ربك يا رسول الله ورب السماوات والأرض ورب ما بين السماوات والأرض من إنسان وبشر ومن موجودات وطيور وحيوانات وكلّ شيء مخلوق، وهو ﴿ربكم ورب آبائكم الأولين﴾.
إذًا، الله الذي ربى الإنسان وجعل لكلّ شخص قدرًا، ولكلّ شيء قدرًا، وحدد العلاقات بين الإنسان وبين الموجودات، بين الإنسان وبين أخيه الإنسان، بين الإنسان وبين نفسه... هذه العلاقات التي يُعبَّر عنها بالأفعال والممارسات حددها الله سبحانه وتعالى رحمة من عنده في هذه الليلة فجعل الفرق بين الأمور وجعل من الأمور صحيحة وواجبة ومحرمة وحسنة وسيئة وباطلة وصحيحة. بناءً على ذلك نستفيد من مجموعة هذه الآيات أن ليلة القدر أيّ ليلة تقدير الأحكام وتحديد الحقائق والعلاقات التي تربط بين الإنسان وبين ما حول الإنسان، بمعنى أن الإنسان في حياته عندما يجد العلاقات، فيريد أن ينظم هذه العلاقات بينه وبين الآخرين، وبينه وبين الموجودات يحتاج إلى رحمة من الله لتحدد له صوابية هذه الممارسات، يجب عليه أن يعمل، ويجب عليه ألّا يعمل. ويختار هو بين العمل وبين الترك في بعض الأمور، هذه الأمور تتحدد من خلال القرآن الكريم الذي يحدد طريق الخير والشر والنور والظلام ويوضح للإنسان كلّ إنسان بما يجب أن يعمل في خلال حياته لكي يكون منسجمًا مع رسالته، مع خلقه، مع وجوده، ومع حياته، إذًا، معنى القدر يعني ليلة نزول القرآن.
أما ما ورد في الحديث الشريف من أن ليلة القدر باقية في أمة الرسول إلى الأبد، فعلى ضوء ما فهمنا من القرآن الكريم، نفهم أن ليلة القدر باقية بذكراها. ومعنى ذلك أن الإنسان عندما يحتفل بذكرى ليلة القدر كما نحتفل بهذه الذكرى هذه الليلة إنما يستعرض القرآن الكريم ساعة نزوله وتأثير هذا القرآن على الحياة الإنسانية، وأن هذا القرآن فرّق ما قبل حياة الإنسان، ما قبل هذه الليلة، وحياة الإنسان ما بعد هذه الليلة، لأنه جعل مقاييس ومقادير وأوضح جميع الأمور الحقيقية الصحيحة من الأمور الباطلة. نحتفل بهذه الليلة لكي نجعل منها مرآة نقارن حقيقة سلامة مواقفنا –وعملنا- وعدم سلامتها.
إذًا، نحتفل بالذكرى لكي نحاسب أنفسنا وندرك مدى صوابية موقفنا أو عدم صوابيته، فالليلة باقية في الأمة بدايةً لأجل تحديد الأمور واستمرارًا لأجل تصحيح الأمور وتأكيد المقارنة. ولا شك أن هذه الليلة أفضل من ألف شهر كما تؤكد ذلك سورة ﴿إنا أنزلناه﴾ لأن ألف شهر التي حاول أعداء الرسول أن يشوهوا الإسلام لم يتمكنوا خلالها من أن يؤثروا في التاريخ فيمحون أثر هذه الليلة المباركة التي بقيت على طول الدهر. فالمقارنة بين هذه الليلة وبين ألف شهر في سورة ﴿إنا أنزلناه﴾ أيضًا تأكيد على أهمية هذه الليلة وتأثيرها على تاريخ الإنسانية، وهنا كانت التعزية الكبرى للرسول عندما وجد في وحيه، في حلمه، في انتباهاته الغيبية أن أعداء الإسلام يسيطرون على خلافته فيحاولون تحويل الإسلام عن مجراه الصحيح فحزن فنزلت سورة: ﴿إنا أنزلناه﴾ فأكد له عدم تمكنهم من هذا التشويه. فأثر ليلة الرسول هذه أكثر بكثير من أثر ألف شهر وآلاف من الأشهر التي يحكم فيها الأعداء على هذه الأمة، فالأمة باقية والخط باقٍ، والقرآن باقٍ دون تحريف ولا تشويه مدى الدهر، ولا يتمكن المحرفون والمأولون والأعداء أن يؤثروا على مصير هذه الأمة. قد تصاب الأمة بنكسات ولكنها بفضل القرآن والاحتفال بليلة القدر والمقارنة، تعود إلى رشدها في أول ساعة ممكنة.
هذا هو المعنى الأول وهو المعنى القرآني من مفهوم ليلة القدر. وهناك معنى آخر يستفاد أيضًا من القرآن ومن الأحاديث الشريفة لليلة القدر نذكره حتمًا هنا بعد هذه المرحلة وبعد هذه الفترة من دراسة آية القرآن الكريم.
أما المعنى الثاني من معاني ليلة القدر يعتمد على كلمة -القدر، فالقدر كما نعرف تحديد، في المعنى الأول اعتبرنا أنه تحديد شرعي للأمور، ولكن في المعنى الثاني لمعنى التقدير يعني التحديد الكوني والتحديد الفعلي لحياة الإنسان بمعنى أن ليلة القدر ليلة تقرير المصير للإنسان.
فالإنسان في هذه الليلة يتمكن من أن يرسم مستقبله، وهذا المعنى أيضًا يمكن استفادته من القرآن ومن المفاهيم الإسلامية لا بالمعنى الاتكالي الذي يشيع بين الناس في هذه الأيام ذلك لأن القرآن الكريم يؤكد أن السعادة والشقاء للإنسان مرتبطان بإرادة الإنسان وبسعي الإنسان وبجهد الإنسان على صعيد فردي وعلى صعيد جماعي. مثلًا عندما نعود إلى سورة الشمس فنرى بعض التأكيدات الواردة بلسان القسم ﴿والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها * والنهار إذا جلاها﴾ [الشمس، 1-3]، نصل إلى النتيجة ﴿ونفسٍ وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها﴾ [الشمس، 7-8]، نتيجة كلّ هذه الأيامين هذه الجملة: ﴿قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها﴾ [الشمس، 9-10]، إذًا، تزكية النفس، من يزكي نفسه هو السعيد ومن لا يسعى في ذلك ويسيء التصرف ويمارس ما لا يتناسب مع تزكية النفس هو الذي يشقى.
إذًا، القرآن يؤكد هذا المبدأ أن مصير الإنسان مرتبط بإرادة الإنسان عندما تتوجه هذه الإرادة بتزكية النفس، ومن جهة أخرى شهر رمضان، شهر الصيام، والصيام كما نعلم له آثار عديدة على ذات الفرد ونفس الفرد وتزكية الفرد، بالنتيجة، لأن الإنسان الصائم عندما يشعر بالجوع والعطش والحاجات الأخرى في النهار فلا يمشي وراء حاجته، لا يشرب ولا يأكل ولا يمارس ما يرغب... يتمكن من أن يتحرر من سيطرة رغباته على نفسه، وهكذا وبعد التدريب على ذلك يتمكن أن يتغلب على هذه الحاجات المادية في أفق أوسع وفي مجالات أرحب؛ تمامًا كما نعلِّم الطفل السباحة في بركة صغيرة فيتهيأ إلى أن يسبح في أماكن واسعة كالبحر. فإذا نحن تدربنا خلال هذا الشهر المبارك في ساعات النهار فامتنعنا عن ممارسة بعض الحاجات، نتمكن من أن ننتقل إلى جو التغلب على الحاجات المادية، فنتحرر من الحاجات التي هي تقلل وتصغر إمكانات الإنسان وتمنع من تحرر الإنسان في الحياة، على ذلك الصيام يكوِّن للإنسان إرادة حرة قوية.
ومن جهة أخرى، عندما يمتنع الإنسان عن ممارسة حاجته يلمس الحاجة ومرارتها يلمس في نفسه ويلمس في عياله وأولاده مرارة الحاجة، عند ذلك يدرك مرارة حاجة إخوانه أبناء وطنه، أبناء أمته وبذلك ينكشف من أمام عينه ما يحيط به من ظروفه الخاصة، ولا شك أن إدراك الإنسان لآلام أمته ولحرمان أمته ولحاجات وطنه يساعده في تقرير المصير.
ومن جهة ثالثة، فالصيام بما فيه من التمرد على الحاجات المادية يقرب الإنسان من الإدراك الروحي وهذا تمامًا ما يفهم من الآيات القرآنية التي تربط بين شهر رمضان وبين نزول القرآن لأن هناك ربطًا عميقًا بين الصيام وبين الإدراك السامي للحقائق السامية، فالقرآن نزل في شهر رمضان، والصائم يتلو من القرآن ويدرك معاني القرآن.
وهكذا نجد أن العناصر الثلاثة للنجاح وهي:
الإرادة الحرة غير المرتبطة بالمصالح الذاتية والحاجات الشخصية من جهة،
العنصر الثاني إدراك آلام الأمة،
والعنصر الثالث الوعي والاستيعاب والانفتاح العقلي أمام الحقائق.
عناصر لكي يتمكن الإنسان من أن يرسم خطة مستقبله، فبذلك يتمكن الإنسان في ليلة قدره من أن يرسم مستقبله، فيسعد نفسه وأمته أو أن يكوِّن لنفسه ولأمته الشقاء. وبذلك نجد أن ليلة القدر بالنسبة إلى كلّ إنسان تختلف عن ليلة القدر بالنسبة إلى الغير.
لا شك أن في أواخر رمضان عندما يستفيد الإنسان من هذا التدريب، من هذا التحضير للامتحانات يستفيد فيصل إلى درجة من القوة والوعي وإدراك الأمور بإمكانه أن يقرر المصير.
إذًا، الإنسان في أواخر شهر رمضان يبلغ هذه الدرجة من النجاح وإمكانية تزكية النفس التي هي سبيل لسعادته وسعادة أمته. أيّ يوم، أيّ ليلة يختلف كلّ إنسان قد يكون الإنسان يصل في ليلة الواحد والعشرين أو الثالث والعشرين أو السابع والعشرين إلى هذه الدرجة، أو في نهار بعض هذه الأيام، وهذا سبب الخلاف في معنى ليلة القدر والخلاف في تحديد وقت ليلة القدر والمتفق عليه غالبًا أنه في العشر الأخير من شهر رمضان.
وبمناسبة هذا المعنى بإمكاننا أن نكتشف معنى آخر قريب لهذا المعنى، نكتشف من الآيات الواردة في شهر رمضان عندما نتلو تلك الآيات نجد أن آية الدعاء واردة ضمن آيات الصيام، آية: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيب دعوة الداع﴾ [البقرة، 186]. إذًا، الإنسان في مناسبة شهر رمضان ومناسبة الصيام بإمكانه أن يدعو، ودعوته تستجاب، والروايات كثيرة في التأكيد على أن الدعاء في شهر رمضان مستجاب. وبذلك نجد أن شروط استجابة الدعاء تزكية النفس، التمرد على الحاجات، قطع العلاقات المادية مع الأرض وما في الأرض، المعراج، إدراك هموم الآخرين، انفتاح قلبي وعقلي على المعاني السامية، هذه الأمور تجعل الإنسان في معراج يقترب فيه إلى درجة الاستجابة فيدعو فيلبى، وبذلك بإمكاننا أن نعتبر أن هذه المناسبة بعد فترة من الصيام تمكن الإنسان من الدعوات الصالحة، وبالتالي من استجابة دعائه الاستجابة التي تؤثر في مصير الإنسان وفي حياة الإنسان.
هكذا نصل إلى معاني ليلة القدر، المعاني التي يمكن استفادتها من القرآن ومن السنة والأمر في الواقع يعود إلى أهله، ونحن نبذل جهدنا لكي ندرك ونستوعب ما نفهم، فإن أصبنا نشكر الله على ذلك، وإن أخطأنا نستغفر الله ونطلب من الله الهداية، ولو كانت عن طريق تذكير الإخوان المستمعين والأصدقاء المهتمين بهذه المعاني على أن يناقشوا ويبحثوا ويطرحوا معانٍ بديلة لما نقولها في هذه الليالي المباركة ويكون ذلك أيضًا قدر لنا وتقدير سعيد لنا.
ثم تتابع السورة المباركة في معانٍ عظيمة فتنقل الأحداث والنتائج التي حصلت نتيجة أعمال الإنسان في ماضيه وفي تاريخه، فتتحدث عن الملحدين وعن الشاكين وعن فرعون الذي طغى في الأرض واضطهد بني إسرائيل وحاول أن ينهيهم ولكن الله أبى ذلك وأعطاهم فرصة أخرى، تلك الفرصة التي تتضح بوضوح من هذه الآية عندما تقول: ﴿وآتيناهم﴾ - أي بني إسرائيل الذين أنجيناهم من فرعون- ﴿وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبينٌ﴾ [الدخان، 33]، فإذًا، ربنا يختبرهم بما يمكنهم من الفرصة فإذا استفادوا من هذه الفرصة يعيشون حياة سعيدة خالدة، وإلّا فهم الأخسرون.
ومن الآيات التي تلفت النظر وعلينا أن نتلوها لكي نستفيد من هديها بعد أن يؤكد غرق فرعون وجنوده الذين حاولوا أن يلحقوا الأذى بموسى وبني قومه يقول: ﴿كم تركوا من جناتٍ وعيونٍ * وزروعٍ ومقامٍ كريمٍ * ونعمةٍ كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قومًا آخرين * فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين﴾ [الدخان، 25-29]. والحقيقة أن هذه الآيات مليئة بالعبر بالنسبة لأصحاب الأموال والأمجاد والإمكانات والسلطان والنفوذ بأنهم سوف يتركون مالهم من إمكانات وزروع ومقام كريم والنعم دون أن يحزن أحد أو أن تبكي السماء والأرض عليهم، وفي هذه عبرة بأن الإنسان يجب أن يخلِّد حياته من خلال الفرص التي تتوفر له في الحياة.
وتبلغ معاني السورة قمتها وهي في القمة جميعًا عند هذه الآية: ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين * ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ [الدخان، 38-39].
والواقع أن هذه الرؤية الثابتة العلمية الواضحة التي تعطيها السورة للخلق، خلق السماوات والأرض لم يكن للعب بل كان لحق يؤكد أن السماء والأرض وما بينهما وكلّ وجميع الموجودات معتمدة على الحق، ولذلك الإنسان الذي يريد أن ينجح فينسجم مع هذا الكون ويخلد في هذا الكون يجب أن يسلك سبيل الحق والعدل، لا سبيل اللعب والنفاق والهزل في حياته وإلّا فإنه يصبح جسمًا غريبًا عن حياة هذا الكون، فيُنبذ ويُهمل ويُنسى.
وهكذا هذه السورة المباركة التي أكدوا لنا قراءتها في هذه الليلة المباركة، وفي ليالي القدر توضح أمامنا طريق السير الصحيح، طريق الخلود، طريق تقرير المصير، إن طريق تقرير المصير يمر عبر الخط الواضح، خط الحق والعدل الذي نرجو أن نسلكه. ولا بد في نهاية الحديث أن نقول أن هذه الليلة تتناسب وتصادف ذكرى استشهاد الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) الذي يعبر عنه الرسول الأكرم بأنه الحق، وأنه مع الحق والحق يدور معه أينما دار، وبذلك تتمثل أمامنا حياة هذا الرجل الذي كان مرآة كاملة لإبراز الإسلام الصحيح، فسلوكه وقوله وشجاعته، وجوده وعطاؤه وخوفه وجرأته وجميع علاقاته وحبه وكرهه، كلّ هذه العلاقات كانت تعتمد على أساس من الحق والعدل والإسلام، ولهذا بإمكاننا أن نقول إن عليًا كان قدر هذه الأمة، وقدر هذه الأمة لأنه هو الذي جسد معاني الإسلام وأهداف الإسلام تجسيدًا كاملًا، والانتماء إليه بالتشابه به لا بالانتماء الجغرافي أو الانتماء العنصري إليه فهذا مرفوض في مفهوم القرآن.
نحن نتمنى أن العبر التي تمر علينا والوضع الذي وصلنا إليه في هذا العالم في هذا العصر في هذه المنطقة وفي لبنان بالذات تكون عبرة لنا لمعالجة الأمور معالجة صحيحة والالتزام بالأخلاق والقيم والمناقب التي لا يمكن للمجتمع أن ينجح، وللعلاقات الاجتماعية أن تتوثق إلا من خلالها.
إذًا، نحن نتوسل إلى القرآن الكريم، إلى شهر رمضان، إلى ليلة القدر، إلى رسول الله، إلى علي بن أبي طالب، ونطلب من الله سبحانه وتعالى وبشفاعة هذه الأمور وبهداية هذه الأمور أن يمن على لبنان فينجو من هذه المحنة وأن يمن على أبناء لبنان فيتعاطفوا ويتآخوا ويرجع بعضهم إلى بعض ويبنوا وطنهم بناءً صحيحًا سليمًا بعيدًا عن الطغيان، بعيدًا عن التفوق، بعيدًا عن النفاق فيخلقوا مستقبلًا سعيدًا ويكون شهر رمضان هذا قدر لبنان كما أراد الله أن تكون ليالي القدر قدرًا لكلّ إنسان.
وفي النهاية لا بد لنا من أن نتلو هذه الفقرة من الأدعية التي وردت في ليالي القدر عندما يقول الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن، وبحق من أنزلته به، وبحق كلّ مؤمن مدحته فيه، وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، بمحمد، بعليّ، بأوليائك الصالحين، بقرآنك، بإنسانك، بعدلك، برحمتك أن ترحمنا وترحم وطننا وأمتنا وتنقذ بلادنا وترشدنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وأن تتقبل منا هذه الأعمال، إنك أنت الرؤوف الرحيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.