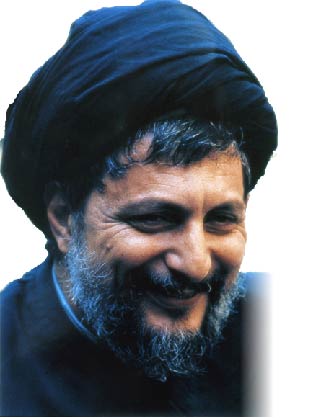* تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، (د.ت).
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وبعد،
في هذا اليوم المبارك، أحب أن أبحث معكم في موضوع نرى القرآن الكريم يحرص على ذكره في هذه الأوقات، وبمناسبة ذكر شهر رمضان. فحينما نقرأ القرآن الكريم، يبحث عن وجوب الصوم، وأن الصوم كتب عليكم ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾ [البقرة، 183]، وأنه يجب في أيام معدودات ويعيِّن الموعد شهر رمضان، ولا يكتفي بذكر شهر رمضان، بل يزيد ﴿شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن﴾ [البقرة، 185]، يريد أن يوحي إلى المستمعين، إلى الأمة، أن هناك ارتباطًا بين الصيام وبين القرآن، لأن القرآن كتاب هداية وفيه ﴿بينات من الهدى والفرقان﴾ [البقرة، 185].
ثم لعلكم تنتبهون أن في أدعية هذا الشهر بعد الصلاة، بعد كل صلاة، والدعاء النهاري والدعاء الليلي وأدعية هذا الشهر حينما يأتي لفظ شهر رمضان فورًا، يأتي بعده: ﴿الذي أُنزل فيه القرآن﴾ [البقرة، 185]. هذا مما يدل على أن في هذا الشهر عناية خاصة بالقرآن الكريم، وأن هناك ارتباطًا بين الصيام وبين الهداية والبينات المتمثلة في القرآن الكريم، ثم نرى أن قرآن النبي، قرآن الله، هذا الكتاب نزل في هذا الشهر، ونزول القرآن في هذا الشهر أيضًا مما يتطلب التفكر في هذا الأمر.
زائدًا على هذا، في أحاديثنا المأثورة، وخاصة في خطبة النبي المعروفة: "أيها الناس قد أقبل عليكم شهر الله(1)، يؤكد النبي في هذه الخطبة، وفي جميع الروايات والتعاليم المأثورة، يؤكد ويؤكد الأئمة (عليهم السلام) جميعًا على الاهتمام بالقرآن وقراءة القرآن وتلاوة آياته والتفكر في معانيه وأمثال ذلك.
هذه المعاني تستدعي البحث في القرآن الكريم في هذا الشهر، لا بد أنكم تقرأون القرآن بكثرة في هذا الشهر كما هو وارد، ولكن أحب أن أتكلم اليوم في أصل القرآن وخلاصة لحالات القرآن، ووضع القرآن.
والحقيقة أن القرآن هو أهم شيء في حياة المسلمين على أساس أن القرآن هو معجزة الرسول الباقية، لأن معجزات الرسول التي صدرت عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في أيام حياته نحن لم نشاهدها وانقطعنا عنها، ولكن القرآن معجزة باقية مستمرة بين أيدينا، ولهذا فالقرآن هو السبيل إلى النبي وإلى الإسلام وإلى الله. القرآن هو الدليل على الوصول إلى رسالة الله. ثم إن القرآن الكريم، كما سوف أتكلم في هذا اليوم، هو سبب خلود الإسلام، لو لم يكن القرآن بهذه الكيفية وبهذه اللغة، لو لم يكن القرآن بألفاظه من وحي الله لما كان الإسلام خالدًا أبدًا، خلود الإسلام بالقرآن، كما أن أصل الإسلام بالقرآن، وزائدًا على هذا وذاك فنحن حينما نرجع إلى الأخبار وإلى الآيات ونقرأ أوصاف القرآن نتعجب ونهتز ونشعر بوجوب الاهتمام بالقرآن أكثر وأكثر. فالقرآن الكريم يصف كتاب الله بأنه: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ [فصلت، 42]، وأنه: ﴿لا ريب فيه﴾ [البقرة، 2] وأنه الفرقان، أي الفارق بين الحق والباطل، وأن فيه تبيان كل شيء، يجب أن لا نمر على هذه الكلمات مرورًا عابرًا، فيه تبيان كل شيء، جميع الأشياء مبينة في القرآن الكريم.
ثم روايات وتعاليم واردة عن النبي تؤكد بصورة عجيبة اهتمامنا ولزوم اهتمامنا بالقرآن فيقول النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم): "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي... ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا"(2)، يعني وراثتنا وتركة نبينا في هذه الأمة، الوسيلة التي نحن بإمكاننا أن نرتبط بالنبي بعد وفاته هي وسيلة القرآن. على هذا الأساس نجد أنه هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يؤكد في موضع آخر ويقول: إذا التبست عليكم الفتن كغياهب الليل المدلهم فعليكم بالقرآن(3)، ويقول في كثير من أخباره وآثاره: "مَن جعله -أي مَن جعل القرآن- أمامه قاده إلى الجنة، ومَن جعله خلفه ساقه إلى النار"(4). وهكذا أخبار وآثار كثيرة ليس في هذا الوقت مجال للتحدث عن جميعها، ولكن أحب في هذا اليوم أن أتكلم بعض الشيء في القرآن حتى يكون عندنا شيء موجز من الإلمام بهذا الكتاب العزيز الذي هو عندنا بعد الله مباشرة.
القرآن الكريم، نحن نعرف النبي عن طريق القرآن، ونعرف الإمام عن طريق القرآن، ونعرف الكعبة عن طريق القرآن؛ القرآن منطلق المسلم وقاعدة الإسلام. فإذًا، بعد البحث عن الله ومعرفة الله يجب علينا أن نعرف القرآن. ما هو القرآن؟ كيف نزل؟ ما معناه؟ وكيف نتمكن أن نفهم؟ ما هي واجباتنا تجاه القرآن؟ شيء من التاريخ القرآني والآثار القرآنية ومناسبة كريمة أن نتحدث في هذا الموضوع بصورة واسعة.
فالقرآن، كما تعلمون أيها الإخوان، القرآن نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى الأمة بالتدريج حسب تعبير المفسرين، أو حسب تعبير القرآن نزل نجومًا وبأقساط في خلال 23 سنة نزل القرآن بواسطة النبي على الأمة. أول ما أُنزل من القرآن الآيات الكريمة: ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق الإنسان من علق* إقرأ وربك الأكرم* الذي علّم بالقلم* علّم الإنسان ما لم يعلم﴾ [العلق، 1-5]. وآخر آية نزلت على رسول الله حسب رأي بعض المفسرين قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا﴾ [المائدة، 3]. وعند البعض قوله تعالى: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا * فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا﴾ [النصر].
المهم أن القرآن كان ينزل على الرسول للأمة في خلال 23 سنة، يعني تاريخ رسالة الرسول بدأ القرآن ينزل من أول يوم وبدأ بالتدريج يكتمل حتى انتهى وأصبح بهذا المطلب الذي بين يدينا.
فإذًا، القرآن الذي نزل بالتدريج ما معنى قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ [القدر، 1]، لماذا القرآن يقول: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ [القدر، 1] مع أننا نعلم أن القرآن نزل على مدى سنين طويلة وما نزل في ليلة القدر دفعة واحدة.
هنا يبحث المفسرون فبعضهم يقول أن بدء نزول القرآن كان في ليلة القدر، وبعضهم يبحثون أبحاثًا أُخر. ولكن الظاهر، وخلاصة مطالعاتي من دون تفصيل ومن دون بحث ونقل للأقوال، وأنقلها بأمانة لكم:
القرآن حسب ما يظهر من الآيات القرآنية أنه نزل مرتين، المرة الأولى نزل القرآن دفعة واحدة، والمرة الثانية نزل القرآن بالتدريج في خلال 23 سنة. النزول الأول يسميه القرآن الإنزال ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ [القدر، 1]، الإنزال يعني النزول الدفعي. وأما النزول بالمعنى الثاني يعني النزول التدريجي الذي كان في خلال 23 سنة فيسميه القرآن التنزيل، نزّلنا، التنزيل يعني مجيء القرآن بالتدريج. والإنزال يعني مجيء القرآن دفعة واحدة. لماذا نقول هذه الكلمة؟ ومن أين نقول الكلمة؟ مع العلم أن الفرق بين الإنزال والتنزيل موجود في اللغة العربية، واكتشاف هذا الأمر لأحد أساتذتنا الكبار السيد الطباطبائي (حفظه الله)، في "تفسير الميزان" هو يقول هذا الفرق بين الإنزال والتنزيل، ويستند إلى إثبات ذلك إلى بعض الأمور:
أولًا، في بعض الروايات أن القرآن في ليلة القدر نزل إلى البيت المعمور، نزل إلى السماء الدنيا، نزل إلى مكان ما، مبهمة عبارة الرواية. والنزول التدريجي كان يأتي إلى الناس ويبين للناس. كيف عرفنا مرحلتين من النزول القرآني؟
نجد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض الأماكن كان يعرف الآيات، ولكن لم يكن مأمورًا بالقول والإلقاء للناس، مثلًا القرآن الكريم يشير ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾ [طه، 114]، ﴿إن علينا جمعه وقرآنه* فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه* ثم إنّ علينا بيانه﴾ [القيامة، 17-19].
هذه الآية تبين أن النبي كان يعرف هذه الآيات، ولكن الله ينهاه من أن يستعجل ويعبر ويبين الآيات قبل الأمر؛ فكأنما كان القرآن موجودًا في صدر النبي وفي قلب النبي وفي عقل النبي، ولكن ما كان مكلفًا بالقول وبالإلقاء وبالبيان إلا حسب الأمر لأنه ﴿ما ينطق عن الهوى﴾ [النجم، 3].
فإذًا، من هذه الآية وآيات ثانية معروفة يتبين بوضوح أن النبي قبل إصدار الأمر بالتبليغ كان يعرف الآيات القرآنية، أو المحكمات من الآيات القرآنية، وهكذا نرى أن في بعض الأمور كان النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) حينما يُسأل كان ينتظر الوحي وما كان يكلف، ويجيب عن الأسئلة حتى ولو كان يعرف ذلك، وهذا واضح في سيرة النبي الكريم.
فإذًا، بإمكاننا أن نقول أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حينما بلغ عمره 40 سنة، وصار أول الوحي، وصار إلى مقام الأنبياء، وبلغ مقام النبوة، اتصل قلبه بالوحي الإلهي، فنزل القرآن في قلبه جملة وبصورة مجملة مجتمعة، بلغ مقام النبوة ثم بدأت الآيات تنزل بالتفصيل، أو كان النبي يُكلَّف من قِبل الله بقراءة الآيات بالتفصيل.
أمرُّ من هذه النقطة التي هي نقطة علمية مع ذكر هذه الكلمة أن في تعاليمنا أنه أول مرحلة نزول القرآن بصورة دفعية في شهر رمضان وفي ليلة القدر، ولكن أول آية نزلت على النبي (عليه الصلاة والسلام) ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ [العلق، 1] كانت في يوم المبعث 27 رجب، المبعث الذي نحتفل به، وهنا يسمى المعراج والإسراء، والحقيقة أنه مع المعراج وذكريات الإسراء مبعث، يعني أول استماع النبي للوحي التنزيلي والتفصيلي الذي نزل فيه: ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ [العلق، 1]. نمر من هذه النقطة بعد ذكر هذه الكلمة. فكانت الآيات تنزل وتُنزَّل بالتدريج، وكان الأصحاب يجمعون هذه الآيات في صدورهم وقلوبهم ويكتبونها، كتَّاب الوحي طبعًا، ويكتبونها على الأوراق؛ والورق في القديم كان نادرًا أو مفقودًا فكانوا يكتبون على الرق، على الخشبة، اللوحة، أكتاف الإبل، يكتبون الآيات على هذه الأشياء فيحتفظون بها.
وأما كيف كانوا يجمعون هذه الآيات؟ هل كان جمعهم لهذه الآيات بصورة عفوية؟ لا. يظهر من بعض الروايات أن جبريل (عليه السلام)، أمين الوحي، حينما كان ينقل الوحي للنبي كان يذكّره قائلًا: ضع هذه الآية بعد الآية الفلانية وقبل الآية الفلانية؛ يعيّن مكان الآية أيضًا، ولهذا نحن نعتقد أن القرآن الكريم ما زاد فيه كلمة ولا نقص منه كلمة، ولا حتى الترتيب، يعني هذا الترتيب الموجود. صحيح أن أول آية نزلت ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ [العلق، 1] الآن هي في آخر القرآن، ولكن وُضِعت في آخر القرآن بأمر من الله صاحب الكتاب وصاحب الوحي هو الذي أوعز أن تكون هذه الآيات في هذه الأماكن.
فإذًا، القرآن ما أتاه الباطل و﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ [فصلت، 42]، وقد وعد الله تعالى النبي والأمة ﴿إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ [الحجر، 9] هو حفظ هذا القرآن الكريم. وأما جمع القرآن الكريم فكانت الآيات مجتمعة، وكان مئات من الصحابة يحفظون القرآن فانجمع القرآن في أيام الخليفة الأول، ثم في أيام الخليفة الثاني، ثم في أيام الخليفة الثالث، جمعوا القرآن ووضعوه في أربع أو سبع نسخ، ووزعوه على أقطار العالم الإسلامي من دون زيادة ولا نقيصة ولا تحريف حرف. الأمر لم يكن سهلًا حتى يغيروا ويبدلوا وأمام أصحاب النبي وأمام عليّ (عليه السلام)، لا يمكن تحريف ولا تبديل. ونحن نقرأ في التاريخ أن يومًا من الأيام كان الخليفة عمر بن الخطاب على المنبر فقرأ الآية الكريمة: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾ [التوبة، 100] قرأ هذه الآية بإسقاط "واو" فقط، يعني قرأ الآية بهذا الشكل: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان"؛ محل ﴿والذين اتبعوهم بإحسان﴾ قال: "الذين اتبعوهم بإحسان"، قام إعرابي من وسط الناس قال له: ﴿والذين اتبعوهم بإحسان﴾ صَحِّحْ الغلطة. فتراجع الخليفة لأنه كان مخطئًا بهذا التعبير فقال: ﴿والذين اتبعوهم بإحسان﴾، ما تركه الرجل، أخرج الخنجر وقال: "أقم وإلا أقمناك بهذا المعوج". القرآن لا يمكن التلاعب فيه لا زيادة "واو" ولا نقيصة "واو"، يجب أن يُحتفظ به، وهكذا احتفظوا بالقرآن.
وأما ما ورد أن ابن مسعود مثلًا كان يقرأ: ﴿يا أيها الرسول بلّغ ما أُنزل إليك﴾ [المائدة، 67] كانت في حق عليّ مثلًا، أما ما ورد أن مصحف عليّ الذي كان يجمعه الإمام بعد وفاة رسول الله كان فيه أشياء وأشياء، وما ورد من الروايات الواردة في أن القرآن قد نقص منه أو زاد فيه وأمثال ذلك، فهذا على نوعين:
نوع هو من دس الإسرائيليين –حسب تعبير فقهائنا– الذين بخلوا وحسدوا وتآمروا على الإسلام، فدسوا أحاديث في كتب أحاديثنا تدعو وتقول بتحريف القرآن ونقص القرآن.
وقسم آخر من الأحاديث في الحقيقة أن ﴿بلّغ ما أُنزل إليك﴾ [المائدة، 67] كانت في حق عليّ ليست من القرآن، وإنما كانت تفسيرًا للقرآن، شأن النزول، مورد النزول، توضيحات، تعليقات، هذه الأشياء كان الإمام جامعها مع القرآن كتفسير للقرآن، كتاريخ للقرآن، وكان موجودًا عنده، وهذا هو السبب، وهذه الثروة الكبرى التي كانت للمسلمين ومع الأسف ما استفادوا منها وبقيت هذه الثروة مخزونة عند آل البيت (سلام الله عليهم).
فإذًا، القرآن كتاب الله ما زاد ولا نقص، احتفظت الأمة به وبقي، والله كما نزله هو حافظ له. هذا أصل الموضوع. وأحب أن أذكر هنا بعض النقاط:
قلنا أن القرآن هو سند صدق النبي، المعجزة الباقية، كيف عرفنا أن القرآن هو المعجزة الباقية؟ وكيف نفهم من طرف القرآن أن النبي كان رسولًا من قِبل الله تعالى؟ هذا له عدة وجوه وعدة أدلة ليس لنا مجال للتفصيل وللبحث، وإنما أذكر بعض النقاط:
أولًا، كما تعلمون أن القرآن الكريم جاء وكان النبي بين أمة كانوا فصحاء بلغاء، يعتزون بالفصاحة والبلاغة، ويعرفون شؤون الفصاحة والبلاغة بكل اهتمام وبكل دقة. وكانوا يعلقون الأشعار الفاخرة الممتازة على حيطان الكعبة. وكان لهم سوق عكاظ يستمعون إلى الشعر كما يشترون البضائع، وكان فصحاء العرب معروفين بين الناس. فالعرب قبل الإسلام كان من ميزتهم أن كل فرد منهم كان نقادًا للأدب والشعر والفصاحة. بين هذه الأمة جاء القرآن، ولا شك أنه صوت جديد، فزعلوا وحاربوا وتعقدوا ووقفوا معارضين... كبار العرب في أول الإسلام، ما كانوا يريدون أن يقبلوا الإسلام طبعًا، لأن الإسلام بزعمهم يسفه أحلامهم، ويهين آلهتهم، ويغير مذهبهم، ويفرق بينهم. كانوا غير راضين من الاعتناق وقبول الإسلام، فوقفوا موقف المعارض.
طيب، النبي جاء وجاء بالقرآن وأمامه تقريبًا كل العرب معارضين، ثم قال لهم بتحدٍّ: أنه أنتم لا تصدقونني فأتوا بمثله. (جيبوا) قرآنًا مثل قرآني حتى تردوا عليّ. لا تشتموا، لا تسبوا، لا تتآمروا... من دون هذه المشقات أنا أقول لكم أن هذا كتاب الله، لا تصدقوني (جيبوا) كتابًا مثله، أنتم الفصحاء، أنتم البلغاء، بينكم الأفاضل والشعراء (جيبوا) مثل القرآن، ثم عاد وزاد في التحدي وقال: ﴿فأتوا بعشر سور﴾ [هود، 13]. (ما بدي تجيبوا) كل القرآن (جيبوا) عشر سور حتى أنا أقبل، حتى أتراجع، ثم زاد في التحدي فقال: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ [البقرة، 23] سورة واحدة: ﴿قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفؤًا أحد﴾ [الإخلاص] (جيبوا) ثلاث آيات وخلّصوا أنفسكم مني، إذا بإمكانكم أن تأتوا بسورة من سور القرآن حينئذٍ أنا أتراجع وأسكت وأنتم تتغلبون عليّ.
تصور أن هناك خصمين، خصم وقف وحده يتحدى، والخصم الثاني جماعة زعلانين يرتكبون كل شيء، مستعدين أن يبذلوا الغالي والرخيص في سبيل إسكات محمد، يصرفون الأموال ويبذلون الجهود ويقدمون العروض تلو العروض لإسكات النبي، والرجل لا يسكت. وفي هذا الوقت يتحداهم، يقول: الحكم بيني وبينكم شرط سكوتي، إذا تريدون أن أسكت لستم بحاجة أن تعطوني إمارة الكعبة ومكة كما تقولون، ولا أريد أن تعطوني أموالًا حتى أكون أغنى منكم، ولا أريد أن تعطوني جاهًا ولا مالًا ولا نساء ولا أي شيء، (جيبوا) سورة واحدة، سورة مؤلفة من ثلاث آيات: ﴿والعصر* إن الإنسان لفي خسر* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصَوا بالحق وتواصَوا بالصبر﴾ [العصر]، (جيبوا) آية مختصرة، (جيبوا) ثلاث آيات، أنا أسكت.
أنظر التحدي، تحدٍّ يثير شعور الخصم ويحرك جميع غرائزهم ويجندهم ويقول لهم لو ﴿اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله﴾ [الإسراء، 88]، التحدي وراء التحدي، يثيرهم. طيب، هل يا ترى القرآن ليس عربيًا؟ عربي. هل القرآن يتكون من حروف غير ألف وباء وجيم ودال وحاء وذال وزاي أليست هذه الكلمات؟ هذه الكلمات هل هي مخصوصة بمحمد؟ هي موجودة بيد كل فرد من أفراد الناس، وكل عربي حينما يتكلم يستعمل هذه الحروف، الحروف الهجائية.
فإذًا، هذا التحدي دليل على أنه لو كان بإمكانهم أن يأتوا بآية واحدة، كانوا يأتون والقضية ما كانت فوضى، لأنه لو كانوا يأتون بآية كانت الآية تُقرأ وكان الناس يحكمون، ولهذا بعضهم حاول أن يأتي ببعض الآيات، بمجرد ما قرأ صار الناس يضحكون عليه ويصفرون له ويهزأون به فكان ينسحب من الموضوع.
فإذًا، التحدي وعجز العرب أن يأتوا بمثل القرآن، دليل على أن هذا الكلام ليس مثل سائر الكلمات، كلام الله، وحتى ليس كلام محمد، هو يقول أنا أمّيّ: ﴿قد لبثت فيكم عمرًا﴾ [يونس، 16]، 40 سنة كنت معكم، كنت أحكي مثل هذه الكلمات؟ هل سمعتم مني نوعًا أو لونًا من هذا الحديث أو مثل هذه الكلمة أو اللون؟ لستم سامعين مني. فإذًا، الكلام ليس كلامي هو كلام الله.
وهكذا نصل إلى مفهوم الإعجاز في القرآن الكريم. والإعجاز لا ينتهي عند عصر النبي، التحدي باقٍ على طول التاريخ. الآن، بعد النبي ألا يوجد عرب؟ ألا يوجد فصحاء وأدباء وبلغاء؟ كلهم مسلمون؟ لا. هناك أنواع وأقسام من الأديان والمذاهب بين العرب وتحدي القرآن لا يزال موجودًا، لا يزال القرآن يقول: ﴿لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله﴾ [الإسراء، 88]. أيها الفصحاء، أيها الشعراء، أيها البلغاء من المسلمين ومن غير المسلمين إذا تريدون أن تكذبوا الإسلام وتكذبوا القرآن لا تُتعبوا حالكم، (جيبوا) سورة واحدة يكفي، لا نجد. هذا دليل على أن هذا الكتاب من جنس آخر، نسيج وحده، ليس مثله شيء ولا يتمكن أحد أن يأتي بمثله.
ثم بعد هذا الجانب الفصاحي البلاغي يوجد هناك جوانب ثانية، فالقرآن يخبر عن الغيب: ﴿غُلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غَلَبهم سيغلبون* في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون﴾ [الروم، 2-4]. هذه الآية نزلت في مكة حينما غلب الفرس الملحدون، غلبوا الروم المسيحيين المؤمنين. كفار قريش في مكة استأنسوا، لأنهم كانوا يرَون أنفسهم مرتبطين بالملحدين، وكانوا يعتبرون المسلمين مرتبطين بالمسيحيين لأنهم مؤمنون بالله. فالقرآن الكريم يقول: ﴿غُلبت الروم * في أدنى الأرض﴾ [الروم، 2-3]، صحيح أن الفرس غلبوا الروم في الشام، في أدنى الأرض، ولكنهم ﴿من بعد غَلَبهم سيغلبون* في بضع سنين﴾ [الروم، 3-4] ، أقل من تسع سنوات سوف يغلب الروم الفرس، وهكذا صار.
الآية كانت موجودة بيد الناس ومعروضة على أذهان الناس، وكان العالم ينتظر وقوع هذه المعجزة التي أخبر عنها القرآن الكريم، وبالفعل صار، وتمكن الروم أن يدخلوا ويحتلوا عاصمة الفرس "المدائن" ودخلوا في قصور الملوك بالخيل وربطوا خيولهم في قصور الملوك ﴿ويومئذ يفرح المؤمنون﴾ [الروم، 4]. إخبار بالغيب.
ثم إذا نريد أن نستعرض المعجزات الواردة في الآيات القرآنية، وأن ليس فيها أي شيء يتنافى مع العلم الحديث، بل تنطبق آراء القرآن واكتشافات القرآن على أحدث النظريات العلمية التي كانت مخفية في أيام الرسول الأكرم، نخضع ونذعن لإعجاز القرآن. فترى القرآن الكريم في باب الهيئة والفلكيات لا يتأثر أبدًا بالهيئة "البطليموسية" وبحركة الشمس حول الأرض، لا يعترف بهذا وإنما يقول ما يعترف به العلم الحديث. وفي حقل العلوم والأفلاك والصناعات وعلم الاجتماع، وهذا بحث طويل بحاجة إلى وقت آخر للتحدث فيه.
أذكر لكم مثالًا تاريخيًا يتناسب مع كسل الصائمين، حتى أُرجِّع إقبالكم على الحديث وندخل في النتيجة التربوية من هذا البحث الطويل.
في سورة يوسف (عليه السلام) ترى أن القرآن الكريم يقول ويعبر عن حاكم مصر بالعزيز، قال العزيز، امرأة العزيز، كلمة العزيز. هنا تساؤل أن القرآن الكريم لماذا يعبّر عن فرعون مصر أو ملك مصر بكلمة العزيز؟ أما تقول ملك، أو تقول فرعون كما كانوا يسمون أنفسهم، ما السبب؟ لا أحد كان يعرف. لماذا؟ لأن حضارة الفراعنة اندملت تحت الرمال قبل النبي بألف سنة، وبقيت الحضارة الفرعونية مختبئة ومختفية تحت الرمال بعد النبي أيضًا بألف سنة، لم يكن أحد يعرف عن الفراعنة شيئًا إلا ما ورد عن طريق التوراة أو عن طريق بعض الأساطير المنقولة من شخص إلى شخص. وما كان أحد يعرف ماذا جرى في التاريخ الفرعوني القديم. بعد ألف سنة من قول هذه الكلمة "العزيز"، جاء رجل مستشرق وتمكن أن يقرأ الخطوط المصرية القديمة، الخطوط الهيروغليفية ثم تمكن أن يكتشف الأهرام ودخل في الأهرام، ثم تمكن من أن يكتشف، لأن المفتاح صار بيده، اكتشف قبور الفراعنة القدامى واكتشفوا أجساد الفراعنة المحنطة التي هي موجودة اليوم في متحف في القاهرة، وبعد هذا تبين من الآثار تاريخ الفراعنة بصورة تفصيلية، وعرفوا أن هذا الشخص الملك المعاصر ليوسف (عليه السلام) هذا الرجل غيَّر دين آبائه وآمن بإله الشمس وسمى نفسه قوطيفار، يعني عزيز إله الشمس. نعم جاء القرآن الذي لا يعترف بإله الشمس فحذف المضاف إليه ووضع كلمة "ال" محل المضاف إليه بالتعبير العربي وقال "العزيز". وهنا نصل إلى أن القرآن الذي كان زمانه منقطعًا عن تاريخ الفراعنة عرف شيئًا ما عرفه الإنسان قبله بألف سنة وبعده بألف سنة.
هل هذا شيء فكري حتى نبوغ محمد يكتشفه؟ لا يمكن إلا أن يكون من وحي الله، ومن عناية الله.
موضوع ثانٍ، أجساد الفراعنة اكتُشِفَت، ووجدوا أن جميع الفراعنة موجودون، يعني ليس هنالك فرعون غريق، أين الفرعون الغريق. يا إخوان، أيها المؤمنون؟ وفرعون موسى غرق في البحر الأحمر، في بحر قلزم أليس كذلك؟ كيف الأجساد موجودة؟ هذا الأب، وهذا جده، وهذا جده كلهم موجودون، ما الذي صار؟ التوراة تقف، ترجع للقرآن الكريم فترى الآية الكريمة: ﴿فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية﴾ [يونس، 92] يعني القرآن الكريم يعرف عن طريق الوحي وعن طريق الله أن جسد فرعون خرج وما غرق، ولهذا موجود. وهكذا نرى أن في القرآن في الأمور العلمية والاجتماعية والتاريخية والفلسفية والثقافية في جميع الحقول، بإمكانك أن تكتشف ما يتجاوز طاقة البشر وتفكير الإنسان، فالقرآن معجزة، معجزة خالدة.
ولكن هنا بحث أهم من هذا البحث يعتمد على كون القرآن بلغة الوحي باللغة العربية، فكون القرآن في زماننا هذا باللغة العربية، يعني باللغة التي نزل القرآن عليها وبها، ماذا يُفْهم من هذه الكلمات؟ نفهم من أن هذه الآيات بألفاظها من قِبل الله تعالى، هذا مهم جدًا. هذا هو خلود الإسلام، يعني أنت حينما تسمع القرآن تسمع كلام الله دون وساطة. فإذًا، أنت في كل عصر وفي كل زمان وفي كل قرن تسمع كلمة الله للاهتداء والهداية. بخلاف سائر الكتب، سائر الكتب المقدسة ليست بلغة الوحي وإنما هي لغة حسب تعبيرهم "الكتاب المقدّس"، الذين كتبوا التوراة والإنجيل نقلًا. والآن إذا نحن ترجمنا القرآن بلغة أخرى أو فسرنا القرآن باللغة العربية سوف تكون نفس المشكلة، طبعًا نحن نفسر القرآن، لكن لا نقول أن التفسير هو القرآن، التفسير شيء والقرآن شيء.
التفسير هو كلمتي أنا، يعني أنا أفهم القرآن وأفسر أو أترجم، هذا الذي أفسره وأترجمه هذا كلمتي أنا، ليست كلمة الله. بينما القرآن كلمة الله ليس كلمة محمد. هذا السبب في أن القرآن يماشي كل عصر، ويوجه كل جيل، ويطور كل قرن، ويبني كل حضارة، ويؤسس كل ثقافة، ويحل كل مشكلة، ويحيط بكل صغيرة وكبيرة إلى الخلود، لماذا؟ لأنه كلام الله، لأن الله هو المحيط بكل قرن، والمطلع على كل شيء، والخبير بكل علم، والمطلع على حلول كل مشكلة. القرآن كلام الله، إنه هو صانع الموجودات، الآن نحن عرفنا بعض الخواص في الموجودات، الله هو صانع هذه الموجودات، يعرف الخواص والآثار أكثر منا. فإذًا، الله يوم الذي نزَّل القرآن كان يعرف الذرَّة واكتشافها، والتنقلات، والحركات الاجتماعية، والمشكلات البشرية، والإغراءات كلها والمسائل كلها كان يعرفها. فإذًا، نزل القرآن من قِبل الذي لا حد لعلمه ولا مدى لثقافته لا يعزب عن علمه ﴿مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء﴾ [يونس، 61]. هذا الإله بعث لنا القرآن باللغة العربية، كلامه هو، فإذًا، نحن في كل عصر مهما بلغت ثقافتنا ومعرفتنا ومهما تقدم البشر لا يزالون بحاجة إلى القرآن، ولا يزال القرآن يتمكن من توجيههم، هذا هو خلود القرآن والبحث بحاجة إلى تطويل.
فإذًا، القرآن سند صدق محمد، والقرآن قاعدة الإسلام، والقرآن كلام الله، وحينما نستمع إلى القرآن نستمع إلى الله يتكلم معنا، إفهمْ يا أخي إفهمْ، حينما تستمع إلى القرآن الله يتكلم معك. فكلما ازداد علمك وثقافتك ومعرفتك وتحسن وضعك الفكري، وازدادت خبرتك، تفهم شيئًا جديدًا من القرآن غير الذي كنت تفهمه سابقًا، فاليوم نحن بإمكاننا في ضوء معلوماتنا الحديثة أن نفهم القرآن أكثر من السابق بنفس الدليل.
فإذًا، القرآن يوجه في كل عصر وفي كل زمن مهما سبق الأمر، ومعنى الحديث المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، حينما يقولون على ما نُقِل عنهما: إن للقرآن ظهرًا وبطنًا، ولبطنه بطن إلى سبعين بطنًا(5)، هذا معناه أنه كلما تعمقت في القرآن لا تنتهي عجائبه، ولا تصل إلى كل أغواره وأعماقه. فالقرآن مثل بحر، فالإنسان الذي عنده مقدار من الثقافة يتعمق مترًا في الماء، الذي ثقافته أكثر يتعمق مترين، الذي ثقافته أكثر وأكثر يتعمق 50 مترًا، وكلما تعمقت بالبحث تجد شيئًا جديدًا والقرآن نفس الشيء، كلما تعمقت في القرآن تجد شيئًا جديدًا. فإذًا، القرآن سبيل خلود الإسلام.
ما وصلنا إلى الجانب التربوي نؤجله للأسبوع القادم بإذن الله: أيام القدر وأيام نزول القرآن، ولكن أجيب عن سؤال وُجِّه إليَّ من قِبل بعض السيدات، سألت ما معنى ﴿ألم﴾ [البقرة، 1]، ﴿حم﴾ [غافر، 1]، ﴿عسق﴾ [الشورى، 2]، ﴿كهيعص﴾ [مريم، 1]، ﴿ألمر﴾ [الرعد، 1]، ﴿يس﴾ [يس، 1]؟ موجود هذا في القرآن أليس كذلك؟ ما معنى هذا؟
أقول في الجواب بكلمة مختصرة هناك تفاسير مختلفة وآراء عديدة استعرضتها جميعًا، والرأي الذي اخترته لنفسي وآمنت به أنقله لكم دون مناقشة. فلا أعتقد أن هذه الكلمات رموز، ولا حساب الجدول والأبجدية ولا حساب الجمل، ولا أسرار، ولا إبهام، ولا كل هذه المسائل. لماذا أقول ليس هذا المعنى؟ لأنه كما ذكرت لكم النبي (عليه الصلاة والسلام) كان مبتلى بخصوم، أمامه خصوم فصحاء أذكياء، بلغاء نقّادون ينتظرون غلطة، يفهمون كل شيء لو كان هو بعد التحدي والتجييش لطاقاتهم، لو كان في كلامه غلط أو خطأ أو لغز أو مبهم كانوا يأخذون عليه. في تاريخ نزول القرآن وفي تاريخ سيرة النبي ما صدف يوم أبدًا أن واحدًا يقول يا محمد ماذا تقصد بـ﴿ألم﴾ [البقرة، 1]؟ ماذا تقصد بـ﴿حم * عسق﴾ [الشورى، 1-2]؟ هذه رموز، هذه ألغاز؟ أنت تحكي كتاب تربية أو أحجيات! ما أحد قال. هذا يدل على أن العربي في أول الإسلام كان يفهم هذه الكلمات، كان يفهمها، وكان يهضمها وكان يقتنع بها. كيف كان يفهمها؟ وماذا كان معنى هذه الكلمات والحروف؟ معناها المبالغة في التحدي، يعني يقول لهم: أيها العرب (جيبوا) مثل القرآن، لا تقدروا ولو اجتمع الجن والإنس، (جيبوا) 10 سور، (ما بيقدروا)... (جيبوا) سورة واحدة، ما (بيقدروا) ﴿ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا﴾ [الإسراء، 88]، ثم يقول لهم مبالغة في التحدي يا جماعة أنا لا أجيب بكلمات من غير حروف، أنا أستعمل حروفكم، ألف ولام وميم، هذه الكلمات الموجودة بين أيديكم مواد عندنا وعندكم، بجيبتي وجيبتكم، ﴿حم * عسق﴾ أليست كلمات بيني وبينكم؟ كلنا نعرف هذه الحروف، لكن أنا آتي بالقرآن وأنتم لا تقدرون أن تأتوا بمثله، وهذا تأكيد على عجزهم وعلى إعجاز القرآن.
فإذًا، ﴿ألم﴾ [البقرة،1]، ﴿حم * عسق﴾ [الشورى،1-2]، ﴿كهيعص﴾ [مريم،1] وأمثال ذلك كلها تعبيرات عن الحروف الأبجدية، ويقصد بها النبي أنه أيها الناس أنا أستعمل الحروف الهجائية وأجمعها أو الله سبحانه وتعالى يجمعها ويوحي إليّ وأنا أستعملها لكم وأنتم بين يديكم هذه الحروف، ولا تقدرون أن تركبوها وتعملوا شيئًا منها. ولهذا يقول بعض المفسرين أن الحروف المقطعة لوحظ فيها التناسب مع السورة يعني مثلًا سورة البقرة الحروف المستعملة فيها بكثرة الألف واللام والميم؛ سورة مريم مثلًا أغلب الحروف المستعملة فيها: كاف، هاء، ياء، عين، صاد؛ سورة الدخان مثلًا: حاء وميم. كل سورة فيها هذه الحروف التي تُسْتَعمل في هذه المواد. وهذا يشبه بأن مهندسًا من المهندسين الكبار يعمل بناية فخمة ثم يتحدى المهندسين، يقول يا جماعة هذا باطون، وهذا حديد، وهذا خشب، وهذا زجاج وابنوا مثل ما بنيت أنا؛ يعني يذكر المواد. المعلم القديم الذي كان يعمل بالآجر والفخار وأمثال ذلك، أو بالطين أو من حجر، يأتي ويقول أنا بنيت هذه البناية الفخمة بالحجر، إعملوا أنتم.
هذا المعنى، يعني النبي يريد أن يقول يا جماعة أنا لا (أجيب) حروفًا من هنا، من هناك، ألف ولام وميم وجيم ودال وباء وخاء. هذه الكلمات التي بين أيديكم أنا أستعملها وأعمل منها قرآنًا معجزًا، هذا المعنى الذي نفهمه من هذه الآيات، ودليله أن العرب في أول الإسلام ما كانوا يستنكرون هذه الكلمات. ما كانوا يتهمون النبي بأنه كان يتكلم الطلاسم والألغاز؛ حتى ما كانوا يسألون، في تاريخ نزول الوحي ولا واحد سأل أنه يا محمد ماذا تقصد بهذه الكلمات، وفسر لي إياها؟ لا يوجد دليل على أنه كانوا يفهمون الجماعة. كان الشيء واضحًا. لكن فيما بعد التعقيدات الحياتية ودخول الشعوب المختلفة والتعقيدات الحاصلة في اللغة وفي الأفكار جعلت الناس بعيدة عن هذه الأفكار وأصبحت التفاسير متكسرة ومختلفة ومتناقضة، وهذه هي خلاصة الموضوع.
هذه نبذة من القرآن الكريم. نسأل الله أن نتوفق في المستقبل للتحدث عن هذا الموضوع بصورة أوسع، وأن نصل إلى النتائج التربوية حتى نكون ممن نجعل القرآن أمامنا حتى يقودنا إلى الجنة لا خلفنا حتى يسوقنا إلى النار.
والسلام عليكم.
__________________________
(1) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج10، ص313.
(2) مستدرك الوسائل، الطبرسي، ج7، ص255.
(3) را: الكافي، ثقة الإسلام الكليني، ج. 2، ص. 599.
(4) وسائل الشيعة، ج6، ص171.
(5) را: بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 89، ص94.