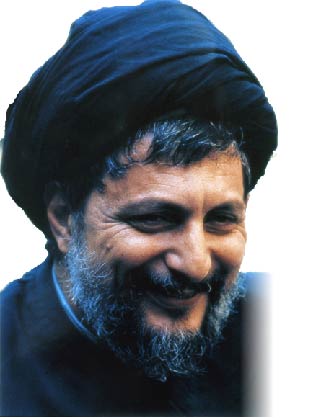* تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.
بسم الله الرحمن الرحيم
[...] استعراضًا لموقع هذه الحلقة كنا نتحدث في الخطوة الأولى في مسيرة الإسلام ووقفنا عند كلمة قولوا لا إله إلّا الله تُفلحوا، وبحثنا حول معاني كلمة إله ونفيه إلّا الله. ثم استعرضنا تأثيرات هذه الكلمة على صعيد الفرد والجماعة بآثارها النفسية والعقلية والعملية، وعلى الجماعة بآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ووقفنا عند نقطتين أساسيتين:
تأثير الإيمان بالله الواحد على تكوين المجتمع ذلك الذي سميناه مجتمع الموحدين. طبعًا في خلال هذه الحلقة لا نتمكن أن نرسم صورة كاملة عن المجتمع الإسلامي لأننا لا نزال في الخطوة الأولى، وإن كانت هي الخطوة الأساس بداية ونهاية وطريقًا. وحاولنا أن نستنتج من خلال الإيمان بالله الواحد ونفي الآلهة أن نرسم خطوطًا عريضة للمجتمع الذي ينشده الإسلام.
بحثنا في النقاط العامة وكان يبدو على وجوه بعض الإخوان المستمعين أن هذه الأبحاث تبدو مثالية كما يقولون Idealistic بعيدة عن واقع الحياة. هذا الرأي وهذه الملاحظة صحيحة، ولذلك أنا أتممتُ المحاضرة بطرح نقطة أخرى هي نقطة الشرّ. مسألة الشرّ في المفهوم الديني وفي المفهوم التوحيدي مسألة عقائدية واجتماعية مهمة جدًا. هل الشرّ موجود في الكون أو لا؟ غير موجود يعني أمر نسبي وإضافي، لأن الاعتراف بوجود الشرّ قد يصطدم بمسألة التوحيد، وحدانية الخالق ووحدوية الخلق. إذا كان الشرّ موجودًا أو الشرّ نسبي، افترضنا ذلك فما سبب تكوين الشرّ؟ سببه خلق الصراع، وما نسميه في الإسلام الجهاد. وجود الشرّ هو الفرق بين المثالية وبين الواقعية؛ وجود الشرّ هو الذي يستدعي أن نفكر في جهاز تنفيذي... ما يأتي إلى ذهنكم حول المثالية والخيالية... الحلقة السابقة في الحقيقة لأن الحلقة كانت بحاجة إلى البحث عن الشرّ، هذا البحث الذي سنتحدث فيه الأسبوع القادم بإذن الله، وسوف نأتي إلى إكمال النقاط العامة حول تكوين مجتمع الموحدين. ويبقى لنا موضوع أخير وهو موضوع "اقتصاد الموحدين" أو ما نسميه من هذا القبيل.
في هذه الليلة تكاثرت الأسئلة وبقيت من السلسلة السابقة أو من الحلقة السابقة أسئلة متعددة، ولذلك استأذنّا الإخوان عن طريق اللجنة أن نخصص هذه الحلقة للأسئلة والأجوبة.
يسألني الأخ الشيخ عباس بأن هناك أسئلة خارجة عن بحث المحاضرات، طلبتُ أن يطرحها سألني هناك أسئلة خاصة فيها تسمية... طلبتُ أن يطرحها حتى نقول إن كلّ سؤال يمكن أن يطرح مهما كان محرجًا فليطرح، ونحن نتحدث عن كلّ شيء. وإن شاء الله ليس لدينا أيّ غموض حتى نقف أمام بعض النقاط الغامضة.
هذه مقدمة موجزة سنبدأ أولًا بالأسئلة التي تكون حول محاضراتنا ثم أسئلة عامة ثم أسئلة خاصة. فليتفضل السائل.
- بسم الله الرحمن الرحيم، لجنة الندوة الثقافية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ترحب بكم آملة أن تلتقي معكم في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء كلّ خميس، مع رجاء اللجنة الحارّ بالتقيد بهذا التوقيت نكمل وإياكم المحاضرات التي يلقيها سماحة الإمام مخصصين هذه الليلة للأسئلة التي تبقت من المحاضرة الماضية.
السؤال الأول: قلتم بأن الله أوجد الليل والنهار وجعل لهما نظامًا كما أن كلّ الحوادث الكبيرة تتم إذًا بعلمه ومعرفته بحيث أنه المدبر لهذا الكون، كيف تفسرون الكوارث الطبيعية وعلاقتها بالله وما ذنب من تقع عليهم الكارثة؟ وشكرًا.
ج: طبعًا هذا البحث من المفروض أن يطرح في مسألة العدالة الإلهية أو ما نسميه في أصول الدين بالعدل ولكن سأجيب عن السؤال باختصار.
يعلمنا القرآن الكريم أن جميع المصائب والمشاكل لخير الإنسانية بشكل أو بآخر، الأمراض والمصيبة والنقص للأموال والأنفس والثمرات، كلّ هذا لخير الإنسان، هذا المبدأ العام. نتحدث في خصوص السؤال... الكوارث الطبيعية، نحن نعتقد أن هذه الكوارث لإكمال الإنسان وإنها سياط على كاهل الإنسان وعلى أكتاف الإنسان حتى يركض ويسعى مُجدٍّا نحو الخير أكثر وأكثر.
توضيح ذلك أن الإنسان في أول الخلق لو كان مأمونًا ومصونًا عن المرض والبرد والحرّ والعدو كما يقول الأثر، لو كان الإنسان يعيش في الجنة من أول يوم... يعيش في مروج خضر لا برد، ولا حرّ، ولا عدو، ولا مرض، ولا شيء... الإنسان اليوم كان مثل الخروف لا يتحرك، ولا يفكر، ولا يسعى، ولا يفتش عن مصالحه، ولا يعرف شيئًا ولا مثقف. وأمامنا أمثال، الإنسان الأفريقي مع العلم أن في أفريقيا لا نجد الجو الذي وصفتُه لا حرّ ولا برد ولا عدو ولا كذا... ولكن مجرد سهولة العيش في الغابات، الإنسان الأفريقي لا يبقى جوعانًا لأنه بمجرد ما جاع يدخل إلى الغابة فيقطف ما يشاء.
هذا الوضع سبب مزيدًا من التأخر في أفريقيا، حتى إذا تفتحت عيون العالم والمستعمر والمستغل نحو أفريقيا وبدأوا يخلقون لهم مشاكل، تفتَّحوا. سبب تقدم أوروبا في الفترة الأخيرة من التاريخ قساوة البيئة عندهم، كلّما كان الجوّ أقسى الإنسان يتحرك أكثر.
في أول الخلق وجود المرض كان دافعًا للإنسان حتى يفتش عن علاج لأنه كان يرى أنه معرض للموت، ابنه معرض للموت، ابنته معرضة للموت، كان يحزن على هذا الوضع فكان يفتش، يبرم، يحرك تفكيره. حرك تفكيره وأول شيء اتجه نحو الأساطير، استغلّه المشعوذون، أخطأ، سقط، قام، مشى، لكن كلّ هذا محاولة لكشف العلاج للمرض. ففتش عن العلاج، فاضطرّ أن يقتحم غوامض الكون ومجاهله، وحينما بدأ يقتحم أسرار الكون، اكتشفها فاستغلّها فتطور وسيطر، وهكذا تَقدَّم.
فوجود المرض أيّ الحاجة كان السبب الرئيسي لدفع الإنسان نحو التفكير، وبالتالي نحو المعرفة. البرد كان دافعًا آخر، الحرّ كان دافعًا آخر، العدو كان دافعًا آخر، دوافع وأسباب أحاطت الإنسان من كلّ جانب فكانوا يضربون على كاهل الإنسان سياطًا حتى يركض ويفتش ويعالج مشاكله. قد تقولون إنه طيب ما الذي كان يصير لو كان الإنسان يُخلق في الجنة من الأول وفي مرج أخضر ولا يوجد برد ولا حرّ ولا شيء ويعيش مرتاحًا مبسوطًا، ماذا يريد بهذه الشغلة؟
هذا جوابه أن الإنسان خُلِق لكي يعرف... ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات، 56] أيّ ليعرفون. الغاية من الخلق هي المعرفة، كان المفروض أن الإنسان يعرف كلّ شيء. الآن لماذا؟ هذا بحث تجريدي آخر. المهمة التي خُلق الإنسان لتحقيقها مهمة المعرفة. فالحقيقة أن هذه المهمة ما كانت تتحقق إذا كان الإنسان بمعزل ومصونًا عن المشاكل والحاجات، وعلى ضوء هذا البحث ولنفس السبب الكوارث الطبيعية. اليوم كارثة تأتي كالزلزال فيقضي على عشرة آلاف أو عشرين ألف في أغادير في المغرب أو في مكان آخر... هذه الكارثة تضحي بعشرة آلاف أو عشرين ألف. ولكن وجود هذه الكارثة إنذار للإنسان وتحريض للإنسان حتى يفكر فيعرف القوى الكونية ويعرف الزلزال وأسباب الزلزال وكيفية التغلب على الزلزال، فيخلق آلات لمعرفة الزلزال تلك التي يسمونها Sismographe ويبنون أبنيتهم على الطريقة اليابانية بشكل لا تُهدم أو لا تتحطم أو لا تقتل الإنسان إذا حصل زلزال وأمثال ذلك، وبالتالي يتغلغل الإنسان في مزيد من غوامض الكون فيعرف الكون.
راح عشرة آلاف... عشرين ألف، ولكن البقية الباقية من البشرية ارتفعت في مستوى من المعرفة أرفع مما كان، وهكذا السرطان وهكذا العواصف وهكذا البراكين وهكذا كلّ شيء. دوافع للإنسانية للتحرك وطبيعة الحال هؤلاء ضحية الأكثر.
قد تقول: ما ذنب هؤلاء الذين قتلوا؟ نقول لكم إن الله سيعوِّض عليهم إذا كانوا في نية حسنة ويستحقون التعويض، سيعوِّض عليهم لأنهم ضحايا البشرية كلّ البشرية. فهؤلاء ماتوا في سبيل الأفضل، تمامًا مثلما يكون عندك كوخ وتريد أن تبني قصرًا، فتهدم الكوخ لأجل القصر، وروّحت كمية من المال في سبيل الأفضل، هذا شيء طبيعي. ولكن الله الذي لا يظلم إنسانًا مثقال ذرة، يعوِّض على هؤلاء الضحايا فيعطيهم أجرهم يوم القيامة بغير حساب ونحن نعتقد أن المعاد متمم لهذه الحياة.
فالجواب عن السؤال، أولًا، وجود الكوارث الطبيعية والمشاكل البشرية والأمراض والعوارض المختلفة دوافع لتحريض الإنسان للسير نحو الكمال ولمعرفة الكون. والضحايا لهم تعويضهم وأجرهم حتى يرضون عن ربهم.
س: سماحة الإمام قلتم إن ما يصيب الإنسان هو بما كسبت يداه فكيف تفسرون الإيمان بالقضاء والقدر، الزلازل والأمراض التي يعتبرها الحديث الشريف تكفيرًا لذنوب الإنسان ويأمره بالصبر، تقتير الرزق على الإنسان الله يبسط الرزق ويقتر، تحديد عمر الإنسان من قبل الله؟
ج: أعتقد أن قسمًا من هذا السؤال طُرِح في ليلة من الليالي السابقة، وقسمًا منه تحدثنا [عنه] في هذه الليلة. أما ما ورد من ﴿أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ [الروم، 37] أو ويقبض أو ويقتر، مشيئة الله في تحديد الرزق كمشيئته في الضلال والهداية يهدي الله من يشاء و﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾ [فاطر، 8]، المشيئة التي لا تتنافى مع المسؤولية، وأنا ذكرت أن هذه المشيئة ردّ على العقائد السابقة من يهودية وغير يهودية التي كانت تصنف البشر وتفرض على الله سبحانه وتعالى طريقة على الحياة، وتفرض على الله أن يُدخل فئة من الناس الجنة وأن يُدخل فئة النار وأمثال ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يخضع لتصنيفاتهم ويتصرف حسب مشيئته، لكن بماذا تعلقت مشيئته؟ القرآن يفسر: ﴿ونفسٍ وما سواها * فألهما فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها﴾ [الشمس، 7-10].
مشيئة الله تعلقت بأن يكون مصير الإنسان رهن إرادته ووضع مجتمعه رهن إرادته ومشيئته هكذا مشيئة الله. إن الله مشيئته في الغنى والتقتير تعلقت بأن يكون تابعًا لجهد الإنسان الفردي والجماعي. طبعًا ممكن الواحد يجتهد ولا يصل إلى خير، هذا ناتج الوضع الاجتماعي العام المشكلة الاجتماعية، بطبيعة الحال الإنسان لا يقدر أن يسيطر على نشاط فردي ونشاط جماعي في نفس الوقت لكن عليه أن يسعى كفرد وكجماعة.
أما ما ورد من أن الأمراض والمصائب تكفير عن الخطايا... نعم! كصبر وتسليم أمام إرادة الله وعدم الجزع تكفير عن الخطايا. ليس مجرد ما إذا أحد ما يصاب بمرض، خطيئته راحت... بل إذا ابتُلي بمرض فصبر عند ذلك يزداد أجره وتكفر خطاياه، لأنه الإيمان في الحالة العادية -كلّ إنسان مؤمن أو كثير من البشر في الحالات العادية مؤمنون- ولكن الإيمان الصعب العميق يعرف في عدة حالات: منها حالة المصيبة ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة﴾ [البقرة، 155-157].
عندما يصاب الإنسان بمصيبة إذا كان مؤمنًا مقتنعًا بـ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ [البقرة، 156]، هذا الإيمان العميق. أما الشخص الذي بمجرد ما يصاب بمصيبة يكفر ويسب، هذا الإنسان مهزوز ومهزوم أمام المصيبة، هذا مصيبته ليست تكفيرًا، نفس الشيء عندما يبتلى الإنسان بمصائب أخرى هذه حالة.
حالة ثانية، حالة الغضب إذا غضب الإنسان وتمكن من الاحتفاظ بإيمانه، هذا الإنسان المؤمن. القرآن الكريم يشير إلى هذا في الآية الكريمة: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ [المائدة، 8].
والحالة الثالثة، حالة الخوف من الفقر: ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء﴾ [البقرة، 268].
الحالة الأخرى، حالة الانتصار، مُعرَّض الإنسان للغرور حالة النصر ونشوة الانتصار أيضًا يشير إليها القرآن الكريم: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا * فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا﴾ [النصر].
فإذًا، الإيمان العميق هو الإيمان الذي يصون الإنسان في الحالات الحرجة، في حالة المصيبة، الفقر، المرض، الغضب، الانتصار وأمثال ذلك... أما الإيمان في الحالة العادية فحالة طبيعية.
كفارة الذنب... المصائب التي هي كفارة لذنوب الإنسان ليست مجرد الإصابة بالمصيبة، إذا أصيب الإنسان بمصيبة فصبر، الصبر كفارة بطبيعة الحال لأن الصبر قوة الإيمان ورياضة الإنسان لأجل قوة الإيمان وهذا كفارة لذنوب الإنسان لأنه تكامل للإنسان.
هناك نقطة أخرى، أن القرآن الكريم يستفاد من كثير من آياته أنه أحيانًا المشاكل التي يتعرض لها الإنسان لأجل التأديب وهذا مفهوم عام في القرآن الكريم: ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾ [الروم، 41].
كلّ المصائب التي نعانيها، الله سبحانه وتعالى يريد أن يذيقنا بعض أثر أعمالنا حتى نتوب ونرجع، هذا المفهوم أيضًا مفهوم إسلامي شامل أن المصائب التي تحصل في الوجود من مصائب عامة، فقر المجتمعات، مرض المجتمعات، تخلف المجتمعات، مظلومية المجتمعات كلّها ناتجة عن يد الإنسان وتصرفات الإنسان حتى يرجع الإنسان إلى الطريق. وقسم من الحديث سبق وقسم من السؤال أيضًا وتحدثنا [عنه] في هذه الليلة.
س: بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يستبعد وجود علاقة بين الإيمان بالله والناحية العملية التطبيقية ويعتقد أن ما جاء به الدين الإسلامي من تشريعات وأمور اقتصادية واجتماعية إنما كان ليرفع مستوى البدو حتى يدركوا الروحيات التي هي غاية الدين، والدليل هو المسيحية التي لم تهتم بالتشريع لكون الشعب الذي أتت له كان راقيًا من الناحية العملية فما رأيكم، شكرًا؟
ج: طبعًا كلّ إنسان يتمكن أن يتبنى نظرية من النظريات ورأيًا من الآراء، وإنما على الإنسان الذي يتبنى نظرية أن يؤكد ذلك من خلال نصوص الدين أو من خلال الواقع التاريخي.
أولًا، المسيحية التي هي حلقة من دين الله ونحن كما تعرفون نعتقد أن دين الله واحد والأنبياء لكلّ منهم ﴿شرعة ومنهاجًا﴾ [المائدة، 48] حسب ما ورد في القرآن الكريم: ولكلّ منكم، يعني أيّها الأنبياء، في ذيل السورة، و﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا﴾ [المائدة، 48]. دين الله واحد، وكلّ نبي بلغ أمته بمستوى تفكيرهم ومستوى استيعابهم واكتمل الدين الكامل الشامل لجميع الأمم كما نحن نعتقد الحلقة الأخيرة: الإسلام هو جميع ما أتى به جميع الأنبياء وليس فقط ما بشَّر به رسول الله محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
المسيح (عليه السلام) هو يقول: جئت لأكمّل الناموس، لا لأنسخه، وهذا يعني أن الديانة المسيحية كانت إكمالًا للديانة اليهودية، ورفعًا للنقص المادي المتغلغل في اليهود، والذي يبدو إلى الآن في عدم تعرض التوراة والتعاليم اليهودية للمسائل الغيبية ومسائل ما وراء الطبيعة ومسائل الدينونة. فالمسيحية لا يمكن النظر إليها وحدها بمعزل عما ورد في العهد القديم وهو التوراة. فليس هناك من دين لا يتعرض للأحكام الاجتماعية، هذا أولًا.
ثانيًا، بخصوص الإسلام إذا نريد أن ندرس النصوص الإسلامية، نحن نجد أن النصوص الإسلامية الصريحة بأن الإسلام ليس دين البدو كما يقول السؤال وإنما جاء ﴿رحمة للعالمين﴾ [الأنبياء، 107] كما يقول القرآن الكريم... وأنه دين الله لجميع البشر لا للعرب الذين كانوا موجودين في الجزيرة. ولذلك، توجُّهُ الموجة الإسلامية نحو الشرق الأوسط كان بدأ في أيام الرسول الأكرم، وليس فيما بعد الرسول حتى نقول إن هذه كانت تصرفات من الخلفاء؛ وواقعة اليرموك كانت في أيام رسول الله والتي قُتِلَ فيها كثير من أصحاب النبي (عليه الصلاة والسلام). فالإسلام اتجه لأجل التغلغل في هذه المنطقة التي هي كانت منطقة الدعوة المسيحية شعب واحد... عالمية الإسلام ضرورة من ضرورات الدين الإسلامي من خلال نصوص الدين. وأخيرًا النصوص التي استعرضتُ بعضها في الليلة الأولى وهي النصوص التي تربط بين الإيمان وبين الأوضاع الاجتماعية، هذه النصوص صريحة لا تقبل الجدل، "ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانًا وجاره جائع". الكلام ليس شعرًا، حقيقة، الإيمان بالله واليوم الآخر لا يمكن أن ينفصل عن مساواة الإنسان لجاره ومنع الجار من الجوع، عندما يتنكر الإنسان لذلك يكون غير مؤمن.
فإذًا، الإيمان الإسلامي لا مفهوم له مع تجاهل أوضاع الجار والنص القرآني المحكم: ﴿أرأيت الذي يكذب بالدين * فذلك الذي يدع اليتيم * ولا يحض على طعام المسكين﴾ [الماعون، 1-3].
أكثر من هذا ماذا نريد؟ وهل هناك فصل بين الإيمان وبين الاهتمام بشؤون الآخرين؟
نحن نعتقد أنه لا يمكن الفصل. وفي الأساس هذا أمر منطقي، الذي يعتقد أن الإنسان ممكن أن يكون مؤمنًا بقلبه ولكن يتصرف في جسمه كما يشاء، ويعيش في مجتمع، أيّ مجتمع كان، كما يشاء... هذا الإنسان مخطئ يعتقد أن الإنسان موجودَين أو ثلاثة... كلّ جزء معزول عن الأجزاء الأخرى، الإنسان موجود واحد... كلّ ما يؤثر في نفسه ينعكس على جسمه وكلّ ما يتصرف الإنسان بجسمه ينعكس على عقيدته... ليس هناك عدة أشياء، الإنسان موجود واحد. فكلّ شيء يؤثر في جزء منه، يؤثر في مجموعة أجزائه، وعلى هذا الأساس لا يمكن فصل الإيمان عن القضايا الاجتماعية وعن القضايا العملية بنص القرآن وحسب المنطق أيضًا. والإسلام كما قلتُ دين المجموعة البشرية وليس دينًا لفئة متخلفة واحدة، ولا دليل على هذا الادعاء إطلاقًا. صاحب النظرية التي تقول إن الإسلام كان يضع نظامًا اجتماعيًا لرفع مستوى البدو عليه أن يثبت ذلك من خلال التعاليم الإسلامية التي لا يمكن إثباتها.
س: سيدي المحترم، تفضلتم أن علاقة الإنسان بإنسان هي على أساس الكفاءات، فما هي علاقة الإنسان بالله وعلى أيّ أساس مبنية ولماذا لم يتدخل الله بالقوة ليجنب البشر الشر والويلات؟
ج: علاقة الإنسان بالله مرسومة من خلال هذه الكلمة ﴿الذي خلق فسوى * والذي قدَّر فهدى﴾ [الأعلى، 2-3]. الخلق والتسوية يعني إعطاء الكفاءات ووضع الدور ﴿قدّر﴾ وتوجيه الإنسان نحو هذا الدور. الإنسان في خلقه وفي تحركه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، تبادل الكفاءات، علاقات الإنسان بعضهم مع بعض ولكن خلق الكفاءات هو دور الله في الإنسان مع خلق الإنسان في الأساس. أما لماذا لا يتدخل الله سبحانه وتعالى في دفع الشرّ وفي فرض الصلاة أو في فرض الخير على البشر؟ لأنه إذا تدخل نصبح كلنا مثل النحلة... لا إنسانية عند ذلك، الإنسان يكتمل نتيجة للصراع النفسي بين الخير والشرّ، لأنه هو مخيَّر بين الخير والشرّ فيختار الخير ويتعب ويتعذب. هذا العذاب هو الصراع الذي يؤدي إلى الكمال لأنه رياضة نفسية. أما إذا كان الإنسان مسيرًا ومجبورًا نحو الخير، يعني لا يدرك الشرّ أو يدرك الشرّ، لكن إذا لم يكن من شرّ، تدخل الله بالقوة فمنع الشرّ، يصبح كلّ البشر مثل الخرفان أو مثل النحلات... يعني موجود تافه مسيَّر مثل هذه الموجودات الكونية الأخرى. كمال الإنسان أن يختار الخير بملء إرادته وأن يعيش صراعًا دائمًا بين الخير والشرّ في كلّ خطوة وفي كلّ موقف.
س: سماحة الإمام إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون والعالم والإنسان وكلّ شيء وقلتم أن له من وراء ذلك في تسيير هذا الخلق هدفًا، فما هو الهدف من وراء خلق هذا الكون والإنسان طالما أن الله هو بغنى تام عن الإنسان فلماذا فرض عليه قيودًا كثيرة كالصلاة والصوم وغيرها؟
ج: أما [في] ما فرض الله على الإنسان كالصلاة والصيام هذا إكمال للإنسان طبعًا وترويض الإنسان وسير الإنسان نحو المعرفة ونحو الكمال كما سيأتي. أما السؤال الأول، هذا سؤال عام وعميق ويجب أن نقف في وجهه بصورة حازمة وصريحة.
أولًا، جميع الأسئلة التي توجه إلى الله وإلى الدين والأجوبة التي تأتي من الجانب الديني ليست أسئلة وأجوبة فلسفية، يعني لا تبحث عن السبب، وإنما أسئلة وأجوبة تربوية، تسأل عن الهدف لا عن السبب. يعني نحن حينما نسأل لماذا خلق الله الإنسان؟ مرة نسأل أنه ما هو السبب الفلسفي لخلق الإنسان؟ هذا السؤال لا يمكننا أن نجيب عنه وليس عندنا شيء يجيب عن هذا السؤال ولا فائدة في هذا السؤال. نحن الذي يفيدنا السبب التربوي، لأيّ غاية ولأيّ هدف ولأيّ مخطط خلق الله الإنسان؟ يعني إلى أين يوصِل ربنا الإنسان من الخلق؟ الجواب التربوي يعني الإنسان يعرف أنه من أجل ماذا خُلِق؟ وما الخطّ الذي يجب أن يسلكه؟ هذا الجواب... هذا الجواب تربوي منعكس على حياة الإنسان.
أما ما الغاية من الخلق؟ أنا لا أعرف. ولا أقدر أن أجيب على هذا السؤال، ولا فائدة في هذا السؤال إلّا جوابًا تجريديًا فكريًا لا ينعكس على حياتنا إطلاقًا. الذي ينعكس على حياتنا أنه نعرف من أجل أيّ هدف وأيّ حركة وأيّ مخطط خُلِقنا. القرآن الكريم يقول: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات، 56].
والتفسير الصحيح عن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) يقول: يعبدون يعني يعرفون.
فإذًا، غاية الخلق المعرفة، وسبيل المعرفة العبادة، والعبادة كما قلتُ في الحلقة السابقة ليست العبودية، وكلّ حركة صادرة عن نية حسنة هي عبادة، فالخلق لأجل المعرفة. ماذا يعني لأجل المعرفة؟ يعني نحن المخطط الموضوع في سبيلنا والهدف التربوي من خلقنا، المعرفة، خُلقنا ووضعنا في أجواء معينة وبدأنا نتصارع مع الطبيعة، ومع أنفسنا. ومن خلال هذا الصراع نتعرف على القوى الطبيعية فنسيطر عليها ونسيطر على القوى النفسية فنسيطر عليها.
يعني أمام الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر الإنسان خُلق لكي يعرف، وكلّما ازدادت معرفته بالأشياء ازدادت معرفته بالله إذا كانت المعرفة في الخط الصحيح ومنسجمة مع سيطرته على النفس.
فالجواب على السؤال أنه خُلق الإنسان لكي يعرف فقط. والمعرفة الصحيحة لا يمكن إلّا أن تكون معرفة الشيء ومعرفة مكان الشيء... العلم الحديث يكتشف الشيء ولكن لا يكتشف مكانه في الوجود. وهذا بحث مفصل آخر قد نتمكن من التحدث فيه إن شاء الله بشكل مفصل.
س: ما رأيكم سيدي بتنظيم شباب مؤمن متطوع لخدمة الدين في حين الدعوة إلى الجهاد نطلب رأيكم وشكرًا؟
ج: أنا موافق مئة في المئة مع تنظيم شباب مؤمن، ولكن لا أعتقد أنه يمكن أن يؤمن الإنسان إلّا بعد أن يعرف، وهذه الحلقات سبيل المعرفة. فإذًا، هذا تمهيد لمن يحب أن ينظِّم شبابًا مؤمنًا، ونسأل الله أن يجعلنا نتوفق في أداء هذا الدور أيضًا. أنا أعتقد أنه في هذه الظروف أهم دور وأوجب دور أن نتمكن من التوعية والفهم الصحيح للإسلام، حتى نتمكن من أن نكون مؤمنين، وحتى نتمكن أن نتنظم وأن نقوم بالجهاد كما تقولون.
س: سماحة الإمام قلتم في محاضرتكم أن الشعب لا ينتخب خليفة في الإسلام، ولكن كما تعلمون فإن الإنسان مخيَّر ويمكن أن تؤثر فيه الشهوات والأنانيات فكيف تفسرون هذا؟ وشكرًا.
ج: هذا أظن دليل ضد المدعى، السؤال يقول الشعب ينتخب الخليفة، السؤال كان الشعب لا ينتخب. الدليل، أن الشعب يتعرض للشهوات والميول. فإذا كان الشعب يتعرض للشهوات والميول فإذًا، لا ينتخب يعني هو كما قلت أنا وليس كما اعترض على الموضوع. بالنسبة للخليفة كما قلنا إنه لا ينتخب، هذا ليس مورد البحث، مورد البحث في الفكر الديني والحكم الديني ومصدر السلطات في الدين.
مصدر السلطات في الدين الله، فهو الذي يؤمن السلطة ويفوض الحكم لشخص النبي أو الإمام أو ولي الأمر. لكن من هو ولي الأمر؟ هذا السؤال يُطرح من جديد. قد يكون في مرحلة من الزمن ولي الأمر هو الذي يُنتخب، وقد يكون في فترة من الزمن هو الذي يُنتخب من قبل النخبة، وقد يكون في فترة من الزمن هو الذي يُسمى من قبل النبي، وقد يكون في فترة من الزمن هو النبي، فتفصيل الحاكم بحث آخر غير مصدر السلطات.
فما ذكرناه نحن أن مصدر السلطات في الحكم الديني هو الله، وهو الذي يؤمِّن الحاكم للحكم، أما من هو الذي يستلم هذه الأمانة الإلهية فيحكم باسم الله؟ هذه تفاصيل. النبي أو الإمام أو ولي الأمر، ولي الأمر يعني الفقيه العادل المجتهد، هل هو واحد؟ هل هو مجموعة؟ هل هو منتخب من الأكثرية، أكثرية النخبة؟ هل هو منتخب من أكثرية الشعب إذا كان الشعب واعيًا؟ مراحل تمرّ على الإنسان وعلى الإنسان المسلم في خلال فترات حياته فحسب الفترة يكون الحاكم.
س: سيدي المحترم، هل عُبِثَ بالقرآن قبل أو بعد جمعه ومن هو الذي جمعه وفي أيّ عهد؟
ج: هذا البحث أنه هل صار عَبث بالقرآن من مفتريات اليهود، ومع الأسف تمكن اليهود بأن يضعوا روايات مدسوسة ضمن رواياتنا نحن يعني روايات آل البيت وضمن روايات إخواننا في كتب الصحاح الست السُنَّة، موجود في كتب الأحاديث عندنا وعند السُنَّة أنه حصل حذف أو عبث في القرآن الكريم. ولكن هذه الروايات نحن نسميها بالإسرائيليات وروايات ضعيفة ومرفوضة ولا يُعتمد عليها، والقرآن الكريم يؤكد: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ [الحجر، 9].
قدس الله روح أبي وآبائكم أجمعين إذ كان يضيف دليلًا آخر على عدم حذف القرآن والتلاعب بالقرآن، والدليل هذا هو التحدي، يقول إنه حينما القرآن الكريم يؤكد أن الجن والإنس لو اجتمعا على أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة منه، وهذا التحدي خالد لأن الإسلام خالد في عصر النبي وفيما بعد. فلو حصلت أيّة زيادة في القرآن، والزيادة ليست من كلام الله انتقض التحدي، لأن البشر تمكن أن يأتي بمثل القرآن. ولو حصل أيّ نقص في القرآن، التركيب اختلّ والتحدي انتقض ولذلك فنحن لا منطقًا ولا نصًا نقدر [أن] نوافق على القول بعبث القرآن، فالقرآن هو القرآن الموجود بين الدفتين هو المُنْزَل بجميع آياته دون زيادة أو نقيصة أو تحريف. وحتى الترتيب مُنْزَل، صحيح أن الآية الأولى: ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ [العلق، 1]، ولكن الوحي أمر النبي بأن يجعل هذه الآية في المكان الفلاني، وأن يجعل الآية الفلانية قبل هذا وبعد هذا، ولذلك القرآن منزل بنصّه وروحه وترتيبه وتبويبه وفصوله دون زيادة أو نقصان.
نبدأ بالأسئلة المتفرقة:
س: هل إعطاء حبوب منع الحمل للزوجة بموافقتها محرم على الزوج والزوجة؟ وهل إعطائها هذه الحبوب رغمًا عنها أو عدم معرفتها بها من قِبل الزوج هل هناك من إثم على الزوجة بعد ذلك؟
ج: أساسًا، منع الحمل عفوًا تحديد النسل في الأساس ليس محرمًا في الإسلام، محرم في المسيحية والمسيحية المعاصرة تناقش في هذا البحث، وقد صدر في السنة الماضية قرارًا مفصلًا عن قداسة البابا حول تحريم تحديد النسل. ولكن في الإسلام لا سابقًا ولا لاحقًا لا دليل على حرمة التحديد إطلاقًا. ولا أفتى به فقيه في أقطار الأرض. وكان الفقهاء سابقًا يسمون طريقة تحديد النسل بالأسلوب البدائي كانوا يسمونه بـ"العزل" يعني صبّ المني خارج الرحم، وكانوا يقولون إن العزل وهو نوع من تحديد النسل يجوز بموافقة الزوجة وهذا يعني أن حجم العائلة يتحدد باتفاق الزوجين دون سواهما.
فإذًا، منع الحمل وتحديد النسل إذا كان برضى الزوجين يجوز. أما الفرض على الزوجة فلا يجوز، وفرض الحكومة على الزوجين أيضًا لا يجوز، لأن هذا أسلوب متكاسل من الحكّام لكي يعالجوا مشاكلهم الاجتماعية عن طريق تحديد العدد. الزوجان هما وحدهما يحق لهما أن يحددا حجم العائلة. وحبوب منع الحمل من جملة هذه القاعدة العامة.
أما ما ورد في الحديث: تناكحوا، تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. فهذا تقدير وترغيب وليس فرض وإيجاب، ثم المباهاة معناها التربية، يعني النبي يباهي بأمته الصالحة ليس بالكتلة المهملة من البشر. فالذي يتمكن من تربية أولاده تربية صالحة فعليه أن يُكْثِر النسل، أما الذي لا يتمكن من التربية ولا يتمكن من الإدارة فيحق له بموافقة زوجته أن يحدد النسل.
س: كثير من الناس زعموا أن التعري أمر طبيعي، ولا بأس بوجود إناث أو ذكور، فما هي نتائجه التي حصلت والمنتظر حصولها للتعري الواسع أو الضيق؟
ج: الحقيقة لا أقدر [أن] أستوعب السؤال، إذا كان المقصود من التعري يعني هذه الموجة التي نسميها بالخلاعة، بطبيعة الحال نحن بحثنا حول الموضوع أن الإسلام يريد للرجل والمرأة أن يكونا قبل أن يكونا ذكرًا أو أنثى أن يكونا إنسانًا؛ ويريد أن يحافظ على إنسانية الرجل وإنسانية المرأة بصورة ثابتة. فلكي يحافظ على إنسانية المرأة ويمنع طغيان الأنوثة على المرأة في جميع الجوانب وفي جميع النواحي وفي جميع الحالات، فرض عليها عدم الإغراء بالكلام وبالمشي وبستر المفاتن. أما ماذا يحصل من التعري؟
طبعًا، الأنثوية تطغى على المرأة، وتتحول المرأة إلى لوحة فنية، وهذا أولًا تقليل لكفاءات المرأة وتجاهل لإمكانياتها الواسعة وحصر كفاءاتها في الإثارة والجنس.
|ثانيًا، تقليل لعمر المرأة لأن المرأة تتمكن أن تكون مثيرة في فترة معينة من عمرها قبلها وبعدها لا شيء.
ثالثًا، تقليل لفرص المرأة، لأن المرأة حتى تكون مثيرة يجب أن تحافظ على كيفية اللبس وكيفية الشعر وكيفية التزيين وكيفية الحركة وكيفية الأكل وكيفية الرضاعة وكيفية النوم وكلّ هذه المسائل وهذا مما يؤثر على وقت المرأة.
وأخيرًا، الإثارة تحوِّل العائلات إلى عائلات مهزوزة، لأن الإنسان الذي يلعب في حياته الجنس دورًا أساسيًا في الحياة العائلية عندما يجد التعري والإثارة يضعف شعوره الجنسي تجاه زوجته وبالتالي علاقتهما تهتز، وبالتالي المشاكل والصعوبات تكثر. ونحن نعيش هذه المشكلة بشكل واضح وكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا بإمكانهم أن يرجعوا للمحاكم الشرعية وعند رجال الدين حتى يعرفوا الصعوبات المتناهية التي تحصل نتيجة للمشاكل الأخلاقية الناتجة من العشرة والإثارة المستمرة والدائمة -هذا الذي فهمته أنا من السؤال بالنسبة لقضية التعري-.
س: سماحة الإمام لماذا يقف الرجل في الصلاة أمام المرأة وما السبب؟
ج: طبعًا هذا سؤال عن حكم عبادي، من الصعب جدًا أن نقدر نحدد سبب تفصيلي في الدين، الدين فيه غيبية وإن كان فيه تعليل وفلسفة لكن أيضًا فيه شيء من التعبد والغيبية، ربما الرجل يقدر [أن] يقف قدام الرجل أو المرأة في الصلاة أو إذا كان بينهما حائل من ستار أو من فاصل كذا متر حتى يتمكن من صحة الصلاة. ربما فيه تعبير عن الحماية لأن المرء-الرجل أصلب وأقسى وهو يقف في الصفوف أمام الإمرأة. وصفوف الجماعة في الحقيقة كما يقول القرآن الكريم وفي تفسيره تقليد وترويض وتمرين لصفوف الحرب: ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص﴾ [الصف، 4].
صفوف الجماعة تدريب للقتال ولذلك نسمي نحن مقام صلاة الإمام المحراب، محراب يعني وسيلة الحرب مكان صلاة الإمام يُسمَّى المحراب في الإسلام. في تفسير الآية الكريمة: ﴿خذوا زينتكم عند كلّ مسجد﴾ [الأعراف، 31]. الزينة مفسرة بالسلاح، يعني خذوا أسلحتكم، زينة الرجال هو السلاح. فهناك ترابط واسع في منطق الإسلام بين الجماعة وبين الحرب وتحرك المأمومين بشكل منتظم حول القيام والركوع والسجود والقعود، يؤكد هذا التشابه. ربما لأن الرجل أقسى فيريد الإسلام يدربه على أن يحمي الامرأة باعتبار أنها ذات كفاءة في غير الحقل القتالي.
س: باسمه تعالى هل الجنّ موجود؟ ما الدليل على ذلك؟ وما علاقته بالإنسان؟ وهل ظهر أمام الأبصار قديمًا أو حديثًا ولماذا في الحالتين؟
ج: إذا كان السؤال سؤالًا دينيًا وليس سؤالًا فلسفيًا... يعني مرة يسأل السائل سؤالًا علميًا يعني ما هي الأدلة العلمية والتجارب المادية التي تؤكد وجود الجنّ؟
أنا لا أملك دليلًا ماديًا على وجود الجنّ إطلاقًا، ولكن لا أملك أيضًا دليلًا علميًا على نفي الجنّ. فعلى الصعيد العلمي، لا دليل على وجود الجنّ ولا على نفي الجنّ، أما إذا كان السؤال دينيًا، يعني ما هو رأي الإسلام في الجنّ؟ فالقرآن صريح بأن الجنّ موجود.
عشرات الآيات تسمي الجنّ وتبحث عن الجنّ، عن إيمان الجنّ، وفسق الجنّ ونشاط الجنّ، وأشياء كثيرة موجودة في القرآن. حتى [إن هناك سورة] في القرآن باسم سورة الجنّ. فالجنّ موجود طبعًا.
أما إنه هل ظهر أمام الإنسان [أو] ما ظهر وهل يؤثر على الإنسان أو لا يؤثر. أنا مسلكي على أن الجنّ لا يؤثر في حياة الإنسان، وأقول إن الله سبحانه وتعالى ألطف من أن يسخِّر موجودًا غير مرئي لا يمكن للإنسان أن يتصرف ويحول ويؤثر فيه، أن يتأثر به. وكلمة الجنّ من الخفاء، من الظلام يعني المخفي، أما أنه ظهر أو ما ظهر أمام الإنسان، هناك أكاذيب كثيرة، وكلٌّ يدَّعي أنه رأى الجنّ ورأى الجنّ، أنا أعتبر أن هذا كلّه أكاذيب. ولا أتمكن أن أصدق ما يقال حول الجنّ، من جملة ما قيل حول الجنّ أن في هذا البيت يوجد أعداد كبيرة من الجنّ، لكن نحن فتشنا كثيرًا في الغرف والحمامات والمستودعات، وما جدنا شيئًا. خافوا منّا.
س: سماحة الإمام، قال الله في كتابه العزيز: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾ [الكهف، 46] صدق الله العظيم. فلماذا ذكر المال قبل البنين؟ وتفضلوا بقبول الشكر والاحترام.
ج: ربما لأن الإنسان يملك المال أولًا ثم يملك الابن، أليس كذلك؟ أول الشيء، الواحد بعد أن يعيش يريد أن يملك بعض المال، من ثمّ يتزوج ومن ثمّ يصير عنده أولاد، فربما الترتيب الطبيعي المال قبل الابن.
ممكن الواحد يبحث في الموضوع ولا أحب أن أقول بشكل مرتجل الفكرة، إذا يسمح السائل أن أفكر بالموضوع ونتحدث إن شاء الله وأجيب عن السؤال. أما الآن ما عندي شيء واضح بالموضوع، وفي التفسير يجب أن نكون ملتزمين.
س: سماحة السيد الإمام "المتوالي" تحية وبعد، هل للمجلس الشيعي مدة معينة؟ وكم المدة الرئيسية؟ ومن يُحلّ؟ وكيف الانتخاب؟
ج: في نظام المجلس مطبوع إذا أحب السائل أن يُقدم له نسخة موجود ومطبوع القانون الأساسي للنظام الداخلي وبإمكانه أن يطّلِعْ عليه.
وبصورة موجزة، أولًا، "متوالي" اسم قديم للشيعة في لبنان مشتق من كلمة الولاية لأنه نحن الولاية في مذهبنا تلعب دورًا رئيسيًا. أما المجلس فمدته ست سنوات وبعد ست سنوات يُحَلّ طبعًا، ثم ينتخب من مجموعة الطاقات -طاقات الطائفة الشيعية- المؤلفة من العلماء والقضاة والمهندسين والمحامين والوزراء والنواب مؤتمرًا عامًا يشمل حوالي ألف شخص من الطائفة الشيعية هم الذين ينتخبون المجلس المؤلف من ثلاثة وأربعين عضوًا. 19 عضوًا منهم نواب والبقية مدنيين ورجال دين ثم هؤلاء المجموعة الثلاثة وأربعين عضوًا يجتمعون وينتخبون رئيس المجلس. وبعد ست سنوات تنتهي مدته وبإمكان السائل أن يعثر على نظام المجلس موجود هذا مطبوع.
س: سماحة الإمام السيد الملهم، ما الخلاف الذي نشأ بينكم وبين كامل الأسعد، علمنا من الجميع في الجنوب وغيره أنه متأزم منذ إعلانكم إضرابًا عامًا وعارضه الأسعد وغير ذلك مع العلم الخلاف موجود على ألسنة جميع الجنوبيين؟
ج: أولًا، أنا لستُ ملهمًا، الإمام الملهم، لستُ ملهمًا، إنما رجل عادي يحاول أن يفهم بتفكير وبسعي وباستشارة، أما بخصوص خلافنا مع الرئيس كامل بك فليس هناك أيّ خلاف، ولا مجال لأيّ خلاف، لأنه أنا عملي كرئاسة المجلس الشيعي عمل ديني [...]