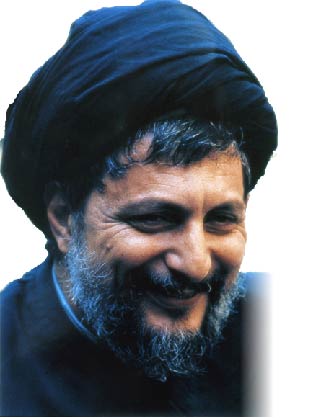* مخطوطة من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بتاريخ 7 شباط 1970 في معهد القضاة- بيروت.
بسم الله الرحمن الرحيم
في الحقيقة، إن هذا الشرف الذي أوليتمونيه، وهو إقامة الحلقة الأولى من سلسلة الدراسات القضائية أمام هذه النخبة من عقول الناس وقلوبهم، حادثة تاريخية في حياتي أعتز بها وأسجلها في صفحات عمري بكل اعتزاز، وأرجو أن أتمكن من تأدية الدور الملقى على عاتقي في التحدث عن "القضاء الرسالة". وطالما أنتم تمارسونها وتعيشونها فسوف أكون بإذن الله في هذه المحاضرة أو في هذا الحديث أؤدي دور المذكر والواعظ لا دور الموجه والمحاضر.
التعاليم الدينية تؤكد أن الكون قائم على أساس العدل والحق وتؤكد أيضًا أن العلاقات القائمة بين الموجودات هي علاقات منظمة في غاية التنظيم وتؤكد أيضًا أن الكون يتحرك بانتظام نحو الأفضل. القرآن الكريم بعد التأكيدات في سورة الرحمن يقول: ﴿والسماء رفعها ووضع الميزان﴾ [الرحمن، 7] ما معنى وضع الميزان عند ارتفاع السماء سوى التعبير على أن كل شيء في هذا الكون موزون ودقيق ومنظم. وفي القرآن الكريم أيضًا: ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين * ما خلقناهما إلا بالحق﴾ [الدخان، 38-39].
والكون سائر نحو الحق والعدل، لأن الكون خلق على صورة الخالق في صفاته وأسمائه. والخالق العادل، خلق الكون القائم على أساس العدل: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط﴾ [آل عمران، 18]. هذه هي الصورة التي يعطيها الدين عن الكون: عالم في غاية التنظيم وكل شيء فيه موزون وكل شيء حسب له حساب ووضع له قدر. أما الشواذ التي نشاهده في الكون كالزلازل وبعض مظاهر الفوضى والأحداث مثل الطوفان وأمثال ذلك، فلهذا الشواذ أيضًا قاعدة والقاعدة حسب ما نفهم من التعاليم الدينية هي المزيد من التأكيد على الإنسان للسيطرة على الكون وعلى القوى الكونية.
فالإنسان منذ البداية لو لم يواجه البرد والحر والعدو لما كان يسعى ويبذل جهده للتغلب على هذه المشاكل ولما كان مسرعًا في طريق اكتشاف الحقائق. وجود الزلازل والمحن سياط على كاهل الإنسان يحضه على السعي الزائد في سبيل المعرفة. ووجود الأمراض سوط على الإنسان حتى يتحرك بسرعة لأجل اكتشاف الحقائق والعوامل الكونية والسيطرة عليها، فالكون بأجزائه وقواه وتحركاته ومستقبله قائم على أساس العدل والحق. والعدل وضع الأمور في نصابها ووضع الأمر في موضعه.
هذه هي الصورة الكونية التي ترسمها الأديان السماوية وهذه الرؤيا أو هذا التفسير الديني عن الكون هو تفسير تربوي يقال لنا حتى نطبق حياتنا على ضوء هذه الرؤيا وحتى ننسجم في سلوكنا مع التحرك الكوني ومع الوضع الكوني العام.
ولهذا نجد أيضًا بعد الآية الكريمة التي تلوناها ﴿والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تطغوا في الميزان﴾ [الرحمن، 7-8]. أيها الإنسان، إذا أردت أن تنجح وإذا أردت أن تخلد وإذا أردت أن تستفيد وأن تكون منسجمًا مع الكون بعوامله وبطاقاته وبقواه، يجب عليك أن تكون عادلًا في سلوكك، منظمًا في حركاتك، متزنًا ومنظمًا في تصرفاتك، وهكذا نجد أن هذه الرؤية الكونية توحي للإنسان بأن يجعل عمله منسجمًا مع خلق الكون وقوى الكون.وهذا المفهوم هو الذي يعبر عنه الدين في بعض الآيات بالسجود وفي بعض الآيات بالصلاة وفي بعض الآيات بالتسبيح: ﴿ألم ترَ أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب﴾ [الحج، 18]. والسجود في اللغة غاية الخضوع، فإذا قلت إن الموجودات تسجد لله فمعنى هذا أن الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وجميع الموجودات تطبق بدقة وبانتظام الدور الكوني الذي كُلِّفت بأدائه في هذا المسرح الكبير الذي اسمه الكون. كل من هذه الأجزاء يؤدي بغاية الدقة والانتظام ومن دون تخلف أو خيانة أو انحراف واجبه الكوني أو بتعبيرنا الديني واجبه الإلهي. وأمام هذا الكون الكبير يقف الإنسان فيجد نفسه في المحراب الكبير، فإذا أراد أن ينسجم مع الكون الكبير فعليه أن يكون ساجدًا في هذا المحراب وهكذا إذا أراد أن يكون منسجمًا مع جسمه الذي هو من هذا الكون الكبير والذي هو أيضًا يخضع بكل دقة وبكل انتظام والتزام للسلوك الكوني العام. فالقلب يؤدي دوره بكل دقة وكذلك الرئة والنبض والدم والمعدة وكل جزء من الجسد يؤدي أدواره الكونية الطبيعية إلا إذا عرض عليه عارض. وهذا أيضًا قانون عام وخضوع للسيطرة العامة التي تفرضها الأمراض والنواقص والشواذ في الطبيعة.
إذا كان الإنسان يريد ان يكون منسجمًا مع الكون الكبير ومع نفسه أيضًا فعليه أن يكون أيضًا بكل دقة وانتظام مؤديًا لدوره الكوني وبتعبير آخر أن يكون ساجدًا ولهذا وفي هذه الآية الكريمة نجد: ﴿ألم ترَ أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض﴾ [الحج، 18] في أول الآية يسجد جميع من في الأرض، وفي آخر الآية وكثير من الناس. والفرق بين الصدر والذيل أنه في صدر الآية جميع من في الأرض يسجد: الجانب الأرضي منا وهو جسدنا أيضًا خاضع للنظام الكوني، لكن الجانب الإنساني ﴿وكثير من الناس﴾ [الحج، 18]، الإنسان الإرادة، الإنسان الاختيار عليه أن يسجد. ولكن كثيرًا منهم يسجدون لا جميعًا. فإذًا، هذا الدور الكوني أمام الإنسان-في منطق تربوي- يجعلنا نتزن وننتظم وبالتعبير الديني نسجد أو نسبح: ﴿يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض﴾ [الجمعة، 1] التسبيح لله هو الشهادة بتنزيه الخلق عن الفوضى والانحراف والشذوذ. والصلاة ﴿والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه﴾ [النور، 41] الموجودات ساجدة لله ونحن سجودنا سلوكنا المنسجم مع الكون وقواه وتحركاته. على هذا الأساس، لكي نتمكن أن نسلك في حياتنا... الإرادة في حياتنا التي نحن مخيرون فيها نتمكن من أن ننسجم مع المجموعة الكونية، علينا أن نسلك السبيل الذي يسمى بالرسالة ويسمى بالدين، ويسمى بالناموس، ويسمى بملكوت الله. وهكذا إذا أردت أن أنسجم في سلوكي مع جسمي الذي هو خاضع للإرادة الكونية إذا أردت هذا وذاك فعلي أن أسلك سبيلًا خاصًا يعرف بالرسالة الإلهية التي لها مراحل ثلاث.
فالمرحلة الأولى من رسالة الله: مرحلة الضمير الذي هو النبي الباطن في مصطلح الأديان. والمرحلة الثانية من الرسالة الأنبياء الذين نتمكن أن نسميهم بعقول الكون وضمير الكون، الأنبياء بعد الضمير يحددون الخط ويرشدون الإنسان إلى السلوك الذي ينسجم فيه مع نفسه ومع الكون كله. وهناك مرحلة ثالثة وفي طليعة هذه المرحلة الثالثة القضاء. فإنا إذا خضعنا لسلطة الضمير أو لسلطة الأنبياء أدينا الواجب. أما إذا انحرفنا عن عمد، وما أكثر من ينحرف عن الدين وعن الضمير وعن الرسالات عن عمد، أو انحرفنا عن خطأ وما أكثر من ينحرف عن السبيل نتيجة لطغيان مصالحه وعواطفه وعقده ومشاكله ورواسبه الثقافية أو الاجتماعية. هنا أمام الانحراف العامد أو الانحراف الخاطئ يجب أن يكون [هناك] ضمانة في المجتمع حتى تعيد الحق إلى نصابه، وهل هناك من يعيد الحق إلى نصابه غير القضاء؟
إذًا، القضاء هو من المرحلة الثالثة من الرسالة الإلهية الكونية التي على أساسها يكون الإنسان جزءًا حقيقيًا من هذا الكون منسجمًا مع الحركات الكونية. أما إذا انحرف الإنسان فهو جسم شاذ، والطبيعة والكون أيضًا ينبذان الجسم الشاذ، كما أن جسد الإنسان ينبذ الموجود الغريب غير المنسجم مع طبيعة الجسد، الجسد يرفضه، يتحمله ساعة أو يومًا أو فترة من الزمن، ثم يرفض الجسم الغريب حتى ولو كان دواء، والكون أيضًا ينبذ الموجود الشاذ والمنحرف ويخلد الموجود الذي يسلك سبيلًا منسجمًا مع الكون كله.
نحن أمام صروح من العلم والصناعة والأخلاق والتجارب، هذه الصروح من صنع الإنسان المستقيم أما الذين انحرفوا، أما الذين سلكوا سبلًا غير منسجمة مع الكون وطاقات الكون فقد ماتوا ومات معهم أثرهم ونبذهم الكون، حملهم فترة من الزمن خمسين أو ستين سنة أو مائة أو مائتي عامًا ثم نبذهم فنسيهم الدهر والتاريخ ولا يبقى لهم أثر في الكون، أما الخالدون فهم الذين سلكوا سبيلًا منسجمًا مع الكون. لكي يكون الإنسان عضوًا طبيعيًا في هذا الكون، مواطنًا صالحًا في وطن الكون، عليه أن يطبق وينسجم مع القوانين الكونية ومع حقيقة الحياة. وهذا الانسجام يأتي بطريق إطاعة الضمير والأنبياء والقضاة.
فالقضاء هو حامي رسالة الله، وحامي انسجام الإنسان مع الكون، بالتالي حامي خلود الإنسان وبقائه في الكون. القضاء متمم للرسالة الإلهية، متمم لرسالة الله أيضًا، ولهذا نجد أن الإنسان المخطئ المنحرف غير المستسلم للعدل يعد في التعبير الديني غير مؤمن بالرسالة، ألا تكفينا هذه الآية الكريمة: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا﴾ [النساء، 65] إذا ما حكّموا العدل، ولا استسلموا للعدالة ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾... هؤلاء، ليسوا من المؤمنين. المؤمن الحقيقي هو المؤمن بضميره، المؤمن برسوله والمؤمن بقضائه، حلقات متسلسلة لا تنفصل إحداها عن الأخرى.
فإذًا، القضاء رسالة، وخطورة هذا الأمر تبدو حينما نعرف أن الكون ينبذ المنحرف، فإذًا، القضاء يؤدي دورًا مصيريًا لا دورًا تصحيحيًا في حياة الإنسان، فلا وجود حقيقي للإنسان من دون القضاء ومن دون العدالة.
إن الإنسان الذي يعيش في الخط المنحرف لا يخضع للضمير ولا للرسالة الإلهية ولا للتعديل الصحيح القضائي. إنه يعيش حياة غريبة عن الكون، محكومة بالفناء، لا وجود له حقيقيًا إذا رفض أن يخضع للعدالة. وعلى هذا الأساس، نتمكن أن نقدر خطورة هذا المركز العظيم. أعتذر وأقول: قد يكون الإنسان العادي واعظًا لمن هو أكبر منه ولمن هو أخبر منه فإذا كنت واعظًا كما قلت فلي الحق كل الحق لأنكم أوليتموني شرف التحدث عن القضاء الرسالة. إن القاضي طالما أنه خليفة النبيين والرسل الذين يتحملون إبلاغ الدين، طالما كان الأمر بهذه الدرجة من الخطورة نتمكن أن نعرف أن الانحراف في القضاء يعطي خسارة مضاعفة، لأن الانحراف في القضاء:
أولًا: يقطع ويبتر الرسالة الإلهية حيث أن كثيرًا من الناس يخطئون في تطبيق الحقيقة أو يتعمدون الخروج عن الحقائق.
وثانيًا: إن الانحراف في القضاء يعجل في افناء الإنسان لأن المنحرف أو المخطئ إذا شُجِع على موقفه، وإذا استند إلى ما يسمى بالعدالة، فمعنى هذا التعجيل في الشذوذ والإسراع في الانحراف والبتر السريع للرسالة الإلهية على الأرض. ولهذا يقول الحديث الشريف: "لا يجلس هذا المجلس (مجلس القضاء) إلا نبي أو ولي أو شقي"... لا واسطة بينهما: إما عادل فهو ولي الله ورسول الله ومتمم رسالة الله، وإما شقي أقل من الإنسان العادي، لأن الإنسان العادي لا يعجل بالانحراف ولا يبتر الرسالة الإلهية، بينما القاضي المنحرف يبتر ذلك ويعجل في نهاية الكون، وفي شذوذ الإنسان، ونسيان الكون له وعدم خلوده.
﴿ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيدًا﴾ [النساء، 60]. أرجو الانتباه لهذه الكلمات: "الذين يزعمون أنهم آمنوا ويتحاكمون إلى الطاغوت" والطاغوت هو القاضي المنحرف، حسب التعبيرات الدينية، لأن أقوى طغيان هو الطغيان في النبع والطغيان في المصدر كالرسول المنحرف. ولكن الله لا يسمح للرسول أن ينحرف ولهذا يؤكد في القرآن: ﴿ولو تقوَّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين﴾ [الحاقة، 44-46]، لن يسمح الله لرسوله أن ينحرف. ولكن القاضي إنسان، رسول مسموح له ومؤجل أمره، وبإمكانه أن ينحرف لأجل هذا الطغيان الخطير، سمي بالطاغوت ومراجعة القاضي المنحرف يتنافى مع الإيمان "يزعمون أنهم آمنوا بالله ويتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به"، ثم هذا تنفيذ لإرادة الشيطان.
فمن يتحاكم إلى الطاغوت فهو في طريق الضلال البعيد لأن الشيطان يريد ﴿أن يضلهم ضلالًا بعيدًا﴾ [النساء، 60]، ولأن القضاء رسالة فعلية وعلى القاضي -أعتذر من جديد بأن أكون واعظًا- أن يحتفظ بالصفة الرسالية، طالما تحمل مقام الرسالة وجلس في مكان لا يجلسه إلا الرسول أو الوصي أو الشقي فعليه أن يحتفظ بالصفة الرسالية. وما هي الصفة الرسالية؟ في المصطلح الديني نقول السماوية، ما هي السماوية وأين هي السماء؟ هل الأجواء اللازوردية هي السماء، أم النجوم التي هي في السماء؟! السماوية هي الابتعاد عن المصالح الخاصة والنزعات الأرضية والعلاقات المادية، الابتعاد عنها ذلك الذي نسميه في منطقكم بالتجرد والنزاهة، فكلما ارتفعت السماوية، ولماذا السماوية، لأن الإنسان في حياته معرض لا للعمل ضد الحق فحسب بل لعدم رؤية الحق أيضًا نتيجة لبعض العوامل الداخلية.
ولهذا فعلى القاضي أكثر من غيره كما أن على غيره أيضًا فعلى القاضي أيضًا أن يكون سماويًا بعيدًا عن العلاقات المادية... وبتعبير محلي، بعيدًا عن المصالح الخاصة من خوف وطمع، وحاشا للقاضي أن يخاف أو أن يطمع، لأن الله ألبسه ثوبًا رسوليًا رفيعًا، وجعله موضع ثقة، فهو الذي لا يخاف ولا يطمع، فإذا خاف أو طمع فما هو المنتظر من غيره؟! التنزه أي السماوية عن المصالح عن الخوف أو الطمع وعن العواطف، وما أكثر ما تتحكم العواطف في نفس كل إنسان، وعن الرواسب، حتى الرواسب الثقافية وهنا تتكون عقدة العقد: الرواسب الاجتماعية والرواسب الثقافية في حياة الإنسان قد تجعل الإنسان ينظر إلى الشيء بمنظارين. ومن الرواسب الثقافية الرواسب الدينية مع الأسف، الرواسب الطائفية، فلنكن صريحين في هذا الحقل.
الحق حق لم يلد ولم يولد كما أن الله ﴿لم يلد ولم يولد﴾ [الإخلاص، 3]. ما المعنى من القول أن الله ﴿لم يلد ولم يولد﴾ [الإخلاص، 3]، أنه ليس له أولاد ولا أحفاد ولا آباء ولا أجداد ولا أمهات، وبالتالي أن الله بلا عشيرة، فليس له عشيرة ولا أزلام ولا أحزاب ولا انتسابات، فهو مطلق غير منتسب، فـ ﴿لم يلد ولم يولد﴾ [الإخلاص، 3]، يعني منزه مثالي، وكل حق في الطبيعة وفي الكون ﴿لم يلد ولم يولد﴾ [الإخلاص، 3]. فالعلم لم يلد ولم يولد، أي إنسان درس وتعب يتعلم، وأي إنسان، ولو كان أبوه عالمًا إذا لم يدرس لا يتعلم، فليس بين العلم وبين الإنسان من ربط خاص، العلم يأتي بعد التعب والجهود، فالعلم لم يلد ولم يولد والحق والعدل لم يلدا ولم يولدا. فلا يمكن أن يقاس الحق بصاحب العلاقة، إذا كنت أنا أكون على حق، وإذا كان غيري يكون على باطل. هذا الحق على هذا الأساس ولد، لأنه وجد له أب ووجد له قريب، يجب النظر إلى الحق والعدل نظرة منزهة، نظرة سماوية ننظر إليه من خلال مقياس رسالي بعيدًا عن المصالح والعواطف والرواسب والعقد النفسية.
وهنا أيضا تكمن المشكلة، فصحيح أننا غير مكلفين إلا في حدود اختيارنا ومعلوماتنا، ولكننا مع الأسف في كثير من الأحيان نشعر بالعقد: العقد السلبية والعقد الايجابية في حياتنا، فهذه العقد تخيل إلينا وتشرح لنا من خلالها الحق على أكثر من شكل إذا لم نحاول أن نتجرد وأن نتعود على التجرد عن المصالح والعواطف والرواسب والعقد، وبالتعبير الديني ألا نكون عدولًا...
والعادل في الفقه، من له ملكة الاجتناب عن المعاصي وتعود على ممارسة العدل. هذا هو العادل، لا من يعدل مرة أو مرتين بل من أصبح متعودًا على أن تصدر عنه العدالة بسهولة. المقصود أن الرسالة السماوية تصبح جزءًا من وجود الإنسان القاضي. وإلا فطالما لم تمارس هذه التصفية المسبقة يرجع إلى الخطأ، ويرجع إلى الانحراف، وتعود المشكلة الكبرى التي تنتظر مصير الأمة.
وفي آداب القضاء اهتمام واسع بالترفع والتجرد حتى في الشكليات. الشريعة تأمر بتساوي المتنازعين أمام القاضي، حتى في الجلوس والمخاطبة، والبدء وتقسيم النظرات، حتى لا يشعر أحد المتنازعين أن المتنازع الآخر محظوظ والحق منسوب ومولود. فالحق أينما وجد حق، والباطل أينما وجد باطل، لم يلد ولم يولد. وهنا كنت أحب أن أعلق تعليقًا صغيرًا على أن ملاك الرحمة معصبة العينين، ولكن من حسن الحظ رأيت أن القضاء اللبناني ليس له هذا الشعار. إن ملاك الرحمة معصبة العينين، الشعار العالمي للقضاء، أتصوره رمزًا بدائيًا، كان القاضي سابقًا يجب أن يسد عينيه عن كل شيء حتى لا ينحرف. كان من الممكن أن يسد الإنسان عينيه، فيمشي حين كانت الطرق واضحة سهلة، أما وأن الحقوق تعقدت والتوت وتشابكت وازدادت الصعوبات الفنية وتضاعفت أشكالها وألوانها، فالعين المعصبة لا تنفعنا وعلى القاضي أن يفتح عينيه، وملاك الرحمة عليها في هذه الأيام أن تفتح عينيها، ولكن لا تنظر إلا من خلال عينها المجردة لا من خلال النظارات أو الزوايا أو المصالح. إن الذي يلبس النظارات الحمر يرى العالم باللون الأحمر، الذي ينظر إلى الحق، وإلى الكون من خلال عاطفته ومصلحته أو ثقافته أو طائفته لا يكون بطبيعة الحال بهذا الشأن العظيم.
ولأن القضاء رسالة، فالحكم الصادر عن القاضي هو إمام لحكم الله وإكمال لرسالة الله، والحكم كما تعلمون مؤلف من جزأين: جزء هو القانون، وجزء هو الشخص، يتركبان فيؤلفان الحكم. فالقانون موجود والرأي والضمير موجود، حينما يجتمعان يؤلفان الحكم. فالحكم طالما أنه حكم إلهي، فيجب أن يكون كلا الجزأين إلهيًا منزهًا. وهنا أشعر بالصعوبات البالغة التي يعيشها القاضي حينما يصدر القانون كيفيًا أو مصلحيًا أو عاطفيًا أو راسبيًا... سمه ما شئت، حينما تصدر القوانين تحت الضغط وتحت الطلب وتحت المصلحة وحينما تصدر القوانين لأجل السياسة والأهواء والآراء فضمير القاضي حينما يريد أن يحكم يثقل بشكل عنيف. ماذا يصنع القاضي وعليه أن يحكم في إطار القانون الصادر، ولكن من حسن الحظ أعطي للقاضي إمكانية التحليل والتفسير وكثيرًا من الحرية في هذا الإطار.
وبكل أسف هذه طبيعة القوانين الوضعية، فخطأ شخص في مجلس التشريع، أو رغبة شخص، أو كسل شخص أو تثاقل إدارة قد يؤدي إلى صدور قانون وزيادة مادة، ونقيصة مادة، وتمر المواد ولا يعرفها أحد، القوانين الوضيعة مشكلة كبرى أمامكم. كنت أتمنى القول أن القوانين الوضيعة مهما كانت لا تتمكن أن ترضي ضمير القاضي، لأن القاضي الرسول يشعر بطبيعة الحال وبنفس الوقت بأن الذي أصدر القانون كان منسجمًا مع مصالحه وأهدافه ورواسبه وثقافاته ومع اتخاذه بعض المعلومات عن القوانين الوضعية الأخرى الموضوعة في بلاد أخرى... لهذا من الأفضل أن يتبنى القضاء في لبنان قانونًا سماويًا مع وجود الاجتهادات والآراء والتطوير في إطار قانون مقدس، وأننا نتمكن من وضع قانون ذي إطار مقدس، ذي إطار سماوي، كما نحن نفترضه مع إمكانية التحرك والتطور ومع البعد عن عقدة واضعي القانون، فحينئذ تخف المشكلة. وعلى كل حال فالتشريع من حق الله بصورة خاصة، والقضاء من حق الإنسان، فعلينا أن نحاول تقريب التشريع إلى صاحب الحق، وتقريب بواعث التشريع إلى بواعث القضاء وما أصعب هذه المهمة. ساعدكم الله على الحكم في إطار القوانين القائمة.
أيها السادة الكرام،
رأيتموني أتحدث كثيرًا في المثاليات السماوية والنزاهة والرسالة وأمثالها، ماذا أصنع؟ كان الإنسان في سابق الزمن يعيش بعقله مؤمنًا في المطلق بالله. وهذا الإيمان كان يحصل من اقتناعه ومن حياته الخاصة، فكان الطفل في سابق الزمن يولد فيجد أمامه وجهًا لله هو وجه أمه. إن أم الطفل في سابق الزمن كانت تمثل الله أمامه لأنها كانت مطلقة في الرحمة وفي التضحية وفي السعي وفي التربية، لا توفر لنفسها لحظة ولا تجعل لنفسها حصة من الحياة، لا لبسًا ولا جسدًا ولا نومًا، الأم كانت مطلقة في سابق الزمن وجه الله أمام الطفل فكان الطفل يرى الله بعينه بعدما يراه بعقله. ثم كان يجد في أبيه مطلقًا، مطلقًا في التربية، مطلقًا في الدفع، مطلقًا في الرعاية، مطلقًا في الحماية، مطلقًا حتى وإذا مات هو يحتفظ بمصالح طفله. ثم كان يدخل الطفل في المدرسة فيجد مطلقًا جديدًا هو المعلم الذي يعلم ويربي ويسمع ويحاول ويفتش ويرعى ويسهر ليلًا نهارًا حتى يربي تلميذه. ثم كان يتنقل إلى المجتمع فيجد في الشيخ مطلقًا وفي القاضي مطلقًا.
ألا وأن الطفل في هذا اليوم يريد أن يعيش إيمانه بصورة تجريدية، فلا يرى في أمه مطلقًا، ولا في أبيه مطلقًا، ولا في معلمه مطلقًا، ولا في شيخه وكاهنه مطلقًا، هل يبقى له إيمان؟ الأم أصبحت نسبية تخدم ساعات وتحافظ على جمال جسدها وراحة شعرها وأناقة زيها وراحة ليلها ونهارها خوفًا من التشويه. أصبحت الأم هي الإنسان وقد كانت سابقًا إلهًا وما كانت إنسانًا، إنها تريد اليوم أن تحتفظ بشخصها وجسمها ولبسها وراحتها، ولهذا كثيرًا ما تتنازل عن الأمومة فتعطي هذا الدور للمؤسسة أو الميتم أو مدرسة داخلية أو مربية أو خادمة أو صانعة، لهذا لا يجد الطفل أمامه مطلقًا باسم الأم والأب والمعلم.
ماذا نقول عن المعلم الذي يضرب اليوم من أجل تسع ليرات أو عشر ليرات مع احترامنا لحقوقه المعيشية؟ ماذا نقول عن المعلم الذي لا ينتظر حتى تنتهي ساعات دوامه، لا ينتظر حتى يؤدي جميع ما عليه من الحصة، فيعيش وكأنه آلة، أين المطلق، أين التجسيد؟ إذًا، الطفل يعيش إيمانه تجريديًا، أصبح كل شيء نسبيًا، وكل شيء محدودًا، أو أصبح المطلق من أساطير الماضين الذين حاولوا أن يسيطروا على الناس ويسخروا الناس، ويستغلوا الناس، ويستعمروا الناس، فلا إطلاق في البيت. أين هو المطلق الذي لا نراه في أمنا ولا في أبينا ولا في شيخنا ولا في كاهننا ولا في معلمنا ولا في حكومتنا ولا في أي شيء آخر؟!
حينما أجد هذا الواقع لا أشك في أننا نعيش في فترة شاذة من حياة الكون، لن نبقى في الكون لأننا لا نعيش الإطلاق لأننا لا ننسجم مع الرسالة القضائية.
أيها القضاة،
بإمكاني أن أقول: أنتم الأمل الوحيد، بإمكانكم أن تصححوا الكثير من الأخطاء، مع العلم أن المجتمع كجسد واحد، فساد القلب يؤثر على فساد الكلى، وعفونة الإصبع تؤثر في السخونة، فالحرارة والقشعريرة والمرض والصحة والنظافة في الجسد يُنظر إليها كمجموعة من الأجزاء. والمجتمع نفس الشيء: فساد الإدارة يؤثر في فساد القضاء، وفساد السوق والتاجر يؤثر في فساد الإدارة، وفساد التعليم يؤثر في فساد الآخرين، هذه حقيقة... ولكن اليوم يوم الجهاد، والجهاد هو الصمود ورفض الفساد والتأثر الخارجي ورفض التأثير من الفاسدين على الإنسان، فإذا تمكنا أن نثبت أقدامنا وأن نثبت، فيصبح بإمكاننا أن نرفض الفساد الهائل. ثم أنه يعيننا على صلاحنا، وعلى مهمتنا ضمائر الآخرين، حيث أن لكل فاسد ضمير يوبخه ويعيننا على توجيه إرادته للتقبل وهذا سر نجاح الأنبياء.
أي مانع من أن يقف القضاء قويًا نزيهًا صامدًا؟ ما المانع أن يكون القاضي مطلقًا بعد أن فقد المجتمع المؤمن كل مطلقاته وكل ممثلي الله على أرضه؟ ما المانع من أن تبقوا أنتم مطلقات على الأرض فتنفِّذوا الإصلاح من أية نقطة بدأنا؟ بإمكاننا أن نصلح، ولكن أنتم بيضة القبان: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط﴾ [المائدة، 8]، والله هو قائم بالقسط: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ [النساء، 58]، الحكم بالعدل أداء الأمانة الإلهية الملقاة على عاتقكم.
ماذا أقول وكيف أخاطبكم أيتها الآمال الوحيدة، الأمل الوحيد في صلاح مجتمعنا، من أولى منكم أن يحكم بالعدل؟ قد تقولون إنكم تحكمون بالعدل وأنا أعترف بذلك جزئيًا. وقد تقولون إنكم تحكمون بالعدل من خلال إمكاناتكم فأنا كنت أتمنى أن أرى (وأعتذر مما أقول إذا كانت الموعظة فيها شيء من المرارة فسوف تُنسى) كنت أتمنى أن يُلاحق مسؤول كبير أو مجرم كبير أو أن يُلاحق شخص منحرف في الإدارة أو أن يُلاحق شخص اتهم بشيء ما. متى تريدون أن تستفيدوا من هذه الإمكانات؟ أنتم بإمكانكم أن تحاكموا كل شخص، قد تقولون إن هذا في الكتاب مكتوب، أنكم تحاكمون كل شخص، ولكن إذا جربتم وجاهدتم ماذا سيكون بعد ذلك؟ لماذا لا تلاحقون الكبار الذين هم سبب فساد هذه الأمة وانهيار هذا البلد وكفر الناس بكل شيء؟ لماذا لا تلاحقونني أنا ولا تلاحقون أمثالي؟ هل هناك من طريقة لإصلاح هذا المجتمع إلا أنتم؟ إذا أمسكتم بقوة وبحزم وبعدالة رقاب المنحرفين أو المجرمين أو المخطئين فليكن ما يكون.
أتمنى ذلك لأن في هذا ضمانة لبقاء هذه الأمة، وإذا قلنا إن الإطار المعطى لنا والإمكانات الواقعية التي نعيشها لا تسمح لنا بذلك، فقد عدنا إلى الحلقة المفرغة، وأصبحنا نسبيين لا مطلقين، جزء من هذا الكل وعضو من هذا الجسد، لا أمل المستقبل.
تمنياتي ودعائي مع كل تواضع واحترام لأنكم أوليتموني شرف التحدث إليكم، أتمنى لكم أنتم على الأقل، أن تحافظوا على البقية الباقية من الأخلاق في هذه الأمة، وما أكثر الأمم التي أنقذت بواسطة القضاء، وكيف لا والقضاء رسالة السماء.
والسلام عليكم.