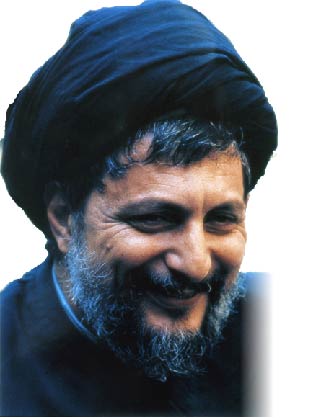* رئيس تحرير مجلة الكلمة المملكة العربية السعودية
* مؤتمر "كلمة سواء" التاسع: موقع الحرية في الاصلاح والتجديد
الجلسة الأولى

منذ تجربة التحديث لمحمد علي باشا في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، الذي أنشأ المطبعة الأهلية سنة 1821م بعد أن ظلت مصر مدة عشرين عاماً بعد خروج الفرنسيين بدون مطبعة، وأصدر صحيفة الوقائع المصرية سنة 1828م، وأسس مدرسة الألسن سنة 1835م لترجمة الكتب العلمية والأدبية من اللغات التركية والفارسية والفرنسية والإيطالية، وقام بإرسال البعثات العلمية إلى أوروبا، وكانت أول بعثة علمية إلى إيطاليا سنة 1813م.. إلى غيرها من أعمال أخرى يمكن أن تساهم في بناء دولة عصرية ومتقدمة في مصر.
وتعززت هذه التجربة وتضاعف الاهتمام بها مع الدور النهضوي والتنويري الذي قام به الشيخ الأزهري رفاعة الطهطاوي، والذي كان وثيق الصلة بتلك التجربة، منذ التحاقه بأول بعثة علمية مصرية إلى فرنسا كإمام وموجه ديني لها سنة 1826م. وتأكد هذا الدور وتنامى وتطور بعد عودته من تلك البعثة إلى مصر سنة 1831م، حيث تولى إدارة مدرسة الألسن للترجمة، وأشرف على تحرير صحيفة الوقائع المصرية سنة 1842م، وقام بترجمة بعض الأعمال الفكرية المهمة والمؤثرة مثل كتاب (روح القوانين) وهو الكتاب الشهير لمونتيسكيو الذي رسخ فيه مفهوم الفصل بين السلطات، كما ترجم كتابه الأخر (تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم)، وفي نظر بعض الباحثين العرب أن هذا الكتاب يماثل ويعادل في فكرته وحكمته كتاب (المقدمة) لابن خلدون. مع العلم أن الطهطاوي في نظر الدكتور فهمي جدعان ربما يكون أول مفكري عصر النهضة العربية الذين اكتشفوا ابن خلدون وتابعوه في إشكاليته. وفي ذلك الوقت شجع الطهطاوي مطبعة الحكومة في بولاق على نشر مقدمة ابن خلدون. ومن المؤلفات الأخرى التي ترجمها الطهطاوي أيضاً كتاب (العقد الاجتماعي) للمفكر الفرنسي جان جاك روسو، إلى جانب مؤلفات أخرى.
كما أصدر الطهطاوي العديد من المؤلفات من أشهرها كتاب (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) الصادر سنة 1834م، وهو الكتاب الذي أعده الدكتور محمد عمارة بأنه يمثل أول نافذ أطل منها العقل العربي على الحضارة الأوروبية الحديثة. ومن مؤلفاته الشهيرة أيضاً كتاب (مناهج الألباب المصرية في مناهج الآداب العصرية) الصادر سنة 1869م.
وما إن انتهت هذه التجربة التي لم يستكمل بناؤها، حتى ظهرت حركة الإصلاح التي نهض بها السيد جمال الدين الأفغاني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبعث بها صحوة ويقظة تأثر منها العالم الإسلامي برمته، وعبر عنها بمفهوم الجامعة الإسلامية، المفهوم الذي كان مؤثراً وفاعلاً في ذلك العصر، وأراد منه الأفغاني التأكيد على حقيقتين: الأولى أن العالم الإسلامي بإمكانه أن ينهض بذاته ومن داخله، والثانية أن العالم الإسلامي ليس بحاجة إلى الغرب في هذه النهضة. وقد أظهر الغربيون انزعاجاً شديداً من هذا المفهوم لأنهم وجدوا فيه تحريضاً على مقاومتهم وممانعة لثقافتهم. كما أن هذا المفهوم ـ الجامعة الإسلامية ـ جاء في سياق الدعوة لإصلاح الخلافة العثمانية لتكون في مستوى حماية العالم الإسلامي ومواجهة مطامع الأوروبيين.
ومن بعد الأفغاني مرت هذه النزعة الإصلاحية بأطوار وتحولات، مثل فيها الشيخ محمد عبده في مصر طوراً أساسياً خصوصاً في الدعوة إلى الإصلاح الديني، ومثل فيها الشيخ عبد الحمن الكواكبي في سوريا طوراً مهماً أيضاً خصوصاً في الدعوة إلى مقارعة الاستبداد، كما مثل فيها الشيخ محمد حسين النائيني في إيران طوراً أخراً في الدعوة إلى الدستورية... إلى جانب أخرين زعماء وجماعات.
ووصلت هذه الحركة الإصلاحية إلى نهايتها مع نهاية وتلاشي الخلافة العثمانية. وبعدها بدأت مرحلة جديدة مع قيام الدولة العربية الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين، التي ورثت مرحلة ما بعد الاستعمار الأوروبي. وقد ظلت هذه الدولة متعثرة منذ قيامها، ومنقوصة السيادة والشرعية، وتكرست فيها طبيعة الاستبداد، وحصادها كان من فشل إلى فشل، وفي كافة المجالات. الوضع الذي أحدث خللاً عميقاً في أنماط العلاقة بين السلطة والأمة في العالم العربي، حيث غيبت الأمة وتضخمت السلطة، وضعفت الدولة.
وإذا كانت الحكومات والدول تتبدل وتتغير في طباعها ومسلكياتها بعد الحروب، كما تغيرت اليابان وألمانيا وغيرهما، فإن العالم العربي الذي مرت عليه حروباً متلاحقة لم تستطع تغييره أو تدفعه نحو الإصلاح. فحرب 1967م كرست ما سمي بإيديولوجيا الهزيمة والإحباط، وحرب الخليج الأولى بين العراق وإيران كانت حصيلتها أن رفعت من وتيرة الخلافات المذهبية بين السنة والشيعة، وأعاقت تطوير العلاقات بين إيران والعالم العربي، وجاءت حرب الخليج الثانية في بداية تسعينيات القرن الماضي لتجعل من العالم العربي منقسماً بشدة على نفسه، إلى حرب الخليج الثالثة وسقوط النظام العراقي حيث بقي العالم العربي على حاله وكأنه عاجز من إصلاح نفسه.
أمام هذا المشهد التاريخي هناك العديد من القراءات المتباينة، والتي حاولت تفسير ذلك المشهد في صيرورته ومآلاته. فهناك من يرى أن تاريخ العالم العربي يمثل تاريخاً متراكماً من الهزائم والفشل. فتجربة محمد علي باشا التي صورتها الأدبيات العربية بأنها من أكثر التجارب كفاءة في بناء دولة عربية عصرية ومتقدمة انتهت إلى الفشل. ومشاريع الإصلاح على قوتها وزخمها لم تستطع إصلاح الخلافة العثمانية التي تلاشت واضمحلت. فالجامعة الإسلامية التي دعا إليها الأفغاني ورثنا من بعدها تفكك وانقسام العالم الإسلامي على بعضه إلى أجزاء متفرقة ومتنازعة فيما بينها. والإصلاح الديني الذي دعا إليه الشيخ محمد عبده لم يستطع أن يطبقه في إصلاح الأزهر. والكواكبي الذي قدم أعظم خطاب في كراهية الاستبداد، وفي كتابه الشهير (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) وإذا بنا نرى الاستبداد متفشياً في عالمنا العربي والإسلامي. والشيخ النائيني الذي دعا إلى الدستورية والحكم المقيد بالدستور، وإذا بالدول تتحول إلى حكومات مطلقة.
وهكذا الحال مع قيام وتتابع الدولة العربية الحديثة التي صادف قيامها نكبة 1948م وضياع القدس وفلسطين، إلى نكسة 1967م، ومن أزمة احتلال الكويت إلى دخول القوات الأمريكية العراق، ومن فشل في السياسة إلى فشل في الاقتصاد، ومن فشل في التربية إلى فشل في التعليم... وهكذا التاريخ يتلاحق بين هزيمة وفشل. الواقع الذي كرس معه الإحباط، وذهنية الفشل، وضمور الإرادة، والإحساس بالعجز، وانسداد الأفق.
وهناك من يرى أن تاريخ العالم العربي يمثل تاريخاً من المؤامرات الخارجية والمنظمة. وحسب هذه القراءة فإن كل تلك الهزائم، وذلك التراكم من الفشل هو بسبب مؤامرات الدول الكبرى المستعمرة والمعادية. فالعامل الخارجي حسب هذه القراءة هو الأساس في الضعف والتراجع الذي وصلنا إليه.
وهناك من يرى أن تاريخ العالم العربي يمثل تاريخاً متتابعاً من الفرص الضائعة التي لم نحسن الاستفادة منها، والتعامل السليم معها. فقد مرت علينا الثورة الصناعية في أوروبا مع بداية القرن العشرين، وكانت حدثاً كبيراً ومدوياً في العالم، ولم نعمل للاستفادة منها. ومرت علينا كل تلك التحولات العلمية والتقنية التي شهدها الغرب واليابان من بعد تلك الثورة الصناعية، ولم تحدث تغيراً حقيقياً في تطوير حياتنا العلمية والتقنية. وتمر علينا اليوم ثورة المعلومات وما سمي بانفجار المعرفة، والتطورات المذهلة في مجالات الاتصال والإعلام والمعلوماتية، ونحن لا نملك إلا أن نظهر الخوف والشك والقلق، وإذا كان من المبرر أن نخاف، إلا أن هذا الموقف بالتأكيد ليس كافياً على الإطلاق، فهو موقف الضعيف الفاقد للثقة بالذات.
كما شهدنا بالسمع والبصر والفؤاد كيف أن العالم يتقلب ويتغير بصورة مفاجئة وسريعة، جعلت من الاتحاد السوفيتي القوة العظمى الثانية في العالم، مع كل ما يملك من جيوش ضخمة، وترسانة هائلة من الأسلحة المتطورة علمياً ينهار بين عشية وضحاها، وتتصدع معه أكبر إيديولوجية صنعها الإنسان في التاريخ الحديث وهي الماركسية. وظلت هذه التغيرات تتراكم وتتلاحق حيث وصلت إلى كافة المعسكر الشرقي في أوروبا، وبقينا نحن نراقب المشهد وبتعجب، ولم نستطع نحن أن نغير ما بأنفسنا، وبقي العالم العربي وكأنه عصياً على التغير. ومرت علينا حروباً وضعت المنطقة على حافة الخطر، وبالذات حربي الخليج الثانية والثالثة، وبعد كل حرب كان يجري الحديث عن إصلاحات جذرية وجوهرية وحقيقية، وعلى الأرض لم نرى إلا غباراً، ولم يكن حصادنا إلا مراً.
وجاءت أحداث 11 سبتمبر التي هزت العالم بقوة شديدة، وكأن حربا عالمية ثالثة قد حصلت في العالم. وهي الأحداث التي جعلت العالم العربي يكون في قلب العالم، ويصبح وكأنه اكتشافاً جديداً إلى العالم، الجميع ينظر إليه، ويفكر فيه، ويتساءل عنه. وأخذ الغربيون والأمريكيون منهم بالذات، يلتفتون إلى هذه المنطقة باعتبارها في نظرهم المنطقة التي لم تصل إليها من قبل رياح التغيير التي هبت على العالم بعد سقوط جدار برلين سنة 1989م، وينبغي اليوم أن تتغير حتى لا تتكرر أحداث 11 سبتمبر مرة أخرى في العالم. لهذا حصل الاهتمام بدفع هذه المنطقة نحو الإصلاح والتغيير برغبتها أو بدون رغبتها، حتى لو اقتضى الأمر تطبيق خيار الحرب كما حصل في العراق. فالعالم يطالبنا بالإصلاح وماذا نحن فاعلون!
فهل نحن أمام تاريخ من الهزائم والفشل؟ أم أمام تاريخ من التآمر والمؤامرات؟ أم أمام تاريخ من الفرص الضائعة؟ والحقيقة إننا أمام تاريخ من التخلف فيه من كل ذلك. فيه من الهزائم والفشل، وفيه من التآمر، وفيه من الفرص الضائعة، ولكن فيه أيضاً محطات مضيئة، ومنها وفي طليعتها شموخ المقاومة الإسلامية وانتصارها على العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.
من خطاب الثورة في زمن، إلى خطاب النهضة في زمن أخر، ها نحن قد وصلنا إلى خطاب الإصلاح، فهل دخل العالم العربي مرحلة الإصلاح؟ وكيف نكسب هذه المرحلة ولا نخسرها كما خسرنا الوعود والآمال في المراحل السابقة؟
ولكي نكسب هذه المرحلة علينا أن نعرف ماذا نريد على مستوى النظر، لكي نكتسب الحكمة والرؤية الواضحة؟ وأن نحدد الشروط والمتطلبات على مستوى العمل، لكي نكتسب الإرادة والعزيمة؟
وفي هذا الشأن يمكن الحديث عن الحقائق التالية:
أولاً: من المؤكد إننا في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة بحاجة إلى مراجعات جذرية وشاملة لأوضاعنا وأحوالنا على مستوى الأبعاد كافة. على أن تنطلق هذه المراجعات من إرادة جريئة وشجاعة تغلب مصالح الأمة والأوطان على أي مصلحة أخرى، وتدفع نحو الإصلاح الحقيقي وليس مجرد التظاهر بإصلاحات فوقية أو شكلية لا تستند على أساس عميق ومتماسك.
ثانياً: لا نختلف على أن الإصلاح الذي نريده ينبغي أن يكون معبراً عن إرادتنا وتصوراتنا وضروراتنا، لا أن يكون مفروضاً علينا من الخارج. والسؤال أين هو الإصلاح الذي نحن نريده ونتحدث عنه. لهذا ينبغي أن نبدأ بالإصلاح الفعلي، قبل أن يفرض علينا بدون إرادتنا ونكون عندئذٍ من النادمين. فنحن أمام أوضاع لا تحتمل تأجيل الإصلاح، فقد أصبح الإصلاح في منزلة الضروريات الواجبة.
ثالثاً: من أين يبدأ الإصلاح؟ هناك من يقول إننا ينبغي أن نبدأ من الإصلاح السياسي؟ وهناك من يقول إننا ينبغي أن نبدأ من الإصلاح الديني؟ والحقيقة إننا بحاجة إلى الإصلاح في هذين المجالين السياسي والديني، وفي غيرهما أيضاً كالإصلاح الثقافي. الإصلاح السياسي مجاله السلطة والقدرة والمؤسسات السياسية. والإصلاح الديني مجاله التصورات والمفاهيم التي تشكل فهمنا ورؤيتنا للدين، والإصلاح في هذا المجال يرتبط بتلك التصورات التي تنزع نحو التعصب والغلو والتكفير، ورفض حق التعددية والاختلاف، وحق الاجتهاد والتعبير عن الرأي. وعن تلك التصورات التي تصور أن الدين لا يتناغم مع المدنية، ولا يواكب الحياة العصرية، وكأن الدين مكانه القرى والأرياف والكهوف وفي مجتمعات الصحراء.
والإصلاح الثقافي مجاله الأفكار ومناهج النظر، بقصد تجديد وتطوير معارفنا وأفكارنا تجاه قضايا مثل التراث والتاريخ والدولة والأمة والتعددية والحرية إلى الديموقراطية والحداثة والعولمة.. وغيرها، ولاستشراف المستقبل بحكمة الثقافة.
رابعاً: إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من مصالحة الدولة مع الأمة، وعودة الدولة إلى الأمة، بعد أن أصبحت الدولة كما يعبر البعض عن حق ضد الأمة. وهذه هي إشكالية الدولة عندنا في مجالنا العربي. في حين أن الأمة في العرف والقانون والتاريخ هي مصدر الشرعية ومصدر السلطة في الدولة. والمقصود من عودة الدولة إلى الأمة أن تصبح الدولة لجميع المواطنين، يكون المواطن فيها مكرماً وعزيزاً، ويستطيع أن يأخذ حقه بدون خوف ورهبة، وبالعدل والقانون. وهذا يتطلب الاهتمام بإصلاح القضاء الذي يرد الحق لصاحب الحق بالعدل والمساواة.
خامساً: لا شك إن هذا الإصلاح بحاجة إلى برنامج منظم ومدروس بعناية، والمشكلة دائماً ليست في القدرة على وضع البرنامج، وإنما في الإرادة والعزيمة القادرة على تحويل البرنامج من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل، وفي الإشراف والرقابة على سير ومراحل التنفيذ والتطبيق. وهذا يتطلب الاهتمام بالإصلاح الإداري في المؤسسات.
سادساً: ينبغي أن نبرهن على عدم التعارض بين الإسلام والديموقراطية، وبين الإسلام والتقدم. وأن بالإمكان قيام ديموقراطية في المجتمعات الإسلامية، وفي ظل وجود الإسلام. وأن بإمكان الإسلام أيضاً أن يقيم ديموقراطية تتكيف مع طبيعة ومكونات المجتمعات الإسلامية. كما أن الإسلام فيه أقوى البواعث نحو التقدم، وبالتالي فإن المجتمعات الإسلامية بإمكانها أن تتقدم في ظل وجود الإسلام، وبإمكان الإسلام أن يدفع هذه المجتمعات نحو التقدم. أقول هذا الكلام حتى لا ينحى الإسلام جانباً كما يرغب البعض بدعوى الإصلاح، أو يكون الإصلاح متعارضاً مع الدين من ناحية الهوية أو الأخلاق ومنظومة القيم.
لقد دخلنا عصر الإصلاح والخوف الحقيقي هو أن نغادره دون أن نصلح حالنا. قال تعالى ?إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم? ـ [سورة الرعد، آية11].