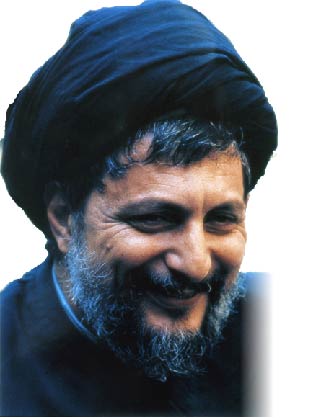* مؤتمر "كلمة سواء" التاسع: موقع الحرية في الاصلاح والتجديد
الجلسة الأولى
احب ان اتابع على قضية البيئة بكلمة مختصرة هناك حديث: "إذا قامت الساعة وفي يده أحدكم فسلة فليغرسها" اي ان قضية البيئة مقدسة أكثر من العبادة.
العلم بلا شك منارةٌ مضيئةٌ يهتدي ويستنيرُ بها، كلُ من أراد الهداية. وقد تميز أرباب العلم في كل العصور، وبقيت بصماتُهم واضحةَ المعالم في مسيرة الحضارة الإنسانية. وعلى ذلك تتوقف أهميةُ عمليةِ التعليمِ ودورِها في المجتمع.
ماهية التعليم:
التعليم هو التدريس، ويتوقف نجاح التعليم على توفير الشروط التي تسهل طلب العلم على الطالب داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها. ويرى البعض أن التعليم ليس إلا مجردُ مهنة، حيث تنطبق عليه خصائصُ المهنة، والمهنةُ كما عرّفها القاموس الفلسفي " هي العمل الأساسي المعتاد الذي يتعاطاه المرء، ويحتاج في ممارسته إلى خبرة، ومهارة، وحذق. ويقال: مهنة التعليم".
ويؤكد أحد الباحثين على الطبيعة المهنية للتعليم، من خلال تحديدِه لخصائصِ المهنة وانطباقِها على خصائصِ التعليم فيقول: " إن المهنة تشمل في الأساس أنشطةً عقلية وتقوم على أصولٍ علمية. وإن المهنة تقوم على التخصص في مجالٍ من مجالات المعرفة والعمل، وإنها أخيراً تتطلب إعداداً مهنياً طويلاً وممتداً".
في الواقع لا يستطيع أحد أن يزيل صفةَ المهنةِ عن التعليم، وخاصة في عصرنا الحالي. لكن التعليم قبل كل ذلك، هو عبادةٌ في مفهومنا الإسلامي، وتقربٌ إلى الله ورسوله، وارتقاءٌ عند الله عزّ وجلّ ثم عند الناس. قال تعالى: " قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ". ونوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية العلم وفضله مقارنة بالعبادة بقوله: " فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر".
والتعليم بلا ريب يساهم بتشكيل العقل بدرجة كبيرة، وعن طريقه تُزرع الأفكارُ والعلوم الأساسية في عقل الإنسان "طالب العلم". وبواسطته يربى الفرد على السلام أو الحرب، على الرذيلة أو الفضيلة. كما يتم من خلاله اكتسابُ المعرفة، وتتكون الميول والاتجاهات تجاه كثير من قضايا الحياة وشؤونها. أضف إلى ذلك ما للتعليم من دور هام في بناء القيم، وترسيخ المعتقدات، وصقل المهارات المختلفة، والتعاطي العام مع كل أمور الإنسان الذاتية والمجتمعية.
لذلك فإن التعليم، ونظراً لأهميته وتأثيره الكبيرين، يحتاج إلى أخلاقية عالية، واحتراف أكيد، ونشاط دؤوب، وإيمان بهذه الرسالة التي سار عليها الأنبياء من قبل فكانوا الهداة المهديين، يعلمون الناس الخير ويدعونهم إليه. قال تعالى :" كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ ايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ".
عناصر التعليم:
لا بد للتعليم لكي يفعل دوره في المجتمع، من أن يقوم على عناصر ثلاثة متضامنة ومتكاملة وهي: المعلم، المنهاج والهدف. وهي الأقانيم الثلاثة التي يتم الإصلاح من خلالها.
1- المعلم: ولكي يحوز على هذه التسمية، يجب أن يمتلك المعلم قدراً من العلم يؤهله لذلك. وأن يتجنب التطلع إلى التعليم إذا لم تتوفر له القدرة والثقة بعلمه وبنفسه للدخول في هذا الميدان. وتحري ذلك أمر مطلوب لما للتعليم من تأثير على المجتمع، والتزاماً بإتقان العمل الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :" إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه".
وبما أن العلم مادة جافة، يضعه المعلم في القالب الذي يريد، فيوجهه إما نحو الخير، وإما نحو الشر، كان من الضروري لصاحب العلم أن يلتزم بالقيم الأخلاقية التي يفرضها العلم على أهله من أجل صلاح المجتمع وتقدمه، وأبرزها:
التواضع: إن من أعتى الأمراض القاتلة التي تصيب المعلم هو "الكبر والإعجاب بالنفس"، فيصبح معه لا يرى العلم إلا من خلال نفسه، ولا يهتم بغيره من العلماء، وينظر إلى طلابه نظرة دونية تبغضهم بالعلم وأهله.
أما المعلم المتواضع، فيدرك أن العلم ميدانه واسع، وأن مسيرة العلماء ضاربة في التاريخ ومستمرة. وأن العلم الكامل هو لله وحده الذي خاطب الناس بقوله تعالى: " وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا".
وفي هذا المقام يحضرني قول الإمام الشافعي الذي لم يغتر بما وصل إليه من العلم:
كلمـا أدبنـي الدهـر أرانـي نقص عقلي
أو أراني ازددت علماً زادني علمي بجهلي
الاعتزاز بالنفس: اعتزاز المؤمن العالم بنفسه شأن ضروري، لكي يستطيع أن يواجه ما يحاك ويدبر لأمته ولشعبه، قال تعالى: " وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ". عزّة بالعلم على طريق الأنبياء، عزّة المتواضعين، وليست عزّة الجبارين القائمة على السلطة والمال والنسب... فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". إنه العلم النافع الذي لا بد أن يكون مبنياً على الإيمان.
الإحساس بالمسؤولية: إنها مسؤولية كبيرة ومزدوجة، فهي مسؤولية أمام الله، ثم مسؤولية أمام الناس. وكلما ازدادت واتسعت دائرة علم الإنسان كلما عظمت مسؤوليته التي سوف يُسأل عنها في الدنيا والآخرة. فعن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟"
فالمعلم مسؤول عن علمه من عدة جوانب: " مسؤول عن صيانته وحفظه حتى يبقى، ومسؤول عن تعميقه وتحقيقه حتى يرقى، ومسؤول عن العمل به حتى يثمر، ومسؤول عن تعليمه لمن يطلبه حتى يزكو، ومسؤول عن بثه ونشره حتى يعم نفعه، ومسؤول عن إعداد من يرثه ويحمله حتى يدوم اتصال حلقاته، وقبل ذلك كله، مسؤول عن إخلاصه في عمله لله حتى يقبل منه". هذا وقد بيّن الإمام الغزالي صفات العالم المقبول، فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجلسوا عند كل عالم إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس :" من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الزهد، ومن الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى النصيحة".
إنها صفات وواجبات على المعلم أن يلتزم بها، ليكون أداة بناء لا معول هدم. بحيث لا يتولى التعليم إلا من استكمل عدته، وشهد بذلك أفاضل أساتذته. هذا المعلم الذي تحققت فيه تلك الصفات الأخلاقية والمهنية الرفيعة، هو الذي يقدّره المجتمع، وقبل ذلك يكرمه الله سبحانه وتعالى، ويعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:" يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم". وهكذا فالمجتمع كله ينظر إلى العالم الصالح بعين الغبطة، وكلٌ يتمنى أن يقدّر قدره، ويحظى بمرتبته. وهذا ربما من الحسد المباح لأنه سباق نحو بذل العلم والمعرفة ليعم وينتشر. فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه:" لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، ويعلمها". فحق للمعلم أن يدرك مكانته، وأن يدرك الأمانة الملقاة على عاتقه فيؤديها ولا يخونها.
2- المنهج: "هو الطريق الواضح، والسلوك البين، والسبيل المستقيم". والمنهج الدراسي: "مجموعة من المواد الدراسية والخبرات العلمية الموضوعة لتحقيق أهداف التربية". ومنذ المراحل الأولى للتعليم لا بد من تخطيط مناهج الدراسة، وتحديد الهدف الذي تصبو إليه، واختيار أنجع وسائل التعليم لإنجاز الهدف ضمن المراحل الزمنية المحددة له وفق المنهج. " إن من شرط المنهج الدراسي الصحيح أن يكون ملائماً للظروف الطبيعية والبيولوجية، وأن يكون مستَمداً من حاجات المتعلم وثقافة المجتمع، وأن تُربطَ موضوعاتُه بشؤون الحياة الحاضرة، وأن تكون مواردُه وخبراتُه وطرقُه ووسائلُه متماسكة".
والمنهج الذي لا يقوم على أسس ثابتة ومنطلقات واضحة، يبقى عرضة للاهتزاز، ولا يؤدي الدورَ المطلوبَ منه، مما ينعكس سلباً على مسيرة التعليم، وبالتالي على إمكانية إحداثها للتغيير أو الإصلاح المرجو. أما المنهج السليم فيقوم على أربعة أسس:
الأساس الإيماني: وينبثق من عقيدة الأمة وتراثها، ويكون نبراساً لسائر مفردات العملية التعليمية.
الأساس النفسي: ويراعي المتطلبات النفسية للمتعلم من حيث نموهُ الذهني، ومن حيث تحولاتُه النفسيةُ والعضويةُ تبعاً لمراحل نموه وتحولاته المختلفة، الطفولة... المراهقة... الشباب...
الأساس الاجتماعي: "ولا يقتصر تأثر العوامل الاجتماعية على محتوى المنهاج، بل إنها تؤثر على كل ما يمكن أن يعتبر متمماً للمنهاج، مثل المتعلم، العملية التعلمية التعليمية والمؤسسات التربوية" وإن أي خطأ في اختيار المنهاج وأي سوء في تطبيقه سوف يؤدي إلى التأثير سلباً على بنية المجتمع والانحراف به نحو الكارثة، وإلى القضاء على معظم المكاسب المادية أو المعنوية التي تحرص المجتمعات على الحفاظ عليها وتطويرها. لذلك كان لا بد للدول من أن تعنى بالمناهج التعليمية وتعمل على تحسينها لكي تنعكس إيجاباً وخيراً عاماً على المجتمع ككل.
الأساس المعرفي: ويستدعي جهوداً علميةً كبيرةً على كافة المستويات وخاصة من جانب القيمين على مناهج التعليم. والأساسُ المعرفي الذي يجب أن تتكامل فيه كل العلوم ولا تتنافر، عليه أن يراعي حقيقة المعرفة، ومختلفَ ميادينِها، بصورةٍ تؤدي إلى الرسوخ في العلم والتمكن منه. وقد حض الإسلام العظيمُ على المعرفة في كثير من المواضع والحقول بدءاً بآية "إقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" مروراً بآيات عديدة تدفع إلى العلم والمعرفة والتفكر:" وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ"
إلا أن الأخذ بالأسس الأربعة المذكورة آنفاً (الأساس الإيماني، الاجتماعي، النفسي، المعرفي) يجب أن يوظف لخدمة الأهداف العليا للإنسان والوطن والأمة. على أن تتكامل هذه الأسسُ مع بعضها البعض وأن يتم تطبيقها ضمن المنهج الواحد.
3- الهدف: إن كل عمل أو نشاط بدون هدف ولا غاية يبقى هائماً يتلطم يمنة ويسرة. والهدف في العملية التعليمية لا شك يُبنى على ركنين أساسيين هما المعلم والمنهج.
والهدف العام يتجلى في تعليم وتثقيف الفرد، ليشكل دعامة المجتمع. المجتمع القوي بأبنائه ومعداته ومعامله ومصانعه، لبناء الإنسان قلباً وقالباً، ومن ثم، لبناء الوطن القوي الحر غير المرتهن. على أن يبقى هذا الهدف نصب أعين المعلمين ليتحركوا من خلاله. كذلك بالنسبة للقيمين على المناهج التعليمية لكي يتفاعلوا معها، ويطوروها بالشكل الذي يخدم الهدف المرجو. لذلك من الضروري أن تقام الدورات التدريبية للمعلمين لتأصيل الخُلق والعلم، ولمتابعة أحدث ما توصل إليه العلم من إنجازات وتطورات.
تبقى الإشارة إلى وجوب التكامل بين عناصر التعليم الثلاثة (المعلم، المنهج والهدف) وإن أي تضارب أو اختلاف بينها سوف يؤدي إلى الإضرار بالعملية التعليمية ككل، وهذا ما نلمسه في الواقع حيث نرى العديد من المؤسسات التعليمية تركز على المعلم، وبعضها يهتم بالمنهاج، والبعض الآخر يصبو نحو الهدف. ونادرةٌ هي المؤسساتُ التعليمية التي تجمع بين العناصر الثلاثة مجتمعة. وعندما يصبح بإمكان تلك المؤسسات النظر إلى العملية التعليمية بعناصرها الثلاثة كوحدة متكاملة عندها نستطيع أن نحدث التغيير والتطوير والإصلاح.
أين نحن من إمكانية الإصلاح؟
لقد شهد القرن الماضي جدليةً كبرى بين مثقفي الأمة ملَكت عليهم سمعَهم وأبصارهم، انقسم الناس إثرها إلى فريقين، وعُقدت المناظرات وأقيمت الندوات وحُضّرت الاجتماعات وكثرت المناقشات، هذه الجدلية مفادها... أيهما فيه عوامل نهضة الأمة ورقيها؟ هل الأصالة، باعتبارها التاريخ والتراث ومسيرة الآباء والأجداد؟ أم تراها الحداثة، التي بها نهضت أوروبا بأفكارها المختلفة وتياراتها المتنوعة ودعواتِها ونظرياتها؟ وهل أن الحداثةَ هي عينُ المعاصَرة أم أن هناك اختلافاً بينهما؟ وأيهما تُلقي عليه الأمةُ أثقالَها لتقومَ من مرقدها وتنفضَ غبارَ النوم عنها؟
إن الحال الحاضرة التي نحن عليها اليوم، تستوجب لقاءات من هذا النوع الذي نحن بصدده، حيث يتداعى المخلصون ويعرضون عصارة فكرهم وخلاصة تجاربهم، في هذا الوقت العصيب حيث يُترصّد بخيرات الأمة ومقدراتها، ولتُساق إلى نظامٍ عالمي بمقاييسَ مختلفة، لا تمت بصلة إلى تلك المقومات التي بنيت عليها ثقافتنا الدينية والاجتماعية والأخلاقية، بل إنها على استعداد – أي العولمة- لأن تريق الدماء في هذا السبيل، إن المشكلة ليست في الخوف من العولمة، لأننا نعلم يقيناً أنها لا تملك عوامل الحياة والاستمرار، فهي في كثيرٍ من مفرداتها تخالف الدين والعقل والفطرة، كما أنها بجبروتها تلغي مبدأ التعدديةِ والحوارِ وخصوصيةِ الأديان، وإلا فلماذا يسعون إلى بث مبادئ المثليين حتى جاهر القوم بشذوذهم وطالبوا بحقوقهم؟ ومن ذا الذي يسعى إلى رفع الحظر عن شهود يهوه الذين ينخرون بأصابعَ صهيونيةٍ تعاليمَ السيد المسيح عليه السلام؟ ومن الذي ينفخ الروحَ في طوائفَ بائدة، يبعثها من رقادها، تجاهر بعبادتها للشياطينِ على أنواعهم، حتى أسسوا المحافل والمنتديات؟
إن المطالبة اليوم بتعديل المناهج التعليمية، الآتية من الخارج، لهي كلمة حق أريد بها باطل. ذلك أنه ليس المقصودُ منها رفعتنا ورقينا ثقافياً واجتماعياً وتقدمِنا صناعياً وتجارياً، فهذه الأمور غدت حكراً على الدول المتقدمة، كما أن القوة النووية هي حكر على النظام الصهيوني، فهل يحق لنا مثلاً أن تُوَرّدَ لنا هذه الدولُ المتقدمة خفايا وأسرارَ الصناعات الحديثة، بل مكوناتِها في الحد الأدنى؟ أبداً وكلا، وإنما المراد جزءٌ محددٌ بذاته يودّون استئصاله بدعوى أنه تحريضٌ على الإرهاب واغتيالٌ للآخر أياً كان. إن هذه الحالة الطارئة تستوجب رصّ الصفوف وتوحيدَ الرؤى وتحديدَ المنطلقات لمواجهتها. فنحن بحاجة ليس إلى تعديل المناهج فقط، بل إلى إصلاحها ولكن من الداخل، وشحنِها بكل ما هو علمي وحديث، وأن نخلي بين طلابنا وإبداعاتهم. فطفلنا لا ينقصه إدراكُ الطفل الياباني ولا ذكاءُ الطفل الألماني ولا عبقريةُ الطفل الأمريكي، بل إن هناك إحصاءاتٍ تبين مدى سوءِ المناهج الأمريكية التعليمية وحاجتِها إلى الإصلاح.
أما إذا كان المراد بترَ ما في مناهجنا، من قيمٍ وأخلاقٍ وعزةٍ وأخوةٍ وحواراتٍ وخشوعٍ وخضوعٍ وعبادة، إلى آخر هذه المنظومة من المعاني الشريفة التي ترتكز على الدين، من أجل أن نزرع في جسمنا جسماً غريباً عنه، ذا سجل سيئ، فهذا ما نرفضه إن لجهة حقوق الإنسان أو لجهة حقوق الشرائع السماوية جميعاً.
لذا فمختصر القول، إن الله تعالى قد وهب هذه الأمةَ عقولاً فذة من علماءَ ومخترعين ومنظّرين وتربويين من أبناء هذه الأرض وهذه الحضارة، وهم أعلم بأنفسهم من سواهم، وحدهم القادرون على وضع برامجَ تربويةٍ فذة، كتلك التي تركت ميراثاً عن الآباء والأجداد فبهروا بها العالم، مناهجَ قد سبرت كل أغوار المعرفة والعلم والحضارة. والمطلوب والحالة هذه، فقط أمرٌ واحد، هو إتاحةُ الفرصة لهؤلاء كي يدلوا بدلوهم، وأن ترعى الحكومات هذه العقول، وأن تهيئ لها ما يلزمها من وسائلَ ومختبراتٍ وعواملَ مساعدة. والأهم أن يكونوا موضع احترام وعناية من هذه الحكومات. بل وحتى الجمعيات والهيئات بإمكانها أن ترعى وتسوّقَ إنتاجَ هؤلاء الأفذاذ عوض أن تتلقفهم أيادٍ تسعى إلى الربح والكسب وتستعملهم رأس حربة باتجاه مجتمعاتنا شاءوا ذلك أم أبوا.
إن مشاكلَ بعينها هي مناطُ ما نحن فيه الآن، وبسبب هذه المشاكل يعاني ونعاني مع شبابنا الكثيرَ لجهة عدم وضوح الرؤية.
فمن مشاكنا تلك الهوة التي تفصل بين المناهج وبين الأجيال، حيث أن الكثير من هذه المناهج مستورد، ينقلها الواضعون نقلاً، وعلى الطلاب أن يحلوا معضلاتِها العلميةَ واللغوية، وليس بالضرورة أن تنجح تلك المناهجُ أو البرامجُ حتى نستوردَها، بل وإن بعضها لا يزال يُعمل به رغم أن الزمن قد عفا عليه، ولا يزال أبناؤنا حقولَ تجارب مفتوحة على أمل أن ننجح في إيصال أكبر قدر من المعلومات إليهم.
ومن مشاكلنا كذلك الانبهار بكل ما هو غربي، من منتجات وعروضات، مروراً بما هو تافه من صرعات وقصّات ونمط حياة، على خلفية الاعتقاد أنه بعينه التطور ومفتاحُ الحضارة، والسبيل الوحيد للتعبير عن نقص نفسي من أجل الوصول إلى أنماطٍ بشرية ترضي خيالاِتنا، متناسين أن ما ينعم فيه الغرب إنما هو نتاجٌ فكري صاغته حضارتُنا من علومٍ وقيمٍ وأخلاقٍ وإنسانية.
إن منهجنا الفكري عمره مئات السنوات، ولم يكن هنالك تعارضٌ بينه وبين سواه من الحضارات والأديان والشرائع، ولقد عرف اتباع جميع الديانات أفضل أيامهم حين كانوا بين ظهراني الحضارة الإسلامية، فلم يكن هناك افتئات ولا قمع ولا تطهير عرقي، لقد كانت حضارتنا حضارة إنسانية أخلاقية بكل معنى الكلمة، ونحن اليوم لسنا طوع حضارة مادية لا تعرف إنسانية الإنسان ولا تساوي مشاعره وأحاسيسه عندها جناح بعوضة.
وها هو ذا النمط من الشباب، اللاهث وراء الشهوة والشهرة والمال السريع، وإذا يمم وجهه شطر العلم فإنما يريد شهادات جوفاء بعيدة عن الأكاديمية الحقة والموضوعية، وهو يريدها للوصول بها إلى وظائف رفيعة ودخل ثابت ليس حرصاً على سلامة الأمة ورفعتها ولا حتى تطويراً لذاته بالحد الأدنى.
إننا في العالمين العربي والإسلامي نتمتع بميراث تربوي واسع وعريض، وبخبرات عالمية، وأشدد على عالمية، قل نظيرها، ولن نرضى أن نكون تحت وصاية أحد، لأننا خبرنا مجتمعاتنا وهي مجتمعات متكاملة تتغلغل جذورها عميقاً في أرض النبوة والرسالات والحضارات.
باختصار نحن بحاجة إلى إصلاح لمناهجنا التعليمية، إصلاح من الداخل، وإذا أردنا أن نلقي نظرة سريعة على مناهجنا التعليمية في لبنان نجد أنها مشروع وطني كبير، قيمته في التجديدات التي أحدثها بالمقارنة مع مناهج السبعينات، وفي قدرته على التجاوب مع الرغبة العارمة لدى اللبنانيين عموماً في التغيير والتطوير. والجميع يعترف بأن إصدار المناهج في الوقت القصير الذي صدرت فيه، ترافق بثغرات كثيرة، خاصة في منهاج اللغة العربية والتربية المدنية وربما في غيرها.
*في المنهج الجديد تتغيير اللغة العربية، كمادة لتصبح فكراً وفلسفة وقيماً فكرية معينة، ومذاهب تسري في ما ورائيات النصوص، وتشكل بهذه الماورائيات عقليات وأذهان ومشاعر طلابنا.
* هناك إسقاط للمفاهيم الغربية، أو هناك استنبات لمناهج غير عربية على اللغة العربية مع أن لغتنا لها خصوصيتها التي تتجاوز كل عموميات اللغة. اللغة العربية التي ندرسها وبها نستطيع أن نفهم القرآن الكريم.
*إذا تساءلنا ما هي الحصيلة اللغوية من المنهاج الجديد؟ وما هي الحصيلة الذوقية والأدبية وما هي المهارة الفنية التي يكسبها الطالب آخر العام؟ وهل توصل الطالب إلى هذا التشكل من جهة التذوق الأدبي والحصيلة اللغوية والمهارة الفنية؟ وهل كانت المشكلة في النصوص؟
* وهل خرجت المناهج من الطريقة التلقينية عملياً وتنفيذياً؟
وإذا سلّمنا بأن المفاهيم التربوية تخضع لحركة دائبة لا تعرف الجمود، وجب علينا ديمومة التجديد واستمراريته وكذلك التغيير والتطور والإصلاح. ولكننا كي نبدأ السير على الطريق فلا بد أن نحقق أولاً:
- الأمن التربوي والروحي لأبنائنا وذلك بربطهم بالوحي الإلهي والأدب النبوي.
- كي تحصد الأمة أبناء على مستوى جيد من العلم يجب أن تقدم لهم المعلم المدرب الماهر.
- علينا جدولةُ المناهج بما يتوافق مع المدة الدراسية المحددة.
- علينا مراعاةُ أفهام التلاميذ وبما يتناسب مع أعمارهم ( في الثامن منع الحمل وإيقاف الإخصاب وإيقاف الإباضة وغير ذلك).
- وتصحيح نظرة المناهج للمرأة العربية وللاقتصاد الإسلامي
- وحذف كل ما يتعارض مع المبادئ الدينية
- ورفع قيمة الأسرة في المجتمع.
- وهذه تحتاج إلى معلم مربٍ نؤهله لهذا.
إذاً، لا بد من إحداث عملية تغيير جذرية تطال كل عوامل البناء وعندها يبدأ الإصلاح.